العنصرية..مقارنة منطقية ما بين نعمة الإلحاد الحضاري ولوثة التصوفات اللاهوتية
- محمد القيرعي الأحد , 13 يـولـيـو , 2025 الساعة 8:06:58 PM
- 0 تعليقات

محمد القيرعي / لا ميديا -
الزميل الكاتب والمثقف والبرلماني أحمد سيف حاشد، قرأت بإمعان موضوع يومياتك في أمريكا.. رقم (11) المعنون «مع عمدة نيويورك»، وللحقيقة فقد أثرت غبطتي وحسدي في آن معا.
حسدي لك ليس لتواجدك بالأحرى في تلك البلاد (أمريكا)، التي وعلى الرغم من اتسامها حاليا بـ”أعلى معايير التحضر الإنساني”، إلا أنني أبغضها بتطرف لا متناه، مثلما أبغض إرثها وميراثها وكل ما فيها وكل ما يمثلها، كونها بلدا نشأ في الأول والأخير على أبجديات الجريمة التي دفعت الإنسانية ولازالت حتى اللحظة وعلى مدى قرون طويلة ومظلمة أثمانا فادحة لتكوين شخصية هذه الأمة المتنافرة بعمق بقدر تجانسها الظاهري، الجريمة التي بدأت نذرها البربرية الأولى بإبادة شعوب القارة الأصليين (قبائل الهنود الحمر) على يد الفاشيين الأوروبيين الذين قدموا آنذاك لاغتصاب القارة بكل ثرواتها وخيراتها.. مرورا بجرائم الكراهية والاستبداد العبودي العنصري الذي طال وبوحشية لا متناهية وعلى مدى أربعة قرون مظلمة من تاريخ العبودية الذي بدأ تدشينه فعليا منذ العام 1612 ملايين الأفارقة الذين تم جلبهم من براري أفريقيا بعد أسرهم بالقوة لتعمير القارة البكر والمغتصبة، إلى الجرائم العصرية الأمريكية المرتكبة خلال العقود الثمانية الأخيرة تحديدا بحق العديد من شعوب ومجتمعات العالم الحرة، من جمهورية تشيلي إلى كوبا وغرينادا وكولومبيا وفنزويلا في أمريكا اللاتينية والجنوبية، إلى فيتنام ولاوس وكمبوديا في جنوب شرق آسيا، إلى العراق وإيران والصومال وسوريا وفلسطين واليمن وغيرها من شعوب العالم المكتوية حتى اللحظة بالشرور والعنجهية الأمريكية.
لكنني أحسدك حقيقة على الفرصة التي أتيحت لك في الأساس لمعانقة (أحد أنبياء الإنسانية السود)، من منظوري الشخصي، العمدة الزنجي إريك آدامز، والذي قد لا يكون له، وهذا مؤكد قطعا، أي تأثير شخصي واعتباري ملموس على صعيد حركة الكفاح التحرري التاريخي لأقراننا زنوج أمريكا، ممن ضحوا بأرواحهم وأمنهم ودمائهم ممهدين له طريق اكتساب السلطة التي يشغلها اليوم كعمدة منتخب لمدينة نيويورك، التي تعد أهم وأكبر مدن أمريكا وباكورتها الاقتصادية، أمثال القادة العظام مالكوم إكس، ومارتن لوثر كنج، وروزا باركس، ونات تورنر، وبولاند كينت، ولوريتا سكوت، وجيمس ليزلي، والعشرات غيرهم..
وإن كانت نبوة السيد آدامز المفترضة بالنسبة لنا معشر “الأخدام” التواقين لنيل مكانته ومكانة أقرانه الزنوج، تنبع من منظوري الشخصي من تمثيله الحاصل ومن خلال موقعه الحالي لعظمة التطلعات التحررية السوداء التي عصفت بأقرانه جيلا بعد جيل على مدى أربعة قرون ونيف من عمر وتاريخ المعضلة العنصرية التي سادت بوحشية القرون الوسطى ضدهم.
يعني بالمختصر المفيد فإن ما أود قوله في هذا الصدد هو أن إريك آدامز الذي يحكم أهم وأكبر العواصم الاقتصادية في العالم (نيويورك) إنما هو انعكاس في الواقع لمدى قدرة الظاهرة الحضارية المنفلتة من قيود التصوفات الدينية واللاهوتية (كقوانين منظمة لسير ومسار الحياة والعلاقات الإنسانية) على تحقيق المستحيل، فمتى ما تحرر المرء من قيود العقائد الاجتماعية والدينية البائدة والمتخلفة، فإن في مقدوره حقا العيش والنجاة والتطور الحتمي صوب الأفضل بالطريقة التي يريدها، إنه الفارق الحتمي والجوهري أصلا ما بين التحضر.. والماضوية.
فعلى سبيل المثال تصوروا معي في هذه الحالة ماذا لو كان قُدر يوما لهذا (إريك آدامز) زيارة بلادنا الموسومة زورا بالحكمة، ألن يصبح قدره ومصيره مرهونا بحجم “المرفع” المخصص له حتى ولو كان إماما لأمريكا كلها، وليس حاكما تنفيذيا لإحدى مدنها فقط، فبشرته الداكنة السوداء، وهويته العرقية، لن تشفعا له أمام هذا المجتمع الغارق في بربريته وماضويته حتى النخاع، فهو في الأول والأخير “خادم”، ولا منجى له من حمل “المرفع” للترفيه عن أسياده القبائل.
وللعلم، ومن باب التذكير والمقارنة فقط، أشير هنا إلى تزامن أولى بوادر ثورة الحقوق المدنية السوداء الجادة والفعلية في أمريكا في ستينيات القرن العشرين مع انبلاج فجر ما يُسمى بتهور في بلادنا بثورة 26 سبتمبر الفارغة قطعا من أي مضمون ومحتوى ثوري حقيقي عام 1962، وبفارق أسبوع واحد فقط لصالح الأولى (ثورة الحقوق المدنية) التي بدأت نذرها الحركية المنظمة في النشوء منتصف سبتمبر من نفس العام، وفي ولاية آلاباما الجنوبية، وتحديدا قبل عشرة أيام فقط من هدير مدافع السلال وعلي عبدالمغني بصنعاء التي صبت جام غضبها آنذاك على نظام الإمامة الملكي الذي كان في الواقع أكثر تقدمية من كل أثوار سبتمبر 1962. وذلك بغية إعتاق الشعب، كل الشعب اليمني بشيوخه و”أخدامه” و”مزاينته” و”دواشنته” و”مطبليه” من الرق المزعوم بحسب الدعوات الثورية.
الثورة الأولى، “بتاع” أقراننا زنوج آلاباما نشبت منتصف سبتمبر 1962م في عهد الرئيس (الشهيد حقا من منظوري) جون إف كنيدي، كما أسلفنا على خلفية احتجاجات اجتماعية وعرقية متطرفة شهدتها آنذاك ولاية آلاباما (المعروفة بكونها إحدى أبرز ولايات النطاق الزنجي الأكثر عنفا وتطرفا في تاريخ الاستبداد العنصري الأمريكي) احتجاجا على قبول جامعة “أكسفورد” في الولاية آنذاك استيعاب الطالب الزنجي الأسود جيمس براديت ضمن صفوفها، وهي الجامعة المخصصة تقليديا ووفق ثقافة الفصل العرقي للطلاب البيض فقط.
الأمر الذي أشعل موجة من الاحتجاجات الجماهيرية الرفضية البيضاء بسحنتها الاستعلائية العنصرية المتطرفة وبقيادة حاكم ولاية الآباما ذاته المتعصب العنصري جورج والاس بهدف إلغاء قرار الجامعة، بغية الحفاظ على إرثهم العنصري المخجل والمتمثل بالفصل العرقي بين االزنوج والبيض، والذي كان لايزال سائدا ومكرسا على كل مناحي الحياة اليومية والإنسانية، رغم عدم قانونيته (أي الفصل العرقي)، والذي يعد من الناحية القانونية والدستورية مُجرما منذ ما يقرب من قرن زمني سابق على تلك الأحداث.. استنادا في المقام الأول إلى مضامين المرسوم الرئاسي الذي كان قد أصدره الرئيس الشهيد أبراهام لنكولن عام 1869، والقاضي بإلغاء كل مظاهر العبودية القسرية من حياة المجتمع الأمريكي، بالإضافة إلى ما تبعه آنذاك من إجراءات تشريعية لاحقة ومعززة لهذا المسعى التحرري على الصعيد الإنساني، أهمهما التعديلان الدستوريان الرابع عشر في العام 1877، والخامس عشر 1878، واللذان تضمنا حرفيا تمكين الزنوج من التمتع بكافة حقوق وامتيازات المواطنة المتساوية، بما فيها حق الاقتراع والترشح للمناصب الحكومية والتنفيذية المختلفة لضمان أسس شراكتهم العادلة والمفترضة في إدارة الشؤون العامة للبلاد.
ومع هذا فقد تعين على أمثال العمدة إريك آدامز الانتظار لقرن زمني كامل قبل أن يبدأوا (أي زنوج أمريكا) في إدراك المعنى البليغ لتلك الحقوق التي يتعين عليهم انتزاعها، رغم عراقة النظام السياسي الديمقراطي الأمريكي على الصعيد الوطني الداخلي الذي كان في مقدور الزنوج الاستفادة منه بشكل مبكر لانتزاع حقوقهم تلك والتمتع بها.. عوضا عن الانتظار لقرن كامل عاشوا خلاله أو تعايشوا بالأحرى مع ما يمكن تسميته بـ”أنماط العبودية المختارة”.
وهذا مرده بطبيعة الحال إلى عاملين أساسيين: الفقر المتفشي آنذاك في نطاق الغاليية العظمى من الزنوج، بالإضافة إلى عوامل الأمية السياسية والمعرفية المستفحلة في حياة 98% من الزنوج الذين تخلصوا وبشكل مفاجئ من قيود العبودية المتدلية من أعناقهم بمقتضى مرسوم لينكولن والإجراءات التشريعية اللاحقة، ليجدوا أنفسهم في الوقت ذاته عبيدا للفقر والعوز والفاقة والأمية والافتقار الكلي لأبسط شروط ومقومات النماء والتطور الإنساني.. بالصورة التي أجبرتهم على العودة والتقوقع داخل قيود العبودية المختارة طلبا للنجاة ولقرن زمني كامل كان كافيا لاختمار حراكهم التحرري والمطلبي الذي انطلق في سبتمبر العام 1962م من وسط الجامعات والمؤسسات التعليمية.. حيث بدا واضحا أن الوعي التحرري الناشئ وسط الزنوج كان مبعثه الأساس توسع قاعدة التعليم في محيطهم.. فالتعليم والمعرفة الإنسانية هي أساس كل التحولات البشرية الحاصلة هنا وهناك.
خلاصة القول، هو أنه ودون الحاجة لسرد الأحداث والتطورات المتلاحقة التي أسفرت خلال تلك الحقبة الثورية المدنية المتزامنة مع سبتمبر 1962 المشؤمة “بتاعنا” عن إيصال إريك آدامز وقبله باراك أوباما إلى سدة المسؤولية العليا في بلادهم، فإن النتائج الحاصلة في كلا البلدين على الصعيد الإنساني تعكس الفارق الجوهري ما بين التحضر الحداثي الفعلي المعاش كأمر واقع ومتقدم هناك، وبين ثورة في بلادنا بلغت عقدها السابع (أي مرحلة الشيخوخة) فيما لاتزال محشورة في زنانير الزنداني وجنبية عبدالله بن حسين الأحمر، باعتبارهما معيار الحضارة والتحضر الوطني.
وفيما بات في مقدور أمثال إريك آدامز التأثير أكثر على سير ومسار الحياة والحداثة والتاريخ في محيط بلاده ككل.. فإن طبقة التهميش والمهمشين الجدد في بلادنا أخذت في التصاعد والاتساع خلال الحقبة الزمنية ذاتها لتشمل العديد من طبقات القبائل السيادية البيضاء، الذين باتوا يقاسموننا بصورة أو بأخرى هويتنا الطبقية التقليدية كـ”أخدام” جدد وكوافدين بفعل معايير الحداثة السبتمبرية المبجلة بأناشيد “يا فرح يا سلى”، لدرجة قلصت معها حتى من مقدرتنا كـ”أخدام” تقليديين في الحصول على متنفسنا الطبيعي لممارسة مهامنا التقليدية في التسول في الأسواق التي قاسمونا إياها قسرا، وإن كانت معضلة “الأخدام” الجدد الوافدين إلينا من محيط طبقات القبائل المقصية والمبعثرة هنا وهناك تكمن في عدم استعدادهم البديهي للاعتراف بوضعهم الدوني الجديد المتولد من رحم العثرات الوطنية المتلاحقة كـ”أخدام” جدد، بصورة قد تساعدنا معشر “الأخدام” التقليديين في الحفاظ على هويتنا العرقية نقية وصافية ومستقلة عن مجونهم الماضيوي.
ويبقى العامل الحاسم والأهم الذي مكن بلدا كأمريكا من تخطي إرثها الإجرامي الطويل والمظلم والمشوه على الصعيد الإنساني والانتصار لتطلعات آدامز وأقرانه ماثلا في صوابية خيارهم الحضاري الذي انتهجوه عبر التحرر أولاً من قيود المعتقدات اللاهوتية، والاتجاه صوب تأسيس حياتهم ومستقبل بلادهم وشعوبهم على قاعدة التطبيق الأمثل للتشريع والقانون الذي يمثل دينهم وآلهتهم الحقيقية، فيما نحن نقتل ونسحل وتصادر حقوقنا وآدميتنا وتداس كرامتنا باسم الرب، الأمر الذي سيتعين علينا إن كنا جادين مستقبلا في السير على منوال مجتمع إريك آدامز التحرر وبشكل غير مشروط من كل ما يمت للروابط اللاهوتية بصلة، وإلا فنحن عبيد في دنيانا وآخرتنا شئنا أم أبينا.

.jpg)










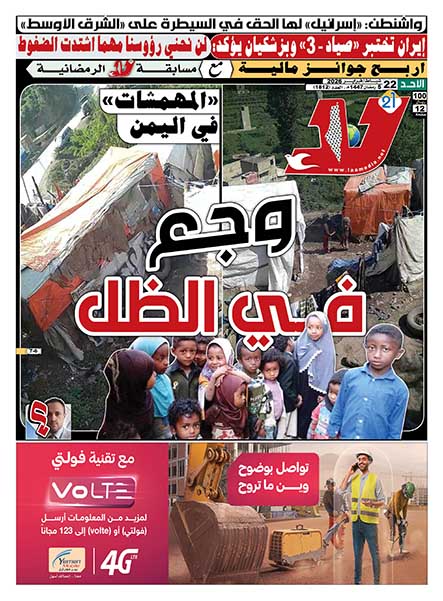




المصدر محمد القيرعي
زيارة جميع مقالات: محمد القيرعي