الاشتراكي «اليمني» فـي ذكراه الـ44..أين يكمن الإخفاق الثوري ؟!
- محمد القيرعي الثلاثاء , 1 نـوفـمـبـر , 2022 الساعة 7:39:45 PM
- 0 تعليقات

محمد القيرعي / لا ميديا -
مر أربعة وأربعون عاماً بالتمام والكمال منذ لحظة إعلان قيام الحزب الاشتراكي اليمني كأداة ثورية وطنية وأممية جامعة في الثالث عشر من تشرين الأول/ أكتوبر العام 1978، في جنوب ما قبل الوحدة، بزعامة الرمز الثوري والتحرري الوطني الأبرز القائد عبد الفتاح إسماعيل.
كانت لحظة إعلان قيام الحزب لحظة فارقة حقاً ومفصلية في تاريخ حركة الكفاح الوطني التحرري، الذي استهله الرديف الحركي الأول للحزب: الجبهة القومية، التي أنيطت بها مهمات خوض الكفاح المسلح لنيل الاستقلال خلال الفترة البادئة في تشرين الأول/ أكتوبر 1963، ومن بعدها التنظيم السياسي الموحد الذي ضم أغلب مكونات وفصائل العمل الوطني المساندة للثورة في مراحل الاستقلال الوطني الأولى في 1967 ـ 1975، وصولاً في نهاية المطاف إلى تذويب شخصيتي الحركتين الثوريتين معا في بوتقة سياسية وحركية جامعة تحت اسم «الحزب الاشتراكي اليمني»، الذي يعد في الواقع امتدادا سياسيا وحركيا وثوريا للجبهة القومية وتنظيمها السياسي الموحد فيما بعد.
ورغم أهمية تلك الخطوة على الصعيدين الثوري والوطني، إلا أنها حفلت -كحقبة ثورية- بالكثير من المتناقضات والإنجازات والانكسارات والعثرات التي لا نزال نتجرع مراراتها حتى اللحظة.
صحيح أن تلك الخطوة كان لها مفعولها، أو لنقل أثرها الفوري، ليس فحسب في وضع الأسس النظرية والمنهجية للدفع بالعملية الثورية الوطنية قدما إلى الأمام، وإنما أيضاً في تحويل اليمن الديمقراطي (جنوب ما قبل الوحدة) إلى نقطة ارتكاز واستقطاب رئيسية لقوى وحركات التحرر في العالمين العربي والثالث؛ إلا أنها -كمرحلة ثورية وليدة- كانت مشحونة بالصراعات الأيديولوجية والحركية الناشبة تباعا بين رفاق الثورة ذاتهم، والتي أسهمت من جهتها وبدرجة رئيسية ليس فحسب في إبطاء أو لنقل تعطيل مسار حركة الثورة الوطنية الديمقراطية التي كنا نأمل من خلالها بلوغ مرحلة الكمال الشيوعي قبل غيرنا، بقدر ما أدت ومع المدى وبشكل كارثي أيضا إلى تفكيك أواصر الروابط الكفاحية والتنظيمية ما بين الحزب وطلائع البروليتاريا (الطبقة العاملة) المناط بها -في أي مجتمع ثوري تقدمي- مهمات بناء المجتمع وتحويله تحويلا اشتراكيا بناء.
وبدأت موجة الصراع التي نشبت أولاً خلال الفترة ما بين آذار/ مارس 1968 وحتى حزيران/ يونيو 1969 بين مكوني الجبهة القومية الرئيسيين: التيار القومي الناصري بزعامة كلٍّ من الرئيس قحطان الشعبي ورئيس حكومته آنذاك فيصل عبد اللطيف الشعبي، والتيار الماركسي في الجبهة بزعامة عبد الفتاح إسماعيل وسالم ربيع علي، والذي انتهى بإقصاء القوميين من السلطة وسيطرة الخط الاشتراكي.
إلا أن الملاحظ أن موجات الصراع الداخلي تلك لم تخمد عقب تطهير هرمية الجبهة القومية ممن وصفوا آنذاك بالتيار اليميني الانتهازي؛ إذ إن بوادر الصراع سرعان ما نشبت بين الأجنحة الماركسية ذاتها (الجناح الماوي الذي كان يمثله الرئيس سالمين وطابوره المكون من الرفاق صالح جاغم وعبدالله سالم الأعور وعلي سالم البار والرفيقين حسن باعوم وعلي صالح عباد مقبل، والتيار اللينيني الذي كان يمثله الرفيق القائد عبد الفتاح إسماعيل والبقية)، وهو الصراع الذي حُسم بكارثة دموية يومي 25 و26 حزيران/ يونيو 1978، وانتهى بإعدام كلٍّ من سالمين وجاغم والأعور وإقصاء البقية، ما أسهم في تهيئة الشروط الموضوعية للمباشرة بإعلان قيام الحزب الاشتراكي الذي كانت فكرة تأسيسه تتعارض في الأساس ومن حيث المبدأ مع رؤية التيار الماوي المقضي عليه (تيار سالمين) فيما يخص منظوره لقيادة عملية الثورة والتطور الاجتماعي والاقتصادي والوطني في البلاد... إلخ.
ومع أن الحزب لم يكن في مقدوره التخلّي عن فكرة ومفهوم الثورة الاشتراكية، بحكم أنّ مرحلة ما بعد تصفية القوميين أولاً، تيار قحطان الشعبي 1969، والماويين ثانياً، تيار سالمين 1978، وتنقية الحركة الاشتراكية، كانت قد هيأت السبل تماماً للانطلاق بقوة صوب الأممية الثالثة؛ إلا أن مطامح تلك الانطلاقة المأمولة سرعان ما تعثرت تماماً جراء استفحال موجة الصراعات الداخلية، التي كان لها عميق الأثر في مسار الثورة والحركة الاشتراكيّة الوطنية إجمالا في بلادنا.
لاحظوا -مثلاً- أنه ما بين انعقاد المؤتمر العام التأسيسي للحزب في تشرين الأول/ أكتوبر 1978 والذي تمخض عنه انتخاب الرفيق عبد الفتاح إسماعيل أميناً عاماً للحزب ورئيسا للدولة، وبين إقصائه القسري في نيسان/ أبريل عام 1980، نجد أن الفترة لا تزيد عن عام ونصف بالتمام والكمال، فيما الفترة الفاصلة أيضاً ما بين إقصاء فتاح من السلطة ونفيه وما بين عودته مجدداً إلى البلاد في العام 1985، قبيل انعقاد المؤتمر العام الثالث للحزب في تشرين الأول/ أكتوبر عام 1985 بما تخلل تلك الحقبة من موجة تصفيات دموية طالت أبرز قيادات وكوادر الحزب والثورة على يد علي ناصر محمد وزمرته، أمثال محمد صالح مطيع، وزير الخارجية آنذاك، والشهيد حسين قماطة، قائد المليشيات الشعبية، والرفيق عبد العزيز عبد الولي... بالإضافة إلى موجة الإقصاءات والتقويم التي طالت كلا من الرفاق علي عنتر وعلي سالم البيض وصالح مصلح... إلخ، نجد أن الفارق الزمني الذي شمل كل تلك الأحداث لا يكاد يتعدى حدود أربعة أعوام ونصف؛ لكنها كانت كافية من وجهة نظري لتقويض كل أسس البناء الثوري والحركي السليم، بالنظر إلى ما أفرزته تلك الحقبة المشحونة بالصراع الداخلي من نتائج كارثية، لعل أبرزها إنتاج بنية هرمية اجتماعيّة فظّة سيطرت من خلالها الأرستقراطية الانتهازية والطفيلية القبلية المقنّعة بالشعارات التقدمية على الوظائف الأهم في الإدارة والحزب، محتكرة بذلك سلك المناصب القيادية العليا والمتوسطة في هرمية الجيش والحزب والسلطة السياسية والقضائية والتنفيذية، بالإضافة إلى دفة التاريخ والتطور الوطني.
ولقد تعمّق هذا الأثر بقوة على ضوء نتائج المؤتمر العام الثالث للحزب في تشرين الأول/ أكتوبر 1985، والذي أسهمت نتائجه وإرهاصاته بصورة رئيسية في غياب وتضعضع بوصلة الجمهورية والثورة الاشتراكية ما بين الأهداف والنزاعات الشللية والنخبوية، وبين متطلبات الحركة الديمقراطية والاجتماعية المباشرة والطموحة للحاق بركب التطور الاجتماعي التاريخي المفترض.
لقد تعمّق هذا الأثر بقوة على ضوء نتائج المؤتمر العام الثالث للحزب في تشرين الأول/ أكتوبر 1985، والذي أسهمت نتائجه وإرهاصاته بصورة رئيسية، ليس فحسب في غياب وتضعضع بوصلة الجمهورية والثورة الاشتراكية ما بين الأهداف والنزاعات الشللية والنخبوية، وبين متطلبات الحركة الديمقراطية والاجتماعية المباشرة والطموحة للحاق بركب التطوّر الاجتماعي التاريخي المفترض، وإنما أيضاً في تهيئة الظروف والمناخات المؤدية آنذاك لانفجار موجة العنف والاحتراب الأهلي الداخلي في كانون الثاني/ يناير عام 1986، مقوضة بذلك دل ما تم بناؤه وإنجازه خلال العقدين السابقين من عمر العملية الثورية الوطنية الديمقراطية بصورة لم تعد قابلة للشفاء والتعافي حتى اللحظة.
وبغض النظر عن كل ما سلف فإن هذا لا ينفي حقيقة كون الحزب لعب دوراً ريادياً وطنياً هائلاً ومؤثراً في سير ماضي وحاضر ومستقبل الأمة والبلاد وحركة الثورة الوطنية برمتها.
صحيح أن الحزب حقق خلال مسيرته الوطنية جملة من الإنجازات المهمة والملموسة، أبرزها -إلى جانب تحقيق الوحدة اليمنية في أيار/ مايو 1990- إنجازاته على الصعيد البنيوي والمدني والإنساني، كتلك المتمثلة في تجربته الرائدة في إلغاء، أو لنقل تخفيف وطأة الفوارق الطبقية والعرقية في المجتمع الجنوبي؛ لكنها تظل في مجملها إنجازات منقوصة ومحدودة الأثر والتأثير؛ كون أغلبها تحقق في الواقع وفق جملة من التصورات الفردية لصانعيها، وليس على أساس نظري وفلسفي ومنهجي مدروس وسليم يضمن لها بقاءها وديمومتها.
فالوحدة المحققة في أيار/ مايــــو 1990 تم إنجازها بعجالة محكومة بالتصورات الفرديــــة والآنيـة لصانعيهـــــا، وليس كهدف وطني محموم يتربع على رأس قائمة أهداف العملية الثورية برمتها، الأمر الذي عرضها لحالة من الانتكاس الكارثي بعد أقل من أربعة أعوام على قيامها، محولاً إياها من عملية قائمة على أبجديات التلاحم والتكافؤ الوطني المتساوي إلى أشبه ما تكون بعملية ضم وإلحاق قسري لطرف مهزوم لصالح طرف منتصر، وهو الواقع الذي ينطبق بحذافيره أيضاً على تجربة الحزب المدنية والإنسانية التي استفدنا منها نحن «أخدام اليمن» بدرجة رئيسية في جنوب ما قبل الوحدة، رغم أنها طبقت وفق بعض التصورات الثورية خارج السياق المنهجي والتشريعي الرسمي للدولة، أي أنها لم تكن مضمنة ضمن النصوص الدستورية الثابتة لليمن الديمقراطية، الأمر الذي عرضها هي الأخرى للانتكاس الفوري، مثلها مثل التجربة الوحدوية تحت وطأة القيم الماضوية المتخلفة القادمة من شركائنا ذوي الغالبية العددية المطلقة في الشمال.
وهذا مرده بطبيعة الحال إلى عوامل الفشل الأبرز الذي اكتسبه الحزب خلال مسيرته الثورية الفريدة، والناجم عن إخفاقه المنهجي أصلاً في تحقيق وترجمة أهم أهدافه الأيديولوجية والثورية المنوطة أساساً بخلق وتحقيق التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية المطلوبة للدفع بالصيرورة التاريخية قدماً؛ إذ إنه وعوضاً عن الشروع بتحطيم جهاز الدولة الاستبدادية والاستعمارية القديم وسحقها، فقد اكتفى ساسته ومنظروه بالاستيلاء على مؤسسات الدولة القديمة، ثم تطويعها لتتواءم مع تصوراتهم الثورية المفرغة في الواقع من أساس نظري وأيديولوجي متين، الأمر الذي جرد العملية الثورية برمتها من أي مضمون تغييري جدي، محولاً التجربة الاشتراكية -التي قاتلنا وضحينا كثيراً في سبيلها في جنوب ما قبل الوحدة- إلى مجرد يافطة تخفي وراءها مجموعة من برابرة القبيلة المتمترسين بقوة خلف «المطرقة والمنجل»، والذين اعتادوا في الحقيقة حشو خطبهم الثورية بالعبارات التقدمية المنمقة واحتساء الكحول والجعة بإفراط، ما جعلهم غير مدركين البتة حقيقة أن قضية الحرية الإنسانية لا تعني فحسب خلع الحجاب وتقويض التراتبية الطبقية وتهميش الألوهية الدينية، بقدر ما هي قضية إنسانية مطلقة، تعني تحقيق الأمان لبيوتنا ولآمالنا وتطلعاتنا التحررية ولأطفالنا وحاضرنا ومستقبلنا... إلخ.
وهذه مسائل لا يعد الكفاح في سبيلها واجباً مقدساً فحسب، بقدر ما هو حق ملزم تفرضه علينا ضرورات الصيرورة التاريخية، لتبدو الحصيلة النهائية للعملية الثورية برمتها تشكل انعكاساً هائـــلاً لأكبر مظاهـــر الإخفاق الثـوري لنظرية سياسيـــــة - أيديولوجية (الماركسية) لا أزال من أشد المؤمنين والمبشريـــن الثوريين بمبادئهــا وأسسها، وبنشيدها الأممـي القائل: «لن يأتينا أحد بالخلاص... لا الرب ولا الملك ولا الأبطال، بل سنتوصل إلى تحرير أنفسنا بأيدينا بالذات».
خلاصة القول: إن ما يمكن استشرافه من وراء كل تلك الإخفاقات التي ميزت الحزب خلال أغلب سني كفاحه الوطني يمكن رؤيته من خلال واقع الحزب اليوم، فبرغم كونه يعد الحزب والأداة الثورية الوحيدة من بين كل منظومة العمل الحزبي والسياسي والحركي في البلاد، يمتلك حضوراً شكلته ظروف وملاحم العمل الثوري على امتداد مراحل العملية الثورية الوطنية، إلا أن كتلته البرلمانية -على سبيل المثال- باتت -وفق نتائج آخر تجربة برلمانية- تقل بشكل مُخزٍ وملحوظ عن الكتلة البرلمانية التي تشكلها أسرة عبد الله بن حسين الأحمر، كأسرة طبعاً، وليس كقبيلة، الأمر الذي يعكس بجلاء مدى الإخفاق الذي ميز تجربتنا الثورية الاشتراكية الفريدة من نوعها في المنطقة العربية والعالم الثالث على السواء؛ فهل سنمتلك القدرة والجرأة في قادم الأيام يا ترى للاستفادة من تلك الدروس والعثرات لاستعادة مجدنا الثوري وهويتنا الاشتراكية من بين الأنقاض؟!
وفي النهاية، يمكنني الاسترشاد هنا بما استشهدتْ به الرفيقة الثورية الملهمة روزا لوكسمبورغ في المنحى بقول ما معناه: «إن الرجال لا يصنعون التاريخ الوطني بإرادتهم المحضة، بقدر نجاحهم غالباً في صنع تاريخهم الشخصي الخاص؛ لأنه من دون إرادة واعية ومن دون عمل واعٍ لأغلبية البروليتاريا فإن الاشتراكية لن تتحقق»، وهذا ما يمنحنا تأكيداً فلسفياً جلياً من ثورية مجربة -مثل الرفيقة لوكسمبورغ- على أن البروليتاريا تعتمد بشكل أساسي ومنهجي في عملها على درجة معينة من النضج في التطور الاجتماعي القائم في وقت وفي حقبة ثورية محددة، يكون معشر الثوريين فيها هم من يملكون القدرة على تسريع أو تأخير هذا التطور التاريخي، من خلال تهيئتهم للظروف والمناخات المادية والموضوعية الكفيلة بدفع عجلة السيرورة التاريخية الناضجة قُدماً إلى الأمام من خلال العمل الجماعي الجاد والمثابر لشحذ وتحفيز الشرارة المتقدة الدافعة والمحفزة لقوة وعي الجماهير الشعبية، بوصفها الفئة والركيزة الطبقية المستفيدة أولاً وأخيراً من مجريات العملية الثورية الراهنة.

.jpg)









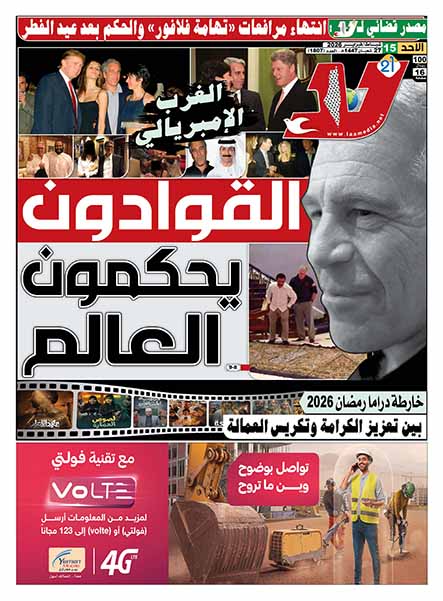
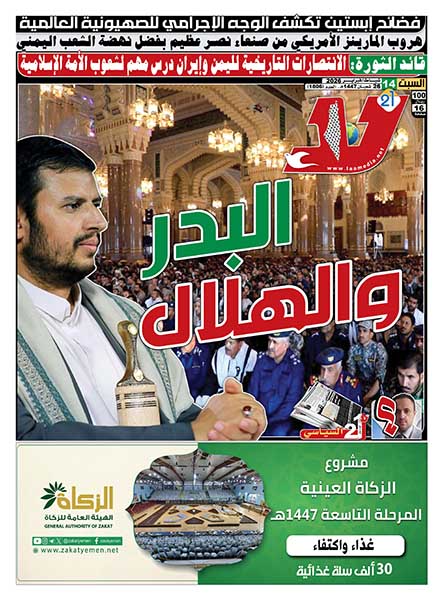





المصدر محمد القيرعي
زيارة جميع مقالات: محمد القيرعي