«بني محمد» تفوق أخلاقي في زمن جاهلي
- محمد القيرعي الجمعة , 13 نـوفـمـبـر , 2020 الساعة 6:36:55 PM
- 0 تعليقات

محمد القيرعي / لا ميديا -
كان الرفيق "فلاديمير الييتش لينين" موفقا بدرجة أكيدة حينما قال: "إن الرجال الحقيقيين الذين نتعرف عليهم في أوقات الشدائد والثورات هم أولئك الذين تتعزز بقيمهم ثقتنا الأكيدة بحتمية انتصار الإرادة الإنسانية يوما ما".
بالنسبة لي كان الرفيق لينين ولا يزال حتى اللحظة محقا بشكل لا لبس فيه فيما يتعلق بتشخيصه الدقيق لنوعية الرجال الذي يتعين علينا معاشرتهم واستلهام قيمهم والاستزادة من مداركهم في أوقات المحن والنكبات، رغم الفارق الزمني الهائل طبعا ما بين تلك الحقبة (حقبة لينين) التي قاد فيها ورفاقه أوائل القرن العشرين أعظم الثورات والتحولات الاجتماعية التي غيرت وجه وطبيعة الحياة والعلاقات البشرية والإنسانية حتى اللحظة، وبين عصرنا الحالي الذي لا تزال فيه شعوبنا ومجتمعاتنا العربية تحديدا عالقة في محيط تخلفها ووثنيتها الأخلاقية بالنظر إلى طبيعة الأنماط الدولانية(1) شديدة التخلف التي لا تزال تحكم سير حياتنا وتتحكم في إدارة الشؤون العامة لبلداننا ومجتمعاتنا وبسبل عيشها وتطورها الطبيعي والتاريخي المفترض... الخ.
وعموماً يمكن القول إن ما دفعني لاستحضار تلك الرؤية اللينينة وفي هذا الوقت بالذات يكمن في نمط ملهم ومميز وفريد من أنماط العلاقات الطبقية والشخصية التي ربطتني لما يقرب من ثلاثة عقود مضت مع شخص ملهم وفريد من نوعه أولا، ومع منطقته الريفية لاحقا، وذلك انطلاقا ليس فحسب من درجة الترابط الروحي الوثيق الذي يجمع الاثنين معاً (الشخص كرمز وزعيم قبلي من جهة وأبناء وقاطني منطقته الريفية على وجه العموم من جهة أخرى)، وإنما بالنظر أيضا إلى حجم وضخامة الأثر التقدمي والحضاري والأخلاقي العميق والمثمر الذي خلفه الأول على صعيد نمط ومستوى الحياة اليومية لمجتمعه المحلي الذي يتزعمه بصورة أبوية إرشادية يندر وجودها على امتداد الجغرافية الوطنية إن جاز التعبير.
شخص يمتلك ثقلا وحضورا اجتماعيا واعتباريا جبارا ليس فحسب على صعيد منطقته ومحافظته فحسب، وإنما على نطاق أوسع من المشهد الاجتماعي والوطني ككل، وتأثيرا جهويا واعتباريا هائلا على صعيد منطقته، وعلى أبنائها وقاطنيها الذين يكنون بدورهم لشخصه كل مظاهر الود والهيبة والولاء والتبعية المطلقة والنابعة في الأساس من حقيقة إحساسهم المجتمعي العام بالثقة والأمان والمسؤولية المشتركة وبالكرامة الطبقية المتجذرة بفضله وفي وجوده في محيطهم.
كان هذا الرجل هو الشيخ الحاج عبدالله عبده المحمدي، رمز منطقة بني محمد- الشمايتين، والذي بدأت علاقتي الشخصية به في النمو الفعلي أواخر العام 1990 وعقب قيام دولة الوحدة.
كنا كشعب نعيش في تلك الفترة حالة جديدة من الاندماج والذوبان الاجتماعي الذي فتح آفاقا واسعة لإمكانية الوفاق والتآخي بين العديد من القوى والمكونات الاجتماعية والسياسية والطبقية التي تخندقت لعقود طويلة ماضية في مواجهة بعضها البعض إبان الحقبة التشطيرية... الخ.
وبما أنني من نوع الأشخاص الذين لا يتفقون بالضرورة مع آرائه وتوجهاته السياسية والأيديولوجية كونه من الزعامات السياسية والاعتبارية والميدانية المهمة داخل مكونات حزب الإصلاح، إلا أن أكثر ما شدني إليه منذ البداية لا يكمن فحسب بتلك الطيبة والبساطة الشخصية المفرطة التي يتسم بها بصورة مغايرة كليا لأقرانه من طبقة المشائخ ما يجعل منه صاحب شخصية آسرة ومؤثرة بحق، وإنما بالنظر أيضاً إلى سعة ثقافته الهائلة بنمطها العصري والمثير للإعجاب والتي يمزج فيها ما بين القديم والحديث، وما بين الخطاب الديني والتقدمي، وبلغة بسيطة وسلسة ومؤثرة.
تلك سمة يندر وجودها في الواقع وبشكل مؤكد بين غالبية نوعه الاجتماعي المتمثل بطبقة المشائخ والنبلاء الذين يعدون تاريخيا من أبرز أحجار العثرة الماثلة في حياتنا والعائق الرئيس أمام إمكانية تقدم مجتمعنا اليمني بصورة مثلى ومظفرة.
وعموما يمكن القول إن علاقتي بالشيخ المحمدي نمت وسط مناخ وطني واجتماعي مشحون بكل عوامل الشك والريبة والتفكك التي خيمت بظلالها على امتداد المشهد الوطني إبان المرحلة الانتقالية التي أعقبت الوحدة.
كانت منطقته (منطقة بني محمد) تتصدى من جهتها وبزعامة المحمدي ذاته لعدوان حربي قبلي شنته ضدها قبائل الزعازع المجاورة كثيرة العدد والعدة.
ما أدهشني حينها في الرجل يكمن في أنه ورغم ضراوة ومشقة الظروف الناشئة التي كان يمر بها آنذاك، فإن مسحة الهدوء والوداعة والثقة المطلقة بالذات كانت هي السمة الأبرز التي يمكن لأي شخص ملاحظتها بوضوح في محيا هذا الرجل، وطريقة عيشه وتعامله اليومي مع الآخرين وفي خطابه الديني والسياسي والاجتماعي السلس والآسر بنزعته الحضارية والإنسانية المبهرة.
كان يحدثني دوما وبتفاؤل شديد عن احترامه المطلق لمبدأ العلاقات الإنسانية العادلة والمتكافئة، وعن إيمانه العميق في أن السلام والعدالة الإنسانية لن يسودا في أي مجتمع كان، ما لم يمتلك جميع أفراده ومكوناته القدرة الحقيقية على اكتساب كل حقوق وامتيازات المواطنة المتساوية، وعلى رأسها حق العدالة والإنصاف القانوني وحق التعلم والعيش الآمن من منطلق تكافؤ الفرص، والذي يعد توافره بحسب كلام الشيخ المحمدي الأساس المادي والمنهجي لدفع عملية التطور الاجتماعي والوطني إلى مصاف مثمرة ومظفرة.
كما أن نظرته للمشيخ كسلطة اعتبارية على الصعيد الاجتماعي كانت محكومة هي الأخرى بمفهومه الشخصي المتقدم والمتمثل في أن القبيلة يمكن أن تتحول إلى مؤسسة اجتماعية داعمة للاستقرار والتطور الاجتماعي إذا ما تحول المشائخ -الذين هو أحدهم، على سبيل المثال- من أدوات للتسلط الاجتماعي إلى مصلحين اجتماعيين وإلى خدام لمجتمعاتهم المحلية إذا ما أحسنوا استغلال نفوذهم لدعم وتعزيز احتياجات التنمية الخدمية في مناطقهم، بالصورة الحية التي يجسدها الحاج المحمدي على أرض الواقع الاجتماعي والتي لمستها شخصيا وعلى مدى ثلاثة عقود مضت عبر إسهاماته الجبارة ليس فحسب في دعم وتمتين المشروعات الخيرية والإنمائية والخدمية بمستوياتها المختلفة على مستوى منطقته والمناطق المجاورة والمتاخمة لها، وإنما بالنظر أيضا إلى الدور المحوري الذي يلعبه بصورة يومية في حل مجمل القضايا والخلافات الاجتماعية الناشبة بين أهالي المنطقة والمناطق المجاورة.
إذ يمكن للزائر لدار الشيخ المحمدي في قرية البطنة- بني محمد، والتي تعد مزاراً يوميا ومفتوحا للمتخاصمين وللمحتاجين أيضاً من شتى مناطق الشمايتين، أن يلمس بجلاء مدى الجهد والإمكانيات الذاتية التي يبذلها الشيخ عبدالله يوميا بسخاء الفاتحين لرأب التصدعات الاجتماعية، وحل الخلافات الناشبة، وسد حاجة السائلين، وبالمجان أيضا، خلافا لما هو سائد على هذا الصعيد في طول البلاد وعرضها، حيث يتحول المشائخ في مثل هذه الحالات إلى ديناصورات تلتهم الأخضر واليابس.
باختصار شديد يمكنني القول إن نظرة هذا الشيخ القبلي والملتحي الإصلاحي في الوقت ذاته، عبدالله المحمدي، لواقع ومستقبل العلاقات الإنسانية يمكن إيجازها من وجهة نظري -كعقائدي ماركسي ومبشر ثوري بعلم الاجتماع السياسي والاقتصادي- بالمبدأ المقدس، الذي رفعه الرفيق لينين كدليل نظري لثورة أكتوبر 1917 الاشتراكية العظمى في روسيا، بما معناه أن "الخبز والأرض والسلام والحرية ضرورية من أجل الشعب".
وهو المبدأ الذي يقول الشيخ عبدالله المحمدي إنه يتفق معي تماما من حيث أهميته الإنسانية والأخلاقية وأن بالإمكان تطبيقه بصورة خلاقة على الصعيد العملي من خلال تلبية ما وصفه بأشواق الروح التي يلخصها بتكريس مبادئ التربية الخلاقة للناس والمجتمع على منهج الإسلام السامي والمتسامح دينا وسلوكا وأخلاقا ومنهاج حياة خالية بالفعل من التعقيدات الأيديولوجية ومفاهيم العنف والتصوف الخلافي العقيم.
والمفارقة الغريبة تكمن في أنه ورغم كل مظاهر الطيبة والكرم والوداعة والمفهوم التقدمي الذي أبهرني به الشيخ المحمدي منذ بداية معرفتي به، إلا أن كل هذا لم يفلح بداية في إقناعي بنبل وصوابية هذا الرجل، ما جعل نظرتي إليه محكومة ومشوبة لأعوام عدة لاحقة بتوجسي، كشيوعي أولاً وكخادم ثائر وناقم على كل ما هو مقدس في حياة القبائل ثانياً، بالعديد من أسباب وعوامل الريبة الأيديولوجية والعرقية التي جعلتني على قناعة شبه راسخة بأن هذا الرجل ما هو إلا شيخ قبلي وأمير حرب يجيد التحدث بلكنة إنسانية، وهذا ما يجعله أشد خطورة من نوعه الاجتماعي، خصوصا إذا ما نظرنا بعين الاعتبار لطبيعة هويته السياسية بوصفه أحد عتاولة حزب الإصلاح الذين ينطبق عليهم من وجهة نظري المثل الباسيكي القائل: "متى ما بدأ الثعلب في الوعظ فقدت دجاجتك"، وهنا يكمن لب المسألة.
إن معضلتنا الرئيسية كمثقفين، ومثقفي اليسار تحديدا، هي أننا اعتدنا النظر للأمور والحكم عليها من زوايا أيديولوجية بحتة، وليس من منظور تشخيصي وموضوعي دقيق بالصورة التي حددت نظرتي سابقا للشيخ المحمدي، متخطيين بذلك حتى رؤية الرفيق كارل ماركس في هذا السياق، والتي لخصها بقوله: "إن الفلاسفة لم يعملوا سوى على تفسير العالم بطرق مختلفة، لكن الهدف هو تغييره نحو الأفضل".
وهي الرؤية التي تنطبق من وجهة نظري على هذا الرجل (المحمدي)، حيث كانت الأيام كفيلة بالطبع بتصويب تلك النظرة المملوءة بعدم اليقين تجاه شخص بات يجسد من وجهة نظري أحد أبرز وأهم الأمثلة الخلاقة على أبجدية السمو والتسامي والتعايش الإنساني المتكافئ والمشترك بالصورة التي يمكن رؤيتها بوضوح من خلال الحكمة والتسامح الطبقي المطلق الذي نجح من خلاله وبزمن قياسي بتحويل حربه وحرب منطقته مع قبائل الزعازع المجاورة إلى أرقى صور السلام والتعايش والانسجام الاجتماعي المشترك السائد بين القبيلتين بصورة يندر وجودها على امتداد الجغرافية القبلية في اليمن والمشحونة كما هو معلوم بكل عوامل الثأر والكراهية الطبقية والعقليات الاحترابية والإلغائية.
لا يقف الأمر عند هذا الحد فقط، فالرجل الذي ينبذ تعاطي القات والتدخين بكل أشكاله، والذي يمتلك في الوقت ذاته بعض المشروعات التجارية الخاصة به في مدينة ومحافظة تعز، بالإضافة إلى شراكته المهمة في عدد من مشروعات الإنماء الخيري والإنساني، حيث تجد بصماته الخيرية بارزة في حياة مئات الأحياء والوجوه والأسر المكدودة والمهمشة على صعيد منطقته (بني محمد)، والمناطق المجاورة لها، والتي ينعم أبناؤها وقاطنوها بالحظ الوفير، وخصوصا الفئات المهمشة (الأخدام) الذين وجدوا في حنو وإنسانية هذا الشيخ الجليل الفرصة المثلى للاستفادة الفعلية من كل مشروعات العون والضمان الاجتماعي والمعونات الإغاثية الممنوحة بمستوياتها الرسمية والمنظماتية المحلية والدولية والمجتمعية أيضاً، عدا عن تلك الممولة على نفقته الخاصة، لدرجة أن العديد من أسر وعائلات القبائل باتوا يحلمون أو يتمنون لو أصبحوا أخداماً ليستفيدوا من امتيازات العون الإغاثي الشهري والضمان الاجتماعي غير المنقطع والموجه بفضل جهود المحمدي لتدعيم الأمن المعيشي اليومي للأسر المسحوقة من طبقة الأخدام وغيرها وبصورة يندر وجودها في أي مجتمع ريفي أو مدني آخر على امتداد الجغرافية الوطنية، حيث تجد مثل هذه الأمور توظف عادة وتوجه على الأغلب لتدعيم نفوذ المشائخ وتعزيز سلطاتهم الاعتبارية والاجتماعية على حساب الإنسانية وبصورة مغايرة تماما لما هو سائد في منطقة ومجتمع المحمدي المحظوظ بدرجة غير قابلة للدحض فعلاً... الخ.
وهو الواقع الذي لمسته شخصيا وبجلاء خلال إقامتي القسرية ولأشهر عدة بفعل عوامل الحرب الأهلية في منطقة الشيخ المحمدي، حيث إن الأمر الذي هالني بشدة خلال فترة وجودي هناك ليس فقط تلك الرفاهية الاجتماعية المطلقة التي يتمتع بها أخدام المنطقة وفقراؤها، بقدر ما شدتني أيضا مظاهر الوفاق والانسجام الاجتماعي الهائلة التي تكتنف حياة الجميع هناك دون استثناء، حيث لم يتبادر إلى مسامعي أية عبارة أو مصطلح ينم عن مظاهر عنجهية أو تفوق عرقي أو سلالي، مثل كلمة "خادم" أو "ناقص" أو "مزين"، على غرار تلك المصطلحات السائدة والمعممة بشكل مهين كجزء من الثقافة الشعبية المتوارثة على امتداد النطاق الديمغرافي الوطني.
فالجميع هناك (أي في منطقة بني محمد) يعيشون بشكل متساوٍ ويجسدون القيمة الحقيقية والأخلاقية لتعاليم الرب وشريعة نبيه محمد الذين لم يتسن لي التعرف إليهما بشكل جلي (أي الرب ومحمد) إلا من خلال احتكاكي المباشر والوثيق بالشيخ المحمدي، الذي قدم لي صورة موضوعية متسمة بالسمو والوداعة عن ماهية الرب ونبيه خلافا للصورة الدموية المشوهة التي قدمها عن الاثنين أغلب ممثلي الرب الزائفين في بلادنا من أصحاب اللحى والعمائم والسكسوكات المسربلة... الخ.
ولعل الأمر الذي أود الإشارة إليه في هذا الصدد يكمن في أن تلك الوداعة المجتمعية (الطاغية في مجتمع بني محمد) لا تعكس في المجمل وجود مجتمع مخملي متراخٍ كما قد يتصور البعض، بقدر ما تخفي وراءها مجتمعاً محلياً شديد البأس والقوة في الملمات، مجتمعاً يشكل بلحمته الطبقية الراسخة بزعامة الشيخ المحمدي ترساً حصيناً يحمي منطقته بكفاءة واقتدار من مغبة الانزلاق في مربع الفوضى والاحتراب والتقطع والاستلاب المشاعي السائد بكافة أشكاله في أغلب المناطق والقطاعات القبلية المتناثرة على امتداد الجغرافية الوطنية، ما يجعل من هذه المنطقة الباسلة والفخورة بأهلها وبرموزها عصية على الانحطاط والتحول إلى منطقة تقدس ثقافة القوة والاستلاب... الخ.
في الخلاصة، يمكنني القول بثقة الفاتحين إن القيم الإنسانية والدينية المثلى والمتسامحة التي لمستها في الشيخ المحمدي منذ بداية معرفتي الشخصية به قبل ثلاثة عقود مضت، والتي ظلت لسنوات عدة مثار تشككي الأخلاقي كما أسلفت، وجدت أنها هي ذاتها القيم المعاشة والمجسدة اليوم في حياة ثلاثة أجيال متلاحقة على الأقل من أبناء قبيلته بصورة توحي بما لا يدع مجالا للشك بأن هذا الرجل نجح ومن خلال قيمه الإنسانية المتقدمة والسامية في خلق مجتمع محلي ثوري وعصري ومتمدن يمتاز بكل مظاهر ومقومات الرقي والنقاء والتفوق الأخلاقي، حيث لا تجد في هذه المنطقة (منطقة المحمدي) من يقطع طريقك أو يسلب مالك أو يستغل حاجتك أو ينتقص من آدميتك وكرامتك وإنسانيتك، مثلما لا يمكن لأي مار أو عابر أو لاجئ إلى منطقة بني محمد أن يشعر بالجوع أو العطش أو حتى الاغتراب، الأمر الذي على ضوئه يمكنني القول بثقة راسخة: "اعطونا يا معشر الجن والإنس ثلاث شخصيات اعتبارية على شاكلة المحمدي فنعطكم وطناً ومجتمعاً مثالياً يخلو من الملحدين أمثالي، مجتمعاً سيتمتع ولا شك بكل مظاهر وامتيازات العدالة والحرية والمساواة والرفاه الاجتماعي الذي نأمله".
وختاماً، أقول ملء فمي: التحية للشيخ المحمدي، الذي أقسم أنا بدموع أطفال الصفيح إنه ومن خلال قيمه وتسامحه الديني منحني الفرصة والحافز لإعادة ترميم علاقتي مع الرب الذي أشكره (أي الرب) للمرة الأولى في حياتي لتكرمه بمنحي فرصة التعرف والاستزادة من قيم ومبادئ هذا الرجل الشيخ والحاج والإنسان عبدالله عبده المحمدي.
-----------------
(1) الدولانية شكل من أشكال النظم السياسية الأكثر بدائية وتخلفا وفردية على الإطلاق، وتعد من المراحل السابقة على نشوء وتطور الدولة الوطنية بأنماطها المؤسسية.
* الرئيس التنفيذي لحركة الدفاع عن الأحرار السود في اليمن- رئيس قطاع الحقوق والحريات في الاتحاد الوطني للفئات المهمشة في اليمن- عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام.
على ذمة الراوي ولا تعبر عن سياسة الصحيفة

.jpg)











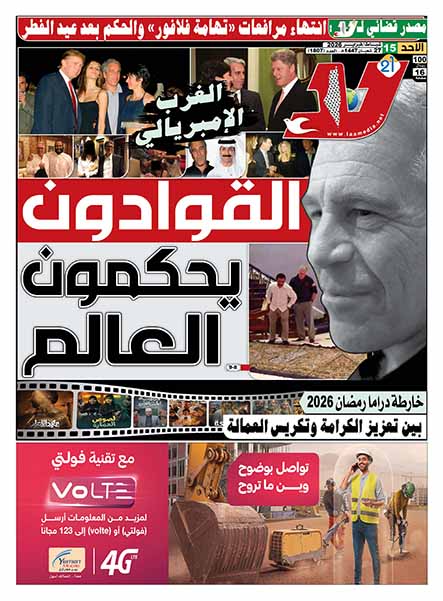
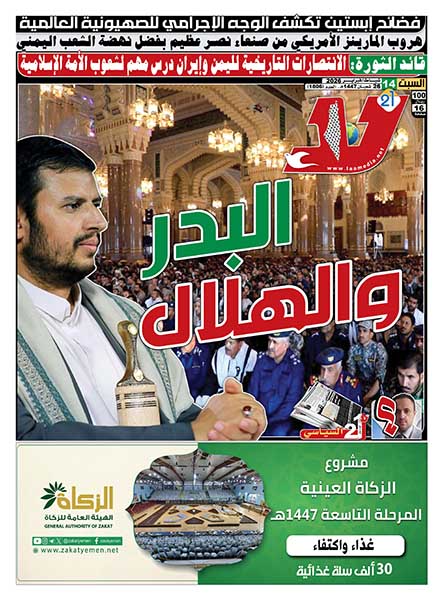



المصدر محمد القيرعي
زيارة جميع مقالات: محمد القيرعي