تراجع الهيمنة الأمريكية في أفريقيا وتنافس البدائل
- أنس القاضي الأربعاء , 9 يـولـيـو , 2025 الساعة 1:56:36 AM
- 0 تعليقات

أنس القاضي / لا ميديا -
منذ القـرن الخامس عشر حتى القرن الواحد والعشرين، شهدت أفريقيا مراحل من العلاقة مع القوى الغربية؛ مرحلة الاستكشاف وتجارة الرقيــق (الهيمنة الاستعماريـــة القديمة)، مرحلة الاستعمار الرأسمالي الحديث الذي سقط مع ظهور حركات التحرر الوطنية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، مرحلة الاستعمار الجديد غير المباشر، وصولاً إلى تراجع الهيمنة الغربية والأمريكية اليوم وهي المرحلة الراهنة.
التراجع الأمريكي في أفريقيا، نتيجة مباشرة لانشغال إدارة ترامب بأولويات جيوسياسية أخرى وتراجع قوة واشنطن الاقتصادية، أدى إلى إهمال أفريقيا كمنطقة استراتيجية مؤثرة في التوازنات العالمية، ما حفز الصين وروسيا لملء الفراغ.
إن التراجع الأمريكي لا يُفضي إلى الانتقال لقوة جديدة واحدة، بل إلى مرحلة انتقالية تتنافس فيها قوى دولية (الصين وروسيا)، وأخرى إقليمية متوسطة (إيران وتركيا ودول الخليج ومصر وإثيوبيا والجزائر وجنوب أفريقيا)، وهناك استغلال من عصابات الجريمة والجماعات الإرهابية وشبكات التهريب والعشائر المحلية المسلحة لهذا التراجع. وبهذا المعنى فإننا لا نشهد فقط لحظة تراجع استعماري، بل لحظة ولادة خرائط نفوذ جديدة (دولية واقليمية ومحلية) في القارة.
تراجع الهيمنة الأمريكية في أفريقيا
رغم الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية المتزايدة للقارة الأفريقية، من حيث الموارد الطبيعية الحيوية، والموقع الاستراتيجي، والتنافس الدولي المتصاعد فيها، لا تزال الولايات المتحدة -وخصوصاً في عهد إدارة ترامب- تتعامل مع أفريقيا بوصفها هامشاً جيوسياسياً، دون امتلاك استراتيجية شاملة وفعّالة تدمج الأبعاد الأمنية والتنموية والسياسية والثقافية في رؤية متماسكة تلبي مصلحة شعوب أفريقيا.
فبدلاً من تطوير شراكات متكافئة وتبادل مصالح مشروعة، اكتفت واشنطن بسلوك إمبريالي يعتمد على المقاربات العسكرية والاستخباراتية، تاركة المجال مفتوحاً أمام قوى دولية أخرى من خارج القارة، على رأسها الصين وروسيا، ومحاولات تركية، لتملأ الفراغ وتعيد صياغة موازين النفوذ في القارة، ومن داخل القارة تسعى كل من جنوب أفريقيا ومصر والجزائر إلى توسيع نفوذها في محيطها الجيوسياسي.
لم تطرح إدارة ترامب أي تصور استراتيجي خاص بأفريقيا، بل خفّضت المخصصات المالية لبرامج المساعدات والتنمية، وأهملت مؤسسات وتحالفات عسكرية مثل "أفريكوم" في التخطيط الاستراتيجي الأوسع، لصالح تركيز محدود على ما تسميه "مكافحة الإرهاب" في مناطق محددة، مثل الساحل الشرقي ودول الساحل الغربي.
في السياق ذاته، لم تتعامل إدارة ترامب بفاعلية مع التحولات السياسية والاجتماعية في أفريقيا -من الثورات الشعبية إلى صعود الأنظمة العسكرية الجديدة- بوصفها فرصاً لإعادة التموضع، بل بدت منفصلة عن التحولات العميقة التي تعيشها القارة، وغائبة عن القضايا الأفريقية الكبرى المتعلقة بالسيادة والعدالة والتنمية المستقلة. ومن هذه الأبعاد التي أغفلتها الولايات المتحدة الأمريكية تنسج روسيا الاتحادية علاقات جديدة مع هذه الدول وتعزز حضورها ونفوذها.
هذه ليست إشكالية ترامب وإدارته فقط، بل أزمة تراجع الهيمنة الأمريكية عموماً؛ فعلى المستوى الاقتصادي، فقدت الولايات المتحدة مكانتها كأكبر شريك تجاري لكثير من الدول الأفريقية، لصالح الصين، التي تضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، وتقدم نفسها كبديل عملي للتمويلات الغربية المشروطة التي لم تفلح في إحداث أي تحديثات اقتصادية طوال العقود الماضية.
وفي حين تمحورت سياسة ترامب حول شعارات، مثل "مواجهة النفوذ الصيني" أو "منع الإرهاب"، لم تُقدّم بدائل تنموية حقيقية، ولم تعد قادرة اقتصادياً على ذلك، ما جعل العديد من العواصم الأفريقية ترى في الشراكة مع بكين أولاً وموسكو ثانياً خياراً أكثر موثوقية.
أما الحضور الأمريكي العسكري في القارة فقد اتسم بالتشتت والتضارب على الدوام؛ فمن جهة تستمر واشنطن في تنفيذ عمليات خاصة عبر "أفريكوم" وتُدير قواعد استخبارية متقدمة، ومن جهة أخرى، تفشل في خلق بيئة سياسية اجتماعية شعبية تتقبل هذا الوجود العسكري وتخلق له شرعية داخلية شعبية، بل إن هذا الوجود يرسّخ صورة "القوة الغربية المتدخلة"، لا الشريك الذي يدعم السيادة والتنمية، ما يفسّر تنامي المشاعر المناهضة للولايات المتحدة في بلدان مثل النيجر ومالي وبوركينا فاسو، التي شهدت تمردات مسلحة مدعومة شعبياً ضد الغرب الأمريكي والفرنسي بدعم من موسكو. وروسيا هنا إنما جاء دعمها في بيئة مهيأة أصلاً للتمرد على الإمبريالية الغربية.
تراجع استراتيجي وتقدّم هادئ للمنافسين
لقد تعاملت الولايات المتحدة مع أفريقيا بآليات غير فاعلة، وبوصفها ملفاً ثانوياً في أولوياتها الخارجية، وركزت على الصدام مع محور المقاومة ومع روسيا والتنافس الاستراتيجي مع الصين ومواكبة التغيرات في أمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطى.
وقد انعكست هذه السياسة في تخفيض حاد للمساعدات التنموية والإنسانية؛ إذ تراجعت مساهمات واشنطن في برامج الصحة والتعليم والبنية التحتية خلال السنوات الأخيرة من حكم ترامب، دون توفير بدائل فعّالة تغطي هذا الانسحاب.
إن تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع إفريقيا بآليات غير فاعلة، وتخفيض واشنطن لمساعداتها التنموية والإنسانية للقارة، ولد فجوة تنموية في علاقتها مع إفريقيا.
وقد نتج عن هذا الفراغ التنموي والسياسي تآكل متسارع في النفوذ الأمريكي، ليس فقط على مستوى الحكومات، بل أيضاً في نظرة الشعوب والمجتمعات. إذ بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تُوصف في الوعي الإفريقي كقوة غير موثوقة، ومع انسحاب الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID) وبرامج الشراكة التقليدية، فقدت واشنطن واحدة من أهم أدوات "التوجيه السياسي الناعم" التي كانت تمنحها الأفضلية السياسية في العقود الماضية.
في المقابل، لم يكن هذا الفراغ محايداً، بل جرى ملؤه بقوى دولية أخرى تسعى إلى تثبيت حضورها وفق أجندات جديدة، تراوحت بين التعاون التنموي غير المشروط (كما في النموذج الصيني)، والدعم الأمني (كما في النموذج الروسي)، والتقارب الأيديولوجي والمصلحي (كما في حالات إيران وتركيا). بل إن بعض الفراغات التي خلّفها الانسحاب الأمريكي جرى استغلالها من قبل فاعلين محليين، مثل الميليشيات المحلية والجماعات الإرهابية، وعصابات الجريمة.
تتجلّى نتائج هذا التحول في المواقف السياسية التي بدأت تتخذها عدد من الدول الإفريقية في المحافل الدولية. فقد امتنعت بعض هذه الدول عن التصويت لصالح مشاريع قرارات أمريكية، ومالت نحو دعم المبادرات التي تقودها الصين وروسيا، في قضايا تتعلق بالأمن، وملف أوكرانيا، وحتى الصراع الفلسطيني -"الإسرائيلي". هذا التبدّل في الاصطفافات يعكس ليس فقط تغير موازين القوة المادية، بل أيضاً تآكل الهيبة المعنوية التي كانت الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بها في السابق.
سياسات البدائل
اعتمدت الصين، منذ أكثر من عقد، سياسة طويلة الأمد تقوم على تعزيز الشراكات الاقتصادية دون التدخل في الشؤون الداخلية، حيث ضخّت استثمارات ضخمة في البنية التحتية، والنقل، والطاقة، والاتصالات، مع تقديم قروض ميسرة دون شروط سياسية مسبقة.
وقد نجحت بكين في بناء صورة لنفسها كـ"شريك تنموي موثوق"، ما جعلها تحظى بقبول واسع في عواصم إفريقية كانت سابقاً تدور في الفلك الأمريكي. وفي المقابل، جاءت العروض الأمريكية محدودة ومشروطة، وغالباً محصورة في قضايا الأمن، والهجرة، ومكافحة الإرهاب، دون رؤية تنموية متكاملة في قارة تشكو المجاعة في بعض الاقاليم.
أما روسيا، فقد ركزت جهودها على البُعد العسكري والأمني، من خلال اتفاقيات التسليح، وتدريب الجيوش المحلية، ونشر عناصر أمنية خاصة في عدد من الدول الإفريقية، لاسيما في منطقة الساحل. وقدّمت موسكو نفسها كحليف لا يفرض أجندات سياسية، بل يدعم الأنظمة في مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية، وهو خطاب جذب حكومات تبحث عن شريك يُعزز سلطتها دون ضغوط خارجية.
تحوّلات القوة في لحظة التراجع الأمريكي
في ضوء ما سبق من تحليل لأزمة القيادة الأمريكية وتفكك أدوات الهيمنة في عهد إدارة ترامب فنحن أمام انتقال مركز الهيمنة من قوة إلى قوى أخرى وأمام تشظٍ في النظام الدولي.
الصين تمثل البديل الأكثر تنظيماً، حيث تسعى إلى قيادة نظام عالمي متعدد الأقطاب عبر أدوات اقتصادية واستثمارية (الحزام والطريق، بنك التنمية الآسيوي)، دون تبنّي الهيمنة العسكرية المباشرة. وتُفضل بكين نمطاً من "الهيمنة غير المتدخّلة"، ما يمنحها قبولاً في دول الجنوب الباحثة عن شراكات غير مشروطة.
روسيا، من جهتها، تُركّز على ملء الفراغ الأمني في مناطق الانسحاب الأمريكي، خصوصاً في الغرب الأوسط وإفريقيا، عبر اتفاقيات تسليح، وتدخلات غير نظامية، ومواجهة مباشرة للنفوذ الغربي.
تمثل تركيا وإيران نموذجاً للدول المتوسطة من خارج القرن الإفريقي التي تحاول أن توسع حضورها في القارة، وبالطبع فإن جهودهما هذه لا تقارن بالجهود الصينية -الروسية، كما أن جهود تركيا أقوى من الجهود الإيرانية في إفريقيا. وهناك أيضاً الإمارات وقطر والسعودية. وداخل إفريقيا ذاتها هناك دول بارزة تريد توسيع حضورها مثل الجزائر والمغرب ومصر وإثيوبيا ودولة جنوب إفريقيا.
كما بات اليمن طرفاً فاعلاً في معادلات الأمن الإقليمي والبحري، واستطاع فرض قواعد اشتباك على قوة عظمى كأمريكا، ما يعكس تحوّلاً نوعياً في مكانة "الأطراف المقاومة" ضمن بنية النظام الدولي. وبرغم التراجع الأمريكي من عموم إفريقيا فإن الأسلوب الأمريكي في الهيمنة العسكرية وضمن مفهوم "مكافحة الإرهاب والقرصنة"، يجعلها أكثر تشبثاً بمنطقة القرن الإفريقي، خصوصاً منطقة مضيق باب المندب، ما يعني أن الصدام الإفريقي -الأمريكي، واليمني -الأمريكي سيظل مستمراً في منطقة القرن الإفريقي.

.jpg)










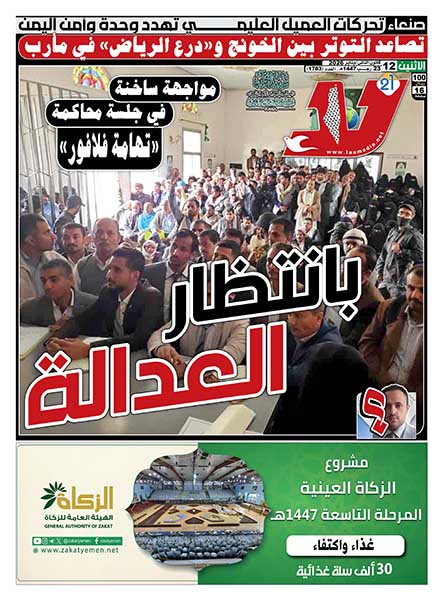
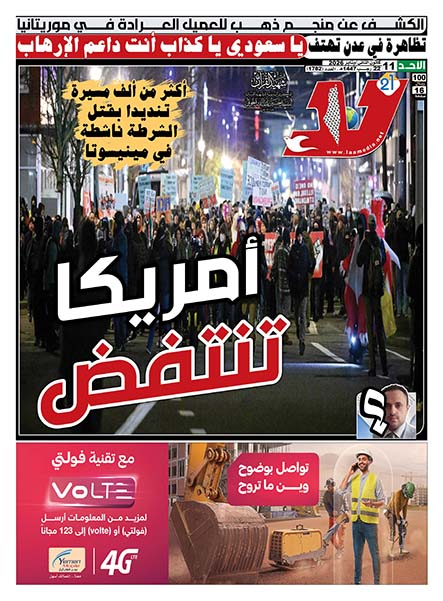

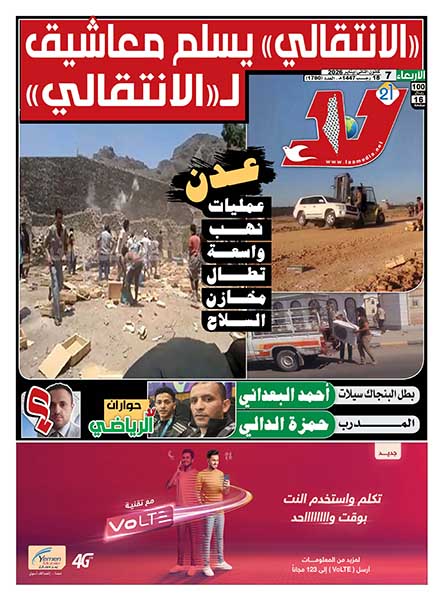

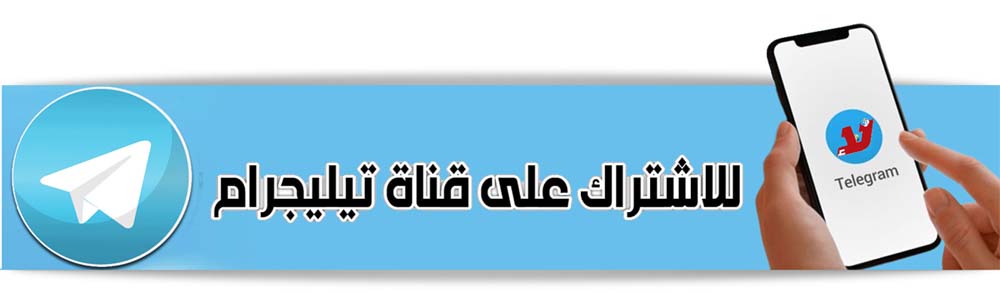
المصدر أنس القاضي
زيارة جميع مقالات: أنس القاضي