الهوية الإيمانية للمجتمع المتمدن (1-2)
- أنس القاضي السبت , 21 مـارس , 2020 الساعة 7:54:59 PM
- 0 تعليقات

أنس القاضي / لا ميديا -
تابعتُ ردود الأفعال حول خطاب الهوية الإيمانية في جمعة رجب، مركزا على الردود السلبية، وخاصة من الكتاب والشخصيات المعروفة بموقفها الوطني، الذين افترضوا أن «الهوية الإيمانية ضد الهوية الوطنية»، وتزيد من «الانقسام الوطني الطائفي»، وتستدعي الفوضى ونماذج الحكم «الطالبانية»، وأنها «هوية قروية فعاليتها في الريف»، وطرحت مخاوف من أن تُصبح دعوة عصبية كـ»الأقيال». بعض هذه المخاوف لها جوانب صائبة نسبياً، وبعضها غير صائب تماما؛ لكن المؤكد أن الدعوة إلى الهوية الإيمانية في عواصم المدن ستحتاج إلى برنامج عمل مختلف عن العمل في الريف من أجل نجاح تغلغلها في واقع المدينة المُعقد، وحمايتها من التحريف.
من البديهي أن العدو يسعى لإعاقة هذه التوجهات كسواها من التوجهات الوطنية. ومؤكد أن لديه حوافز أكبر لتخريب الهوية الإيمانية النقيضة للهوية الوهابية السعودية ولأنماط التفكير والسلوكيات الانهزامية والأنانية (وقد انعكست هذه المساعي في مقال للعميل ياسين سعيد نعمان)، فالهوية الإيمانية تمثل خطورة على التصورات الدينية والاستعمارية المتخلفة والمُعززة للتخلف من أن يستوعبها المجتمع كمنظومة ويتمثلها في سلوكه العملي فيتجه نحو التعاون والنهوض والبناء.
باعتقادي هناك مساران للعمل عبرهما يُمكن نشر الهوية الإيمانية وتوسيع قاعدة من يستشعرونها، ثم يتمثلونها في مجتمع المدينة المعقد. المسار الأول: وضع برامج عمل متطورة لتقديم موضوعات الهوية الإيمانية والمعالم الأساسية في الإسلام إلى مجتمع المدينة، وخاصة شريحة المتعلمين الجامعيين والمثقفين والفنانين والأدباء. والمسار الثاني: معالجة التشوهات الأخلاقية والسلوكية التي رافقت عملية التحديث في المدينة بدون الصدام مع عملية التحديث المستمرة والعودة عنها. وهذه المسألة الأخيرة لا تهم فقط أصحاب الفكر الإسلامي، بل أيضاً الاتجاهات التقدمية في العلوم الاجتماعية.
إذا ما تم معالجة الإشكاليات الناتجة عن عملية التحديث الاجتماعية، الاقتصادية، التربوية، الإعلامية، الثقافية، التقنية... ومحاربة التصورات الوهابية عن الدين، لتحل محلها التصورات القرآنية وفق المعالم الأساسية في الإسلام ومنظومة الإيمان، حينئذ سيكون المجتمع في المدينة قد امتلك إيمانية هويته الروحية الاعتقادية السلوكية، بدون الصدام معه والقسر والفرض عليه أو تجاهله وتركه في موقع المعادي.
المعالجات، إلى جانب كونها ممكنة التطبيق وفق برنامج عملي واقعي حكيم تدريجي مسؤول، فهي احتياج للشعب يدركه الإنسان بعد أن يعرف هذه الهوية. فعلى الصعيد العقيدي غالبية مجتمع المدينة يعيش حالة تزعزع وشك في تصوراته وقناعاته السياسية والدينية، وهو بحاجة إلى يقين إيماني وإلى التصورات القرآنية الجديدة الحضارية الإنسانية العملية الخلاقة المبدعة (المتحررة من الجبر المضاد لحرية الاختيار ومن السلبية التي تنفي قيمة الوجود والحياة على الأرض ونعم الله)، وهذه التصورات الجديدة هي عين ما تحدث عنه الشهيد القائد رضوان الله عليه.
مخاوف طرحت إزاء الهوية الإيمانية:تجريف الهوية الوطنية
مفهوم الوطن جاء من الطابع الجزئي التحويري لمفردة «الموطن» من حيث الدلالة العملية الحسية للموطن، التي يتلقاها الإنسان يوميا وتنطبع في وجدانه كملامح وصور بلاده وذكرياته، والمأثورات الشعبية القديمة تؤكد ذلك. على سبيل المثال: «عز القبيلي بلاده»، أي قبيلته، أي الموطن. والنشيد الوطني اليوم تطور في ظروف العصر عن المقولات القديمة عن الموطن. والانتماء إلى الموطن يتسع ويتعدى حدود القبيلة والعشيرة والمحافظة والمنطقة، مع الاندماج الاجتماعي ووحدة السوق المحلية وتوسع سُلطة الدولة المركزية. وقد حققت بلادنا ذلك وقطعت فيه شوطا كبيراً مقارنة بوضع الخمسينيات، وهذا مكسب لا ردة عنه.
ويتحول الحس الوطني في الهوية الوطنية إلى سلوك وطني في مواجهة التهديد الأجنبي، عبر مسارين: مسار تعبوي ثقافي يدفع الإنسان إلى الاعتزاز بوطنه والدفاع عنه ولو كان غير مستفيد من سلطته، ومسار ثان يتعلق بتجسد المواطنة في ممارسة السُلطة القائمة في البلد. وهذا الأمر يتم بالتدريج. ويتجلى تعمق الهوية اليمنية وتملكها للوجدان الشعبي اليمني -صاحب المواقف السياسية المتباينة في الواقع الراهن- عندما يشارك المنتخب اليمني في مباريات خارجية ضد منتخب دولة أخرى.
الدعوة إلى الهوية الإيمانية لم تأتِ لتناقض هذه الحقائق، ولا لترتد عن الهوية الوطنية اليمنية كهوية راسخة؛ فهي هوية روحية للشعب اليمني، وليست هوية سياسية. ومن يقاتلون في سبيل الله ضد العدوان بدافع من هذه الهوية يجسدون سلوكاً وطنياً ملموساً في الواقع، منافياً لما تمارسه قوى الارتزاق من أعمال خيانية وإن رفعت الشعارات الوطنية؛ فالهوية الإيمانية تنطوي على عناصر مسؤولية تدفع الإنسان المُسلم إلى الدفاع عن وطنه وإخلاص التوحيد لله بتحقيق الاستقلال الوطني.
الانقسام الطائفي والوطني
الانقسام الطائفي ليس موجوداً في المجتمع اليمني. وليس في خطاب الهوية الإيمانية نزعة مذهبية، فهي قائمة على النص القرآني الذي يجمع كل المسلمين من مختلف المذاهب. والنزعة الطائفية في ممارسة طرف المرتزقة في التهجير والقتل والنهب والسحل لا تتجاوب معها ممارسة طائفية مماثلة من قبل الجيش واللجان الشعبية.
أما في مسألة الانقسام الوطني فإن من يفترضون هذه المخاوف يتجاهلون حقيقة أن الانقسام بين القوى الوطنية وقوى العدوان ليس انقساماً وطنياً داخل الصف الوطني، بل هو انقسام سياسي بين توجهين سياسيين: وطني، وغير وطني، وهو انقسام سابق للعدوان ويعود إلى ما بعد انتفاضة 11 فبراير 2011م والقوى المعادية للثورة والسيادة والاستقلال الوطني المرتبطة بالأجنبي، من حينها، تتعامل مع أي شعار يرفعه أنصار الله بعدائية، ومن الطبيعي أن ترفض الهوية الإيمانية، ولن يكون رفضها الجديد شقا للمجتمع.
من أجل ان يكون الانقسام وطنيا فيجب أن يكون بين الوطنيين. خطاب الهوية الإيمانية لا شك سيصنع مسافة بين من يدافعون عن الوطن من مبدأ إيماني ومن مبدأ وطني وفلسفي قومي ويساري ويريدون أن يحتفظوا لأنفسهم بأفكارهم الخاصة ولا ينكرون على القوى الإسلامية الوطنية أفكارها.
هؤلاء الأخيرون هم شريحة محدودة بالنسبة إلى مجتمع الشعب اليمني، واعتراضهم على الهوية الإيمانية كعنوان رئيسي لخوض الصراع مع العدوان لن يؤدي إلى تراجع الاندفاع الشعبي عن الالتحاق بالجبهات المسلحة، فالخطاب الإيماني المتضمن قضايا وطنية هو الذي يقوم بالدور الأكبر في مهمة الحشد للجبهات والتعبئة للمجاهدين، فيما فاعلية الخطاب الوطني القومي اليساري الذي يحشد إلى الجبهات فاعلية محدودة، وتأثير الخطاب يسهم في رفع الوعي السياسي للشعب أكثر منه في التحشيد الكفاحي الجهادي. ومرد هذا الأمر إلى طبيعة التركيبة الاجتماعية اليمنية؛ فغالبية السُكان ريفيون (سكان الريف وجزء من سُكان المدينة)، ومستوى وعيهم ومحصلتهم العلمية متدنية. كما أن السُلطة السابقة من حيث آليات سيطرتها العصبوية والفاسدة لم تجسد المواطنة المتساوية، مما يجعل غالبية الشعب دون الهوية الوطنية، وبعيدا عن المعتقدات الأيديولوجية الحديثة العلمانية، ينتمي لهويات مناطقية ومذهبية.
على المستوى العسكري، ليس هناك أية مخاوف من وجود هذا التباين في الصف الوطني. وتداعيات هذا التباين ستكون على الأصعدة المدنية، كالنشاط الإعلامي السياسي والوقفات والمبادرات المدنية... وغيرها. وهذه المسألة وإن كانت لا تؤثر على المسار الرئيسي العسكري، رأس حربة المواجهة، فمن المهم التنبه لها ومعالجتها، فالأدوار المدنية الأخرى مكملة للدور العسكري، وحروب العصر لم تعد اشتباكاً بالسيوف والرماح، فمعظم مجالاتها مدنية ومعرفية.
صحيح أن المدينة ليست خزاناً بشرياً عسكرياً بمستوى الريف، إلا أنها قوة مدنية ناعمة هامة، إذا لم تكسبها الحركة القرآنية الثورية فقد تؤثر حتى على الصمود العسكري، بما تملكه الجماهير المدنية من أساليب نضال تمرستها منذ 2011 وما قبله، كالعصيان والشغب والمظاهرات والاعتصامات، أو ما تعرف بالثورات الملونة وحروب الجيل الخامس. والقوى المعادية تعمل على هذه المسارات المدنية دون كلل، كما أثبتت اعترافات الخلايا المرتبطة بالعدوان التي ضبطتها الأجهزة الأمنية اليمنية. واليمن في هذه المرحلة التاريخية أشد حاجة إلى تلاحم الجبهة الداخلية وضمان قواعد ثورية وطنية في المدينة، لا تقل عما كانت عليه في ثورة 21 أيلول 2014، التي جسدت التفافا شعبياً منقطع النظير حول أنصار الله حول قضايا ملموسة، وأظهرت تفاعلا فريداً بين الريف والمدينة، وبين شكلي النضال الذي تم وحقق النجاح والنصر.
العصبوية الضيقة
بالنسبة لمخاطر تحول الهوية الإيمانية إلى عصبية ضيقة كدعوة «الأقيال»، فهذا مستبعد من حيث إن الهوية الإيمانية كما حددها السيد القائد هي هوية حركية فاعلة مرتبطة بكيان الإنسان الداخلي وقناعاته ودوافعه، وليست هوية خارجية مضافة إلى الإنسان يستدعيها سياسيا ويتمايز بها عن الآخر من منطق سمات ظاهرية كالعرق واللون.

.jpg)








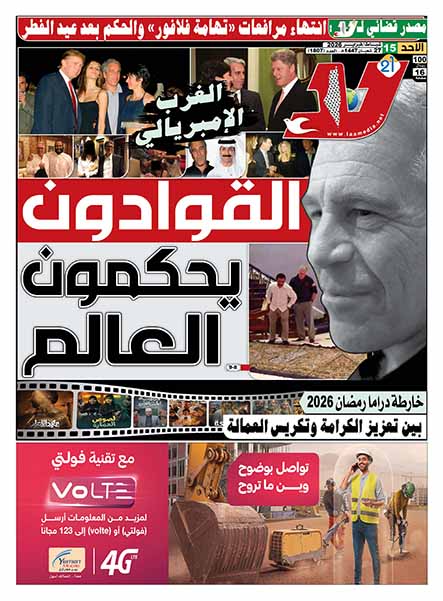
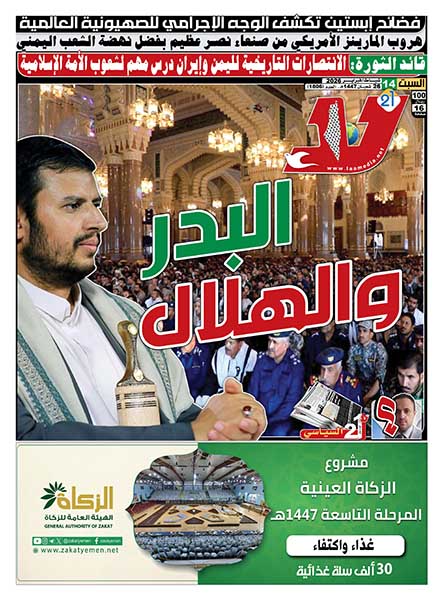






المصدر أنس القاضي
زيارة جميع مقالات: أنس القاضي