كيف أُسقطت سورية؟ وما هو مستقبلها؟
- أنس القاضي الأثنين , 16 ديـسـمـبـر , 2024 الساعة 12:25:57 AM
- 0 تعليقات

أنس القاضي / لا ميديا -
في غضون أيام، سقطت الدولة السورية أمام جحافل من الجماعات الإرهابية التي تتزعمها «هيئة تحرير الشام»، والقائد التكفيري الجولاني، سقوطاً مدوياً، لم يُصدق، ولا يُمكن تفسيره باعتباره حدث أسبوع أو عشرة أيام، بل هو أقرب إلى أن يكون حصيلة تراكمات 14 عاماً من الحرب القائمة في سورية، ومن التدمير والحصار والإنهاك، هوت معه سورية دولةً، لا مجرد نظام البعث الحاكم، وكان مشهد النهاية الغامض صادماً. وأياً كانت تفاصيل مشهد النهاية وما جرى في كواليس آخر أسبوع في سورية، وهو ما لا يمكن التحقق منه بصورة دقيقة، فإن ظروف سورية في الـ14 عاماً الأخيرة معلومة، وهي تفسر الأزمة التي بلغتها الدولة السورية، والتي جعلت من الممكن أن تَسقط سورية بذاتها، وأن تُسقط بالتدخلات والخيانات الأجنبية!
واقعياً سقط النظام السياسي السوري في العام 2011، حينما عجز بجهوده الذاتية عن الاستمرار في الحكم، والتماسك أمام التظاهرات الشعبية، التي ظلت حتى مطلع ذلك العام سلمية، قبل الانتقال إلى الحرب والانشقاقات العسكرية وظهور الجماعات الإرهابية.
بداية من العام 2010 كانت تربط سورية علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، وسعت الولايات المتحدة آنذاك من انفتاحها على دمشق أن تبعدها عن محور المقاومة. كما أن السعودية كانت في ذلك العام تصالحت مع سورية في سبيل أن تأخذها بعيداً عن إيران. إلا أن جهود الدولتين لم تنجح.
رغم الإنتاج السوري المتطور والاكتفاء الذاتي النسبي، وعدم وجود ديون أجنبية، فقد دخل البلد مرحلة الأزمة الاقتصادية التي انعكست مباشرة على المجتمع، خصوصاً الأرياف، وذلك بتأثير الأزمة المالية العالمية 2008، وبتأثير الإصلاحات الاقتصادية النيوليبرالية التي وسعت التفاوت الطبقي، وبروز «اقتصاد المحسوبيات» الذي جعل الثروة التي تنتجها سورية تتراكم في يد قلة على حساب المنتجين. كما أن استمرار نظام حكم الحزب الواحد الشمولي منذ العام 1963، وكل هذه القضايا، أدت إلى انتفاضة شعبية في سورية. هذه الأوضاع أوجدت ثغرة تسللت منها القوى المعادية (الولايات المتحدة، تركيا، قطر، السعودية، الإمارات، فرنسا، الكيان الصهيوني)، والتي دخلت على مسرح الأحداث بهدف تدمير الدولة السورية، وتحقيق مصالحها الجيو سياسية والجيو اقتصادية. وقد نجحت هذه الجهود العدوانية في نهاية المطاف بتحقيق هذا الأمر في ديسمبر 2024، بإسقاط الدولة السورية.
منذ العام 2013 استند النظام السوري من أجل بقائه، على الدعم الأجنبي (الإيراني - الروسي) ومساعدة حزب الله اللبناني، وهذا ما أطال في عمره، حتى العام 2024. وبخلاف العام 2011م الذي سقط فيه النظام واقعياً وعجز عن الصمود بدون دعم الحلفاء، فإن ما سقط في العام 2024 هو الدولة السورية، على غرار ما حدث في العراق في العام 2003. وهناك تفاصيل كثيرة تشترك مع تجربة إسقاط الدولة العراقية، منها فرض حصار اقتصادي خانق، وفرض عزلة إقليمية، وإفقار وفساد وضعف في صفوف الجيش، وصولاً إلى الاجتياح العسكري الشامل.
استناداً إلى دعم الحلفاء من محور المقاومة افترض النظام السوري أنه قادر على الاستمرار وليس بحاجة إلى تسوية سياسية مع المعارضة، وبالتالي قام بعمليات عسكرية على مواقع الجماعات المسلحة المتطرفة «منتهكاً» اتفاقية «خفض التصعيد»، وحقق في هذه المعارك انتصارات مهمة. كما رتب لانتخابات رئاسية في العام 2021 بدون مشاركة المعارضة فيها. وفي ظل انقسام البلد والمجتمع، شعر النظام السوري بالأمان أكثر مع استعادة العلاقات مع السعودية والإمارات والعودة إلى الجامعة العربية، وحصل على وعود خليجية بإعادة الإعمار. بناءً على هذا الواقع الجديد رفض الأسد لقاء أردوغان واشترط أولاً الانسحاب التركي من الأراضي السورية ووقف دعم تركيا للمعارضة المسلحة المتطرفة وتجريدها من السلاح.
وفيما كانت التحالف (الروسي - الإيراني - السوري) يعمل على تقوية النظام، كان التحالف (الأمريكي - التركي - القطري) يعد لسيناريوهات أُخرى. ومع تفكك سورية واقعياً إلى أربع مناطق عسكرية، جندت تركيا الكتلة السكانية الواقعة على حدودها وأعادت هيكلة الجماعات المسلحة، ودعمت الولايات المتحدة «قوات سورية الديمقراطية» الكردية، ورعت قطر إعلامياً ومالياً الجماعات المسلحة، واستهدف الكيان الصهيوني طوال معركة «طوفان الأقصى» مواقع سورية وتحركات حزب الله وإيران، وكانت الجماعات المسلحة التركية مستعدة للهجوم، مع إدراكها ضعف الجيش السوري وعدم رغبته بالقتال.
التطورات في المنطقة والعالم، بدخول الكيان وحزب الله في مواجهات مباشرة في لبنان اضطر معها الحزب لسحب جزء من قواته في سورية لدعم معركة الجنوب، ومع انشغال إيران بواقعها الداخلي في ظل الحكومة «الإصلاحية»، ومع انشغال روسيا بمعركتها في أوكرانيا التي شهدت تصعيدا، هذه التطورات الداخلية والإقليمية والدولية، هي التي حددت ساعة الصفر، لتشن الجماعات المسلحة هجومها وتتهاوى مواقع الجيش السوري دون قتال، وبحسب التصريحات الروسية والإيرانية، فلم يجد الحلفاء قوات سورية تقاتل على الأرض لإسنادها، وكذلك حزب الله لم يجد الجيش السوري مقاتلاً لدعمه ميدانياً. وهكذا سقطت سورية في غضون أيام في يد الجماعات المسلحة.
سقط النظام السوري وخرج من المحور، وفي ذلك خسارة كبيرة لمحور المقاومة عموماً، إلا أن الأهم اليوم هو مصير سورية كدولة، وهناك ثلاثة سيناريوهات يصعب الحكم أي منها سوف يكون الأرجح. وفي مختلف هذه السيناريوهات، ستكون علاقات سورية أكبر من تركيا والولايات المتحدة وقطر، ومتصالحة مع الكيان الصهيوني باتفاقية رسمية أو وضع الأمر الواقع بدون اتفاق. وهذه السيناريوهات كالتالي:
السيناريو الأول: تشكيل نظام «ديمقراطي طائفي» على غرار العراق، يقوم على أساس من التوازنات العرقية (العربية - الكردية) والطائفية (سنة - علويين - إسماعيلية) مع مشاركة حزبية سياسية وانتخابات.
السيناريو الثاني: دولة «إسلامية» تهيمن عليها الجماعات التكفيرية متصالحة مع الكيان الصهيوني مضطهدة لبقية الطوائف الدينية معادية لإيران وحزب الله. وسوف ينتهي هذا السيناريو بحرب أهلية.
السيناريو الثالث: انتقام الجماعات المسلحة من خصومها وحل الجيش وحل حزب البعث كما جرى في العراق، وبالتالي اندلاع حرب أهلية تقف فيها الأقليات الدينية إلى جانب بقايا البعث والجيش السوري القديم.
النظام السياسي السوري
تولي حزب البعث السلطة في سورية عام 1963، عقب انقلاب عسكري على حكومة الرئيس نظام القدسي، وأصبح الحزب القوة المهيمنة على النظام السياسي السوري.
رسخ حزب البعث من مكانته في دستور عام 1973، حيث نصت المادة الثامنة منه على أن «حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة»، على غرار الأنظمة الاشتراكية آنذاك. هذا النص الدستوري منح الحزب دوراً مركزياً في صياغة السياسات وتوجيه النظام. إلا أن النظام لم يكتفِ بالهيمنة عبر الحزب الحاكم، بل اعتمد إضافة إلى ذلك على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لضمان استمرار سلطته في مواجهة المعارضة.
وأما المعارضة السورية، التي ظهرت بعد «الربيع العربي»، فتعود أصولها إلى «التجمع الوطني الديمقراطي» الذي تأسس عام 1979 كتكتل معارض ناتج عن الانقسامات والانشقاقات عن الأحزاب اليسارية والقومية العربية المنضوية تحت الجبهة الوطنية التقدمية التي يقودها حزب البعث الحاكم.
تعرض «التجمع الوطني» لضربة إبان أحداث الثمانينيات التي فجّرها الإخوان في حماة من منطلق طائفي، وتم إحياء نشاط التجمع بعد صعود بشار الأسد إلى السلطة عام 2000، الذي وفر بشكل مؤقت نوعاً من الحريات السياسية، في أوائل الألفية الثانية ضمن الحراك المدني المسمى «ربيع دمشق». وكان التجمع جزءاً من المشاركين في «إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي» عام 2005.
شكل «إعلان دمشق» أكبر تجمع لأقطاب المعارضة السورية، لكن سرعان ما تفاقمت الخلافات بين مختلف التيارات المنضوية تحت لوائه، بدءاً من تعليق الإخوان المسلمين نشاطهم لتشكيل تحالف مع نائب رئيس الجمهورية المنشق آنذاك عبد الحليم خدام، ووصولاً إلى الخلاف اليساري الليبرالي حول جدوى الاستعانة بالخارج لإسقاط النظام السوري على غرار التجربة العراقية في إسقاط نظام البعث في العراق، إذ كان الليبراليون يريدون تكرار التجربة، فيما وقف اليسار على الضد من هذه الفكرة.
وضع المعارضة بعد الانتفاضة
مع اندلاع الانتفاضة الشعبية السورية في آذار/ مارس 2011، توحدت المعارضة مجدداً في «هيئة التنسيق الوطنية». عَرّفت هيئة التنسيق نفسها بأنها تجمع لتيارات ماركسية وقومية عربية وكردية وسعت إلى تجاوز نواتها اليسارية من خلال ضم شرائح أخرى إلى صفوفها، كـ»التيار الديمقراطي الإسلامي» وجهات محسوبة على الشباب المتظاهرين كـ»حركة شباب 17 نيسان» و»حركة معاً».
ساهم رفض «هيئة التنسيق» المعارضة المشاركة في اللقاء التشاوري الذي دعا إليه النظام في تمزيق هذه التحالف المعارض، فبينما كان رفض التيارات الليبرالية والإسلامية في الاستجابة لدعوة النظام ناتجاً عن رفض الحوار مع النظام من حيث المبدأ، كان رفض اليسار ناتجاً عما وصفته بغياب المناخ الملائم للحوار في ظل اتباع النظام الحل الأمني للتعامل مع المظاهرات.
تعززت الانقسامات داخل المعارضة مع تغير المناخ الإقليمي والدولي المصاحب لانهيار نظام القذافي في ليبيا بمساعدة الناتو، فأسس الإخوان «المجلس الوطني» في اسطنبول بدعم أمريكي تركي.
رداً على تأسيس «المجلس الوطني» عقد ما تبقى من قوى المعارضة في هيئة التنسيق «مؤتمر حلبون» في ريف دمشق، وطرحت فيه شعار اللاءات الثلاث: «لا للعسكرة، لا للطائفية، لا للتدخل الخارجي»، وبناءً على ذلك شاركت في الانتخابات النيابية في العام 2012، ثم اختلفت مع النظام لاحقاً، وتفتت، وفي المجمل أصبح «المجلس الوطني» المدعوم خليجياً وأمريكياً وتركياً بثقله الإخواني هو المعارضة السياسية الأبرز خارج البلد.
الانتفاضة في سورية
دخل النظام السوري أزمة عميقة في آذار/ مارس 2011 باندلاع الانتفاضة الشعبية. كان السبب الرئيس للاحتجاجات ضد حكم الأسد يتمثل في ضعف الشرعية السياسية لحكم البعث لدى غالبية المجتمع، نتيجة للإحباط من الفساد، والقمع السياسي والأمني وحكم الحزب الواحد الشمولي، وقضايا «التوريث الجمهوري»، وبسبب تدهور الأوضاع المعيشية بعد الأزمة الاقتصادية العالمية 2008، والتراجع الاقتصادي بفعل الإصلاحات الاقتصادية النيوليبرالية التي قادها بشار الأسد، وظهور نظام اقتصادي من المحسوبيات للمقربين من النظام. رغم ذلك كانت البلاد تسجل معدلات نمو إيجابية وتتطور صناعياً. هذه العوامل السياسية والاقتصادية هزّت شرعية النظام، كغيره من الأنظمة العربية بعد الاحتجاجات الشعبية في العالم العربي التي سُميت «الربيع العربي».
الجدير بالذكر أن الانتفاضة السورية جاءت في ظل تحسن العلاقات السورية مع السعودية والولايات المتحدة، وكانت الرياض وواشنطن تسعيان من ذلك إلى سحب سورية من محور المقاومة، وعادتا في آخر أيام الأسد لتطرح عليه الأفكار ذاتها، فلم تدْعُ هذه الدول إلى تنحية الأسد إلا في العام 2012. كما أن جماعة الإخوان المسلمين فرع سورية كانت قد علقت نشاطها المعارض في العام 2009، دعماً لموقف النظام المقاوم والداعم لحماس؛ فالانتفاضة في بداية المطاف كانت عفوية شعبية وليست مؤامرة خارجية كما كان يطرح النظام، وكما أصبح عليه الوضع لاحقاً.من العام 2011 حتى العام 2012، كانت مطالبات المعارضة السورية لحل الأزمة السياسية، تتلخص في:
- تنحي الرئيس بشار الأسد.
- إنهاء احتكار حزب البعث للسلطة.
- إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
- وقف العنف وإطلاق عملية انتقال سياسي وفق بيان جنيف 2012.
- صياغة دستور جديد يضمن: العدالة، المساواة، والتعددية السياسية.
في العام نفسه، 2012، وتحت ضغط الاحتجاجات الشعبية والضغوط الدولية، أجرى النظام السوري تعديلات دستورية ألغت المادة الثامنة، مما سمح نظرياً بالتعددية الحزبية. ومع ذلك، ظل حزب البعث مسيطراً فعلياً على النظام السياسي، ولم يحدث أي تقدم في بقية المطالب السياسية.
عسكرة الوضع في سورية
ظلت الانتفاضة سلمية في الأشهر الأولى دون عنف مسلح ولا وجود للجماعات الإرهابية. إلا أن النظام والمعارضة عجزا عن التوصل إلى اتفاق سياسي. ومع تعقد الخلافات السياسية، واستمرار قمع التظاهرات، بدأ الوضع في سورية يتعسكر. وبداية من النصف الأول من العام 2012، دخلت سورية مرحلة الحرب، وفتحت البلد على مصراعيها للجماعات الإرهابية، التي أصبحت تركيا معسكراً خلفياً لها، وأصبحت الفواعل الدولية هي المُقرر لمصير سورية.
ظهرت الفصائل العسكرية و»الجهادية» المعارضة بشكل بارز في منتصف العام 2012، بداية مع انشقاق وحدات من الجيش السوري وتشكيل ما سمي بـ»الجيش السوري الحر»، بالإضافة إلى ظهور جماعات إرهابية مثل «جبهة النصرة». من الجانب الآخر حصل النظام السوري على دعم عسكري من إيران وحزب الله بشكل قوي من العام 2013. أما القوات الروسية فقد دخلت على الخط بسلاح الجو المتطور بداية من العام 2015.
دخل الروسي لحسابات جيوسياسية لها علاقة بالقاعدة العسكرية في الساحل السوري، وهو طموح الدولة القيصرية الروسية ومساعيها التاريخية ثم الدولة السوفييتية في الدخول إلى المياه الدافئة، فيما دخلت إيران وحزب الله، دفاعاً عن النظام السوري الذي يمثل معسكراً خلفياً للمقاومة.
مع عسكرة الثورة في سورية، ازدادت التعقيدات السياسية بين السوريين، وازدادت التدخلات الدولية الخليجية والغربية والتركية والصهيونية، وعند هذه النقطة خرجت الأزمة من أيدي السوريين، وأصبحت رهناً للقوى الدولية الفاعلة، واستمر هذا الحال كما هو وصولاً إلى كانون الأول/ ديسمبر 2024 بوصول الجماعات المسلحة إلى العاصمة دمشق.
مارست القوى الدولية ضغوطاً على النظام السوري، أضعفته طوال السنوات الأربع عشرة الماضية، ما أدى إلى انهياره ومعه انهيار الدولة وتدمير الكيان الصهيوني لسلاحها، فقد فرضت الدول الغربية وحلفاؤها عقوبات اقتصادية ودبلوماسية مشددة على النظام السوري، إضافة إلى دعم المعارضة السياسية في المحافل الدولية، ودخل النظام في حالة عزلة إقليمية، حيث تدهورت علاقات سورية مع دول الخليج وتركيا وفرنسا والدول الغربية.
مسار «آستانا» في سورية
بدأ مسار «أستانة» في كانون الثاني/ يناير 2017 كجهد ثلاثي بين إيران وتركيا وروسيا لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية. ركزت «أستانة» على الجانب العسكري والأمني لخفض التصعيد، بالتوازي مع الجهود السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف للحل السياسي، وكانت أبرز القضايا التي بحثها مسار «أستانة»:
- الاتفاق على إنشاء مناطق خفض التصعيد لتخفيف العنف بين النظام والمعارضة.
- تعزيز الهدنة بين الأطراف المتنازعة.
- تسهيل وصول المساعدات للمناطق المحاصرة.
- مناقشة آليات إعادة النازحين واللاجئين.
- دعم إنشاء لجنة دستورية لوضع دستور جديد.
بناءً على اتفاق «أستانة»، تحددت أربع مناطق لخفض التصعيد (إدلب، شمال حمص، الغوطة الشرقية، وجنوب سورية)، وجرى تبادل الأسرى بين الطرفين. كما ساهم مسار «أستانة» في تخفيف حدة القتال في بعض الفترات. ورغم إنشاء منطقة خفض التصعيد، استمرت العمليات العسكرية من قبل النظام وحلفائه ضد المجموعات المتطرفة المدعومة من تركيا، كما استمرت خروقات الجماعات المتطرفة من الناحية الأُخرى.
إلا أن أبرز العقد السياسية لم تحلها جهود «أستانة»، وفي مقدمتها الانتقال السياسي، بما في ذلك صياغة دستور جديد؛ إذ لم يتم تحقيق أي تقدم ملموس في عملية انتقال سياسي شامل. وفي القضية الكردية، لم يتم التوصل إلى توافق حول دور الأكراد ومصير المناطق التي يسيطرون عليها.
الانتخابات الرئاسية 2021
في ظل الأزمة السياسية المعقدة، وبعد فتح مسار «أستانة» التركي - الإيراني - الروسي، ومع التماسك العسكري للنظام بفضل الدعم الإيراني الروسي لعضو في محور المقاومة، قام النظام السوري بخطوة سياسية منفردة سدت الآفاق لإمكانية التوصل إلى تسوية سياسية بينه والمعارضة.
بناءً على هذه الانتخابات فاز الرئيس بشار الأسد بولاية رابعة بنسبة تصويت تجاوزت 95% من الأصوات، وفقاً لما أعلنته السلطات السورية. جاءت الانتخابات كجزء من محاولات النظام لإظهار السيطرة والاستقرار؛ لكنها لم تترافق مع إصلاحات سياسية فعلية تساهم في حل الأزمة، وكانت موضع جدل داخلي ودولي، فلم يشارك فيها السوريون المتواجدون في إدلب، كما لم يشارك فيها المواطنون المتواجدون في المناطق الكردية، ناهيك عن ملايين النازحين من الشعب السوري في لبنان وتركيا والدول الأوروبية.
الظروف الاقتصادية
الحرب التي استمرت في سورية لمدة 14 عاماً، والنهب التركي لمصانع حلب، دمرا البنية التحتية الاقتصادية. أثرت الحرب على الإنتاج الصناعي والزراعي، مما أدى إلى انهيار الاقتصاد المحلي وخلق بيئة لتجنيد الجماعات المسلحة، إضافة إلى ذلك فإن العقوبات الدولية على سورية، خصوصاً قانون» قيصر»، أضعفت الدولة السورية، وهيأ لسقوطها، وهذا الأمر قريب من الحصار الاقتصادي على العراق الذي كان مقدمة لإسقاطها.
انهيار العملة الوطنية السورية أدى إلى زيادة معاناة المواطنين، فقد انهارت قيمة الليرة السورية من 60 لليرة أمام الدولار في أواخر العام 2011 إلى 15000 ليرة أمام الدولار في العام 2024. أدى ارتفاع الأسعار وضعف القوة الشرائية إلى زيادة معدلات الفقر، حيث يعتمد جزء كبير من السكان على المساعدات الإنسانية.
شهد البلد تراجع الاستثمار الأجنبي والمحلي، وهروب رأس المال. كما انخفضت حركة الاستيراد والتصدير بسبب العقوبات المفروضة على معظم القطاعات، مما أدى إلى شلل اقتصادي.
أدى التدهور الاقتصادي إلى زيادة معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بات يعيش حوالى 90% من السكان تحت خط الفقر، كما تفاقمت معدلات البطالة والاعتماد على المساعدات الدولية.
في السنوات الأخيرة أدى استعادة النظام مساحات واسعة من البلاد إلى تحسن طفيف في بعض المناطق. كما وقفت روسيا وإيران اقتصاديا مع سورية، وهذا الأمر لم يعالج الأزمة ولم يوقف مسار التدهور، ولكنه آخّر السقوط الاقتصادي. ورغم الدعم الخارجي، تسببت الأزمة الاقتصادية في تآكل الشرعية السياسية للنظام في أعين العديد من السوريين، وفي صفوف الجيش، إذ تذكر بعض المصادر أن راتب الجندي السوري بات يساوي 10 دولارات، مع انهيار قيمة العملة الوطنية.
الجانب العسكري
الجيش السوري لم يكن مجرد مؤسسة عسكرية ضمن مؤسسات الدولة المختلفة، فقد كان كبار الضباط جزءاً من النُّخبة المُسيطرة التي يعتمد عليها النظام الحاكم، وبالتالي شاع الفساد والبيروقراطية في صفوف الجيش.
كان أداء الجيش في مواجهة الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت عام 2011 مخيباً لآمال قيادة النظام السوري، سواء على مستوى الفاعلية أم على مستوى الولاء والتماسك. وخلافاً للأجهزة الأمنية التي تنتقي عناصرها بعناية بناءً على معيار الولاء، فإن الجيش الذي يتألف من مجمل القوميات والمذاهب في سورية، تأثر بالوضع الاحتجاجي، فشهد انشقاقات واسعة، فيما ظهرت انشقاقات في أوساط كبار الضباط بتمويل خليجي.
مع تخلخل وضع الجيش عمل النظام على استدراك الموقف بالمزيد من القبضة الأمنية داخل صفوف الجيش لإيقاف الانشقاقات، بالتزامن مع الاعتماد الكامل على المجموعات الأمنية، بما في ذلك بعض تشكيلات الجيش النخبوية شديدة الولاء لأسرة الأسد، وفي مقدّمتها الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد والحرس الجمهوري.
لم يتمكّن الجيش السوري من حسم المعارك وحدَه، رغم أنه في بداية الأمر كان في مواجهة الجماعات المسلحة بأسلحة صغيرة أو متوسطة ويفتقرون لسلاح الطيران والدبابات. ولم تبدأ انتصاراته إلا بفعل دعم القوات التي شكلتها إيران وحزب الله ومقاتلون من العراق، والإسناد الجوي الروسي اللاحق الذي دخل على خط المواجهات في العام 2015. وكانت أبرز المعارك التي مثلت ذروة تعافي النظام السوري عسكرياً، مواجهة «داعش»، ومعركة حلب، حيث استعاد الجيش السوري السيطرة على المدينة في 2016 بمساعدة حلفائه.
مرحلة خفض التصعيد والانتهاكات
انقسمت سورية سياسياً وعسكرياً إلى 4 مناطق معادية لبعضها: الأغلبية تحت سيطرة النظام السوري بقيادة الرئيس بشار الأسد، والشمال الغربي تحت سيطرة الجماعات المسلحة التي تهيمن عليها «هيئة تحرير الشام» التكفيرية، والشمال الشرقي تسيطر عليه قوات سورية الديمقراطية «قسد» - وهو تحالف يهيمن عليه المقاتلون الأكراد بدعم أمريكي، والمناطق الشمالية التي تسيطر عليها الحركات المدعومة من تركيا.
ترسخ هذ الوضع بفعل اتفاقية «خفض التصعيد» الذي رعته كل من إيران وتركيا وروسيا في العام 2017، واتفاق «سوتشي» بين تركيا وروسيا. إلا أن النظام السوري استمر في الهجوم على مناطق المسلحين المدعومين من قبل تركيا في إدلب، منها شن عمليات عسكرية ناجحة في خان شيخون ومعرة النعمان وسراقب، خلال عامي 2019 و2020. وكان هذا الأمر يُعد خرقاً للاتفاق، فيما كان التركي من جانبه يُعيد تنظيم وتدريب الجماعات المسلحة لخوض المعركة الفاصلة.
الخروقات العسكرية التي ارتكبها الطرفين لهذه الاتفاقيات عقّدت الإشكالية السياسية، فلم يتم التقدم في ملف السلام طيلة هذه الفترة. كما زاد الموقف التركي العدواني عدوانية، وزادت أنقرة وجودها العسكري في إدلب لدعم الجماعات المسلحة، ومنعت محاولات النظام السوري وحلفائه تحرير هذه المناطق الخاضعة للجماعات المسلحة المتطرفة.
في إطار هذه الخلافات، راهن الأسد على تأثير ثقل اللاجئين السورين في تركيا بالضغط على النظام التركي، الذي يعاني أزمة اقتصادية. وهكذا رفض الأسد لقاء أردوغان رغم محاولات وساطة روسية وسعودية، وذلك بسبب استمرار التواجد العسكري التركي في الشمال السوري ودعمها للجماعات المسلحة. وما كانت تركيا لتوقف دعم لهذه الجماعات، فهي واقعياً الراعي لهم، والتوقف عن دعمهم والانسحاب من سورية يعني تقديم نصر جاهز للنظام السوري، فيما تركيا كانت تريد أن تحتفظ بهذه الأوراق للتفاوض. وهكذا كان هناك تناقض تام بين الطرفين السوري والتركي.
التطورات الأخيرة 2024 وسقوط دمشق
استغلت تركيا تصاعد الصراع لتمكين الجماعات المسلحة من تعزيز وجودها في الشمال السوري، وخلق مناطق آمنة جزئياً تحت نفوذ الجماعات التي تدعمها، فكتلة اجتماعية كبيرة مؤلفة من «المعارضة» النازحة من مختلف مناطق سورية مقيمة على الحدود التركية كانت مهيأة للتجند والتعبئة التركية.
كانت تركيا مستعدة لخوض هذه المعركة بعد سنوات من الإعداد العسكري، ومن التهذيب الشكلي للجماعات المسلحة لتبدو بعيدة عن «القاعدة» و»داعش»، وقد ساعدتها التطورات العالمية والإقليمية في تسريع الهجوم، خصوصاً مع انشغال حزب الله وإيران بواقعهم الداخلي، وكذلك روسيا بحاسباتها الخاصة وتطورات الوضع في أوكرانيا، وهم أبرز القوى التي وقفت مع النظام السوري عسكرياً وأطالوا عمره السياسي من العام 2013 حتى العام 2024.
أتت العملية العسكرية للجماعات المسلحة بدعم تركي تحت اسم «عملية ردع العدوان»، التي شنتها قوات «هيئة تحرير الشام» وأخواتها، كنتيجة طبيعية لاختلاف موازين القوى، الإقليمية وفي الداخل السوري، ليس فقط بين الفاعلين المحليين وأطراف الصراع على الأرض، بل وأيضاً نتيجة اختلاف الظروف والقوة السياسية بين الفاعلين الخارجيين.
كانت الجماعات المسلحة السورية بقيادة ما تسمى «هيئة تحرير الشام» و»الجيش الوطني السوري»، مستعدة للهجوم منذ 6 أشهر، بالتنسيق مع الجانب التركي. ورغم تصنيفها «هيئة تحرير الشام» كـ»منظمة إرهابية»؛ إلا أن «هيئة تحرير الشام» سعت في السنوات الأخيرة لإعادة تأهيل صورتها وإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها في إدلب.
اعتمد الهجوم على تقاطع مصالح بين الجماعات المسلحة وتركيا، فقد تخلت أنقرة عن محاولاتها للتفاوض مع الرئيس السوري بشار الأسد بعد رفضه عروضها السياسية، ووجدت في العملية فرصة لتغيير المعادلة على الأرض عبر الجماعات الموالية لها.
كان الجيش السوري يعاني من فساد واسع النطاق، ونقص في الإمدادات، تسببا في انهيار سريع أمام تقدم المسلحين. الروح المعنوية للقوات الحكومية انهارت في العامين الماضيين، وذلك ما جعلها عاجزة عن مواجهة الهجوم الأخير. وكان يشهد حالة سخط؛ لأن تضحياته أثناء الحرب لم تترجم إلى تحسين الرواتب والظروف المعيشية، وبعد سقوط حلب استدرك الرئيس السوري هذا الأمر ووجّه بزيادة رواتب الجنود بنسبة 50%. يؤكد هذا الأمر ما كشفه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني حول التطورات الأخيرة في المنطقة؛ إذ قال إن «السيد بشار الأسد نفسه عندما التقيت به أنا والسيد لاريجاني كان متفاجئاً، واشتكى من سلوك جيشه، وكان من الواضح أنه لم يكن هناك تحليل مناسب للجيش السوري حتى في الحكومة السورية، وفي رأيي أن الجيش السوري أصبح أسير الحرب النفسية».
تقاطع المصالح الاستعمارية
تظافرت مصالح دولية مشتركة في إسقاط النظام السوري، أوجدت تحالفاً عمل بشكل حثيث على إضعاف النظام السوري وصولاً إلى إسقاطه. دعمت قطر إسقاط النظام السوري لتحقيق مكاسب سياسية في المنطقة، مستندة إلى سياستها في دعم الإسلام السياسي والجماعات المعارضة للحكومات المركزية، وخصوصاً بعد «الربيع العربي». كما أن قطر تريد مشروع أنبوب غاز عبر سورية إلى تركيا وصولاً إلى أوروبا. ساهمت قطر في دعم الجماعات المسلحة السورية مالياً وإعلامياً، خاصة من خلال قناة «الجزيرة».
سعت تركيا إلى إسقاط الأسد لتحقيق نفوذ إقليمي أكبر، وتجنب أي تهديد كردي ينشأ في شمال سورية. كما استفادت من النزاع لتحقيق مكاسب اقتصادية عبر فتح مسارات تجارية في المناطق الحدودية التي سيطرت عليها الجماعات المسلحة ونهب المصانع السورية في حلب. قدمت تركيا دعماً لوجستياً وعسكرياً مباشراً للجماعات المسلحة، خصوصاً «الجيش الحر»، كما استضافت قيادات هذه الجماعات ومؤتمراتها السياسية.
ركزت واشنطن على تقويض ما سمّته «النفوذ الإيراني في سورية»، ومنع استقرار النظام، الذي ترى فيه تهديداً لحلفائها في المنطقة، مع التركيز على دعم الجماعات المسلحة المعارضة للنظام، مثل «قوات سورية الديمقراطية».
أما المصالح «الإسرائيلية» فتركزت في الحد من «النفوذ الإيراني» وحزب الله في سورية، ومنع استمرار سورية في احتضان معسكرات المقاومة الفلسطينية اللبنانية ودعمها.
وفي الإجمال فإن الدول الأربع استفادت بشكل متباين من الأوضاع في سورية لتعزيز مصالحها الجيوسياسية والاقتصادية، سواء بدعم مباشر أو غير مباشر للجماعات المسلحة، مع تركيز كل دولة على أجندتها الإقليمية الخاصة.
وينتظر سورية مستقبل مجهول، أول معالمه سيطرة الجماعات التكفيرية، والاحتلال الصهيوني الجديد، والهيمنة التركية، والنفوذ القطري، والسلام مع الكيان الصهيوني.

.jpg)







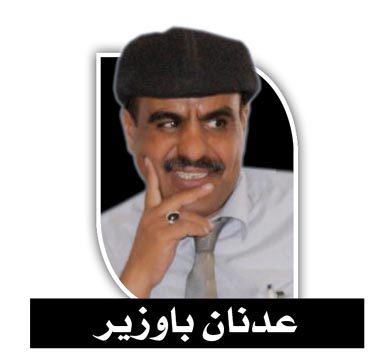





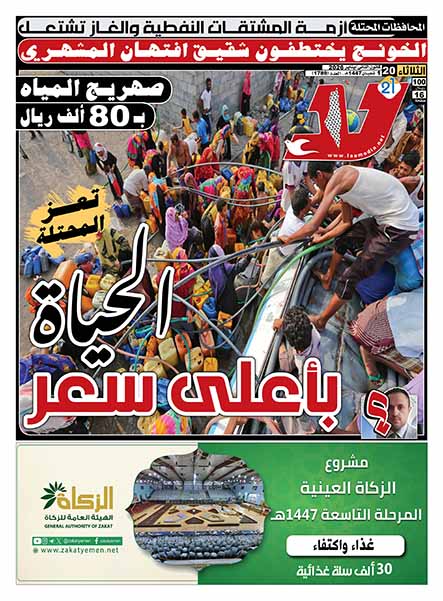


المصدر أنس القاضي
زيارة جميع مقالات: أنس القاضي