«الأخدام» بين عبودية الماضي والحاضر
- محمد القيرعي السبت , 1 أبـريـل , 2023 الساعة 12:29:21 AM
- 0 تعليقات

محمد القيرعي / لا ميديا -
كان فيلسوف ومفكر القرن الثامن عشر، الفرنسي جاك روسو محقا في تشخيصه الدقيق لتطور حياة المجتمعات البشرية البدائية، حينما أشار في إحدى أطروحاته العلمية إلى أن المجتمعات البدائية كانت تعيش حياة بريئة وسعيدة نوعا ما، لاتسامها بقدر معقول من العدل والمساواة التي كانت تؤمنها قوانين البداوة ذاتها، ما يعني أن الحضارة لم تشكل طوق نجاة فعليا للبشرية من منظور روسو، بل على العكس من ذلك تماماً.. فالحضارة هي ما نحتاج إلى الخلاص منها أصلا.
وهي الرؤية التي تم تفنيدها في مرحلة ما وبشكل سلبي في كتاب «فجر كل شيء: تاريخٌ جديد للإنسانية - The Dawn of Everything: A New History of Humanity»، لمؤلفيه عالِم الآثار الفرنسي، ديفيد وينجرو، وعالِم الأنثروبولوجيا الفرنسي أيضا، ديفيد جرايبر.
وبالنسبة لي كـ«خادم» أعتقد تماما بصحة وجهة نظر جاك روسو تلك، وخصوصا بالنسبة لنا معشر «أخدام» ومهمشي اليمن، إذا ما قارنا وضع العبودية القائم اليوم في حاضرنا الحضاري المزعوم بالوضع الذي كانت عليه في العقود والقرون الماضية.
فالعبودية في الماضي كانت موجودة وسائدة ومتوارثة بقوة ولكن بشكل بسيط ومقنن ودون رتوش حتى، كما هو حاصل اليوم.
ذلك أن المجتمعات السيادية القبلية التي سادت بطابعها الهرمي الاستقوائي، وإن كانت ولاتزال حتى اللحظة مولعة بالحروب وحب التفوق والفتن، فإنها مولعة في الوقت ذاته بثقافة الإخاء والتسامح والسلام، وجميعها كانت تحتكم أيضاً ـ أي العشائرـ للمبدأ أو العرف الاجتماعي القبلي الذي يجيز مثلا وفي سياق ثقافة الاستعباد المشاعي لـ«الأخدام» إمكانية تأمين الطعام المجاني لعائلاتهم من خيرات أراضي القبائل مقابل المنع القسري لـ«الأخدام» من تملك الأراضي الزراعية والبور وفق شروط الاستبداد الاجتماعي ذاتها.
مثلما كانت تنص تلك القوانين الاجتماعية أيضاً (الأعراف) على جواز منح المأوى المجاني لـ«الأخدام» وعوائلهم في أراضي القبائل والسماح لهم في العيش بها جيلا بعد جيل دون السماح لهم بتملكها، بالإضافة أيضاً إلى تحريم تلك القوانين البدائية القتل المجاني للخادم أو التنكيل به، وحتى في حالة حدث أن أقدم أحد «الأخدام» على قتل قبيلي سواء بصورة متعمدة أو عن طريق الخطأ، فإن الأعراف القبلية كانت تحرم في هذه الحالة الاقتصاص الشرعي من الخادم.. وإنما تكتفي بالتنكيل به وعائلته وتشريدهم من المنطقة، كون الاقتصاص في هذه الحالة يشكل وفق مذهب الاستبداد الاجتماعي السائد انتقاصا اعتباريا مرفوضا من مقام وشخصية القبيلي القتيل، لأن الاقتصاص يساوي في هذه الحالة بينهما من منظور النفس بالنفس، وربما عملا بما جاء في القرآن الكريم، في الآية 178 من سورة البقرة: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ» صدق الله العظيم.
وهو العرف بالذات الذي أغراني بقوة وبات محببا إلى نفسي، بالنظر إلى الحصانة الاجتماعية التي يوفرها لأمثالي إلى الحد الذي جعلني أتسأءل معه ماذا لو كان قدر لي أن أولد في تلك الأزمان الغابرة.. لكنت استفدت منه بالتأكيد إلى أقصى درجة ممكنة كونه سيتيح لي على الأقل التعشي بقبيلي كلما سنحت لي الفرصة دون الخوف من أي رود فعل ثأرية أو اقتصاصية كوني خادما.. ولا يجوز البتة مساواتي بقبيلي.
وهو الواقع الذي لا يمكن بأي حال مقارنته بمظاهر العبودية السائدة والمكرسة اليوم ضد فئاتنا المقصية والمهمشة وفي حاضرنا الجمهوري الأكثر عصرية من منظور البعض، بالنظر ليس فحسب إلى المستويات الساحقة من عوامل النبذ والتهميش وانعدام العدالة والمساواة الإنسانية السائدة في كل مفاصل الحياة اليومية، وإنما بالنظر أيضا، وهذا هو الأهم، إلى كون ظاهرة العبودية ذاتها باتت اليوم الأسوأ والأشد خطورة وتعقيدا من سابقتها، بالنظر إلى طبيعتها المقنعة والمخفية خلف جملة من التشريعات والقوانين الدستورية الملطفة بنمطها العصري المزعوم والتي تصر إصرارا عجيبا على إنكار واقع العبودية في سياق اللوحة الزائفة لوحدة الأمة الواحدة والمتساوية المضمنة في تشريعاتنا الوطنية المعطلة من الناحية الأخلاقية والعملية، الأمر الذي يجعل من ظاهرة العبودية ذاتها الأكثر خطورة وإجحافا كظاهرة غير معترف بوجودها أصلا على صعيد أنظمة البلاد وتشريعاتها الرسمية.
فالادعاء بأن «الثورة والجمهورية في بلادنا» قد تخطتا ميراث العبودية هو ادعاء لا أساس له من الصحة، كون الإلغاء الفعلي الذي شاب العبودية خلال العقود الستة والنصف الفائتة من عمر الثورة.. لم يطل سوى نمطها العلني فقط، مانحين إياها في الوقت ذاته شكلا مخفيا ومبطنا أسفر بطبيعة الحال عن خلق أسوأ أشكال الاستغلال اليومي لطبقات «الأخدام» وعلى أوسع نطاق ممكن وبمستوياته الرسمية والمجتمعية.
فالدولة مثلا وبصفتها الرسمية تمارس العبودية بأحط السبل وضاعة وابتذالا ضد أوسع القطاعات المهنية للمهمشين، من خلال استخدامها لعمال وعاملات النظافة والصرف الصحى في شروط عمل بغيضة وعنصرية لا تقل انتهازية عن أنماط العمل الإجباري (السخرة)، فلا حقوق عمل ولا درجات وظيفية ولا ضمانات صحية ولا تأمين صحي ومعيشي ولا تثبيت وظيفي.
كما أن أحد الجوانب الأكثر شهرة وغير المشرفة أصلا في تاريخ العبودية الحديث في بلادنا يكمن في الدور السلبي الذي لعبه ويلعبه على الدوام الساسة البيض، وبالأخص دعاة الحداثة المدنية من قوميي واشتراكيي وتقدميي الزيف في إذكاء جذوة الاستبداد العرقي ليس فحسب من خلال إسهامهم الفاعل في تكريس واقع العبودية ذاته عبر تواطئهم المشبوه والعلني في إنكاره ومحاولة طمس آثاره ومعالمه، وإنما أيضا من خلال استغلالهم الانتهازي لقضايا «الأخدام» ولتجمعاتهم البشرية في رفد أجندتهم وتطلعاتهم الانتخابية والحركية قبلا، والاحترابية حاليا، دون أن يكون هناك أي تضمين أو إشارة ولو بسيطة في أدبياتهم ومعتقداتهم السياسية والتبشيرية لقضايا «الأخدام» ولهمومهم التاريخية المعاشة والمتوارثة جيلا بعد جيل.
خلاصة القول، أن القائلين بأن الحضارة هي العلاج الناجع لميولنا البشرية العنيفة.. يمكنهم النظر فقط وبموضوعية فاحصة إلى ما أنجزناه خلال العقود الستة والنصف الفائتة من عمر الثورة والتي لم نتمكن خلالها وحتى اللحظة، ورغم كثرة حروبنا الداخلية وضراوتها، من الاتفاق حتى على شكل الدولة وأسسها، فما بالكم بالهموم والتطلعات الإنسانية الأكثر مدعاة للرثاء في بلادنا.

.jpg)








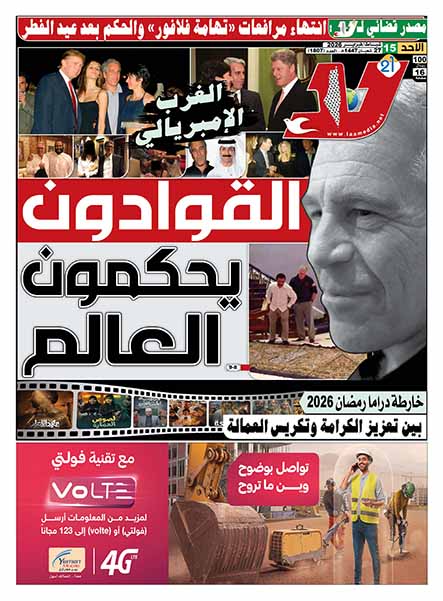
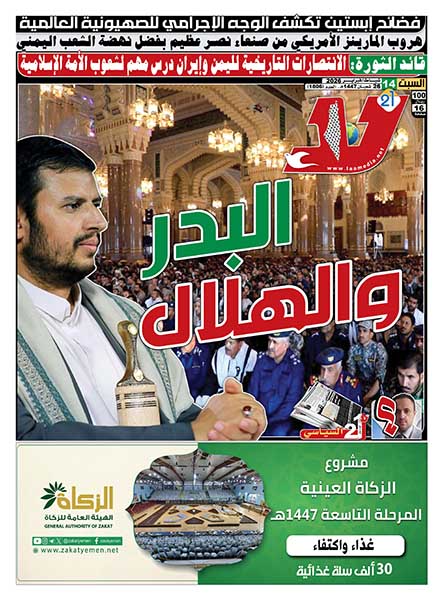






المصدر محمد القيرعي
زيارة جميع مقالات: محمد القيرعي