
مقالات محمد القيرعي
الله والشيطان وآل سلول
تعز تبتهج بالبحر
لن أعيش في جمهورية الخطيئة!
مهرجو السعودية والخليج.. عمالة وانحطاط حتى النهاية
ابنا سلمان وزايد والأفندم هادي والمفدى نتنياهو .. أكبر الخاسرين برحيل ترامب من عرش اليانكي
«بني محمد» تفوق أخلاقي في زمن جاهلي
الأمن «الماركييزي» في الشمايتين .. الذراع القمعية واللصوصية لإخوان الرذيلة
جائحة ابن سلمان تضرب ترامب وإدارته المترنحة
طاغية الشمايتين عبدالعزيز ردمان..مهرج إخونجي
الأزمة اليمنية..أسبابها وجذورها وبواعثها المحلية والإقليمية
«ترويكا» ولي عهد مملكة الرذيلة محمد بن سلمان
بـ«مارش وطني ديني» نفير إتاوات خونجي
عصابات الخطف والجريمة في الشمايتين.. «الجستابو» الأمني لـ«الخونج»
ومضة ضوء لمولود أخير
حزب سياسي للمهمشين..إعدام ممنهج للقضية
هل يطمح قادة المهمشين لاستنساخ تجربة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي؟!
عملية جيزان الأخيرة قوضت فتوة ابن سلمان
نفاق المثل الإنسانية السهل.. مونتسكيو
ازدواجية «اليانكي»!
تعز .. فساد ثوري أم اختراق رجعي لمفاصل العملية الثورية؟!
انفصاليو الجنوب وسيناريوهات العمالة
الرحيل المشترك لدونالد رامسفـيلد ومشاريعه الإخضاعية
عمدة وثائر وخادم!
خفايا الهستيريا الصهيوأمريكية أوروبية المسعورة ضد إيران
لسنا بحاجة إلى حزب وإنما إلى إجابة:لماذا تستعبدوننا؟!
«طالبان» وإمارتها الإسلامية.. إعـادة تـدويـر أمريكي
ما بين إعدام قتلة الأغبري ومجزرة أسرة الحرق في تعز.. الفرق بين الدولة والعصابات
هل فعلاً يملك «الأفندم هادي» سلطة حتى على بلاطه الفندقي؟!
3١ عاما من ورم الإخوانجية الخبيث في بلادنا
المرتزقة والبرع السبتمبري .. مات الشعب.. عاش قاتلوه
متى سـيدرك هادي ومرتزقته أن أسيادهم في التحالف ليسوا في صفهم؟!
معروضة على طاولة قائد الثورة..هل ينبغي للثورة التنكر لبعض شهدائها من ذوي البشرة الداكنة؟!
مجلس حقوق الإنسان والبرع على طبول العدوان
هل تريدون إدراك ماهية العمالة؟ .. انظروا الأبهة التي يعيشها مرتزقة العدوان!!
في تدشين موسم الرياض السنوي.. نزالا مصارعة حرة وصواريخ باليستية!
«ربيع النصر»..تحرير للأرض وللحقيقة معا
ما بين اغتيال المحمدي واستهداف قرداحي.. النظام السعودي وهوس مكافحة «الحوثية»!
ما المغزى من تزامن زيارة المبعوثين الأممي والأمريكـي لكل من تعز وعدن؟!
لماذا لا يملك «الحوثيون» استراتيجيــة فعالة ضد حملات الدعاية والتشهير؟!
الساحل الغربي.. المعادلة والاستراتيجيات العدوانية الجديدة
طوفان المرتزقة في عالمنا العربي.. مشيخات الخليج مرت من هنا
الإسلام المفصل على مقاس الرياض ومرتزقتها!
أنجيلا ميركل تستعد لطي حقبتها ..ماذا لو كان الأفندم هادي امرأة؟!
تعز والجنوب.. صحوة شعبية وسياسية متأخرة لمخاطر العدوان وجرائمه
ابن سلمان وأوهام إحياء المبادرة الخليجية!!
ضحالة المضمون الأخلاقي لعدوان التحالف
مقاربة نقدية لبعض الشوائب العالقة في مسار العملية الثورية.. روح الله أم روح الثورة الوطنية؟! أيهما المساوى؟!
ما هو الجزء الذي لم يفهمه الصهاينة والأمريكان حول .. قدرات محور المقاومة؟!
في الذكرى الـ19 لاغتيال جار الله عمر.. ما الذي تبقى من مشروعه الوطني؟!
السعودية والإمارات.. سباق محموم صوب الباليستي والمريخ!!
تحالف العدوان من الرغبة في الإخضاع إلى الثأر المفتوح من الشعب اليمني
ما هي الحسابات السياسية والجيواستراتيجية لتحالف العدوان من وراء تصعيده في شبوة؟!
طارق عفاش.. عمالة وارتزاق حتى الثمالة
دويلة عيال زايد غير آمنة!
العدوان ومرتزقته وعقدة إيران وحزب الله
هل في مقدور البربرية الصهيوأمريكية الخليجية إخضاع الشعب اليمني؟!
جامعة الدول العربية تصحو من سباتها الشتوي بسحنة عبرية
المحور المقاوم ومخاطره المتنامية على «الشقيقة أورشليم»!
هرتسوغ في أبوظبي ومهرجو الخارجية العرب في الكويت.. ما الرسائل والدلالات؟!
أهداف ومآلات مقتل زعيم «الدواعش» في سورية
على ضوء احتفاء «إخونج الرذيلة» بذكرى ثورة فبراير المغتصبة!!
بهجة نفتالي بينيت في البحرين تمحو غصته الأفريقية
أبعاد الرسائل المتوالية من نصر الله والمحور المقاوم للصهاينة وللمنظومة التطبيعية
بوتين.. السقوط المتهور فـي الفخ الإمبريالي!
السعودية حروب وإعدامات بالجملة باسم الملَّة!
سعي الطابور الخليجي الخامس لـ«يمننة» الحرب.. عدوان إضافي
في الذكرى السابعة للعدوان الفاشي على بلادنا .. «حزم عاصفتهم» البربرية تحول إلى قزم
سيناريوهات الرياض الأخيرة .. انتهاء صلاحية مرتزقة لصالح مرتزقة كثر
الازدواجية الدولية حيال الإنسانية المستوفية للشروط الأمريكية من عدمها
تحركات اليانكي الأخيرة فـي مياهنا الإقليمية.. ما الرسائل المراد إيصالها؟!
ما بين تشييع شيرين أبو عاقلة ووفاة بعبع الإمارات خليفة بن زايد
التدنيس في الأقصى والفصح في المنامة والحي اليهودي في أبوظبي
هل يدرك قادة تحالف العدوان الفارق بين شن الحرب وإنهائها؟!
بوتين الساعي لحماية روسيا بات فاقدا على ما يبدو للبوصلة الأمنية!
كهرباء الشمايتين التجارية..انعكاس لتحالف الأوليغارشية المتوحش
فيما يخص عدوانه البربري على بلادنا.. ما الذي لم يكذب بشأنه النظام السعودي بعد؟!
الهدنة الهشة.. هل هي أمل المرتزقة وأسيادهم في التحالف للعَّب على حبل الفُرقة والتناقضات؟!
صراع المرتزقة فـي شبوة انعكاس واضح لعمق المأزق الوطني والأخلاقي
ظاهرة الشواذ والمثليين في حاضرة الحجرية آخر صيحات المقاومة الإخوانجية
الوداعة الصهيو-أنجلوسكسونية فـي المهرة وسقطرى!
عروبة العمالقة وانحطاط المتصهينين.. تضاد القيم التحررية
الثورة في ثامنتها الظافرة رسائل ردع وسلام
التربة.. مؤشرات صراع المرتزقة
هل الهدوء يسود الجبهات حقاً مع كل هدنة ممددة ؟!
قمع القيرعي أو تطويعه من قبل المرتزقة..أيهما الأنجع يا ترى؟!
الاشتراكي «اليمني» فـي ذكراه الـ44..أين يكمن الإخفاق الثوري ؟!
هل يمكن للثورة الانتصار لإنسانيتها في ما يخص الأسير/ المأساة.. فؤاد قائد الحمادي؟
ما المغزى من ترويج شائعة وفاة عاهل مملكة الرذيلة؟!
زيارة البركاني ومعوضة لمحافظة تعز السليبة..المغزى والدلالات
هل في مقدوري كـ«خادم» الشعور بالحنين مجددا للعيش وسط هذا المجتمع البربري؟!
مشروع مياه الدريح..آخر ضحايا اللوثة الخونجية
الكريسمس لم يعد محبذا عندي منذ رحيل الشهيد جار الله عمر
جريمة التربة والبصمة الإخوانجية
«الأخـدام» والعبودية المزدوجة .. شهداؤهم من بني هاشم وشهداؤنا من «بني خادم»
اسألوا الدكاك من منا غادر الآخر..أنا أم الحزب الاشتراكي؟!
الشمايتين ومناخ الجريمة الخونجية الصرفة
تركيا..التي أكثرَ «الإخوانُ» فيها الفساد
النفوس الجميلة..مفارقة فلسفية تعكس الفارق بين ثـوار الفضيلة وسماسرة الثورات
الفرح الأبوي الممزوج بألم الوحشة
نفاق وطني عنصري خونجي محمـوم
من المستفيد من اغتيال الخيواني؟!
«الأخدام» بين عبودية الماضي والحاضر
استلاب إخوانجي جديد لروح مهمش ثائر في الشمايتين
في تعز.. «الإصلاحيون» يتخلصون من مواليهم
من جبهة الأعبوس الصامدة إلى حيفان الأبية.. معايدة رفاقية مصبوغة بعبق الثورة
الخروقات المستمرة في صعدة والحديدة ..انعكاس فعلي لإخفاق المعتدين
زمن المرتزقة الذهبي!
ذكرى الوحدة اليتيمة والمشيعة بالنكران
هل يمكن لسلام فعلي أن يتحقق مع من أباد شعبنا؟!
كل تحولاتنا الثورية منذ الأزل ممسوسة بالردة
متى سيُحاسب المرتزقة على قتلهم أسرانا؟!
في الذكرى الـ49 لحركة يونيو التصحيحية.. أين يقف الحمدي يا ترى من ناصريي فنادق الرياض؟!
الديلمي.. لم يتطرق إلى مواطنينا في «ديار الإسلام»!
جرائم القتل العرقي في تعز السليبة.. انعكاس للهمجية الإخوانجية
الــ17 من يوليو400 شهر من دكتاتورية عفاش المضنية
لا بواكي لنا نحن معشر «أخدام اليمن» 22 عاما على ميلاد حركة الأحرار السود
العليمي من مرتزق طوعي إلى «رئيس» هائم على وجهه
التربة..لم تعد «أورشليم» الحجرية!!
هل الاشتراكي بالفعل «بعبع» المشروع الانفصالي في الجنوب؟!
القتل فقط..هو كل ما يجيده خونج الرذيلة
ثورة أيلول 2014 مع قرب ذكراها التاسعة.. ماذا أنجزت؟ وبماذا أخفقت؟
مشاهد صادمة من مهزلة العدالة الخونجية المروعة في الشمايتين
في الشمايتين غول الإرهاب الإخوانجي يلتهم الجميع
محمد بن سلمان.. التطبيع بوصلة لضمان مستقبل حكمه الانقلابي
أين موقعنا من «الأيلولين»؟!
يعيد للأمة اعتبارها المفقود
هلع صهيوني غير مسبوق يا مسوخ العرب العاربة
من حق «أتباع يهوة» الارتكان إلى حثالتنا في كراسي الرذيلة!
غزة وحيدة في كل منعطفاتها يا أوباش العرب
الإجلال لعروبة المندوب البرازيلي في مجلس الأمن واللعنة على أنصاف العرب
تعزالمنكوبة برائحة الحرب و«نبيلها» الأضحوكة
معتقل للمرة الألف بسبب «حوثيتي» المتنكر لها من «أثوار» أيلول 2014
أطفال غزة واليمن في مرمى صهينة الخليج المتمددة حتى النخاع
الشيباني من «مقهوي مغمور» في الجهاز المركزي إلى طاغية في الشمايتين
من جزار بقر إلى جزار بشر.. غول يلتهم الشمايتين
لماذا يخفق الأمريكان دائما في التعلم من أخطائهم؟!
العدوان المتولد من رحم العدوان
دون حياء..الخونج يحتفون بذكرى فبراير الموؤودة
أربعينية والدتي الراحلة بلا وداع أخير
«إسرائيل» تجرد الرئيس لولا دا سيلفا من غفرانها غير الصالح للاستهلاك السياسي
سجون الشيباني الخاصة في الشمايتين معيار عدالة الخونج المروعة
غرق «روبيمار»..والعنجهية الأنجلوأمريكية
إلى متى يستمر خونج الشمايتين بسحل آدميتنا نحن المهمشين؟!
أدوات العدو الخفية في الداخل الثوري
في الشمايتين..«الإرهاب» والغطرسة الخونجية يتفاقمان
الوعد الصادق الإيراني
المسّاح يختم لحظاته المنسية بانكسار الروح
هل حقق خونج اليمن نبوءة الرفيق كارل ماركس حول الدين؟!
الزنداني مُنظِّر الإرهاب الأول يرحل عن عالمنا
سماحة القائد الأعلى للثورة هل جربت العيش دونما وطن يحويك؟!
الخونج ليس كمثلهم شيء لا اليهود ولا المغول ولا النازيون
رغم كل جرائمهم..هناك من لا يزال يؤمن بوداعة الخونج!!
مات الرئيس ولم تمت الجمهورية
الهمجية لا غير..هي من تحكم الشمايتين
كل القبائل أعداء طبقيون وإن كانوا يقتلوننا بطرق مختلفة
رعب صهيوني من الرد اليمني
«إسرائيل» تتجرع مرارة المواجهة مع «الحوثيين» ومرتزقة اليمن يتفانون في خدمتها
رحل هنية لتعيش فلسطين رمزا لكرامتنا القومية
الجوانب الخفية في أنماط الاستعباد المشاعي لـ«أخدام» اليمن
الخونج و«المتحوثون» يسلبون ذراعي وجزءا من روحي
في الشمايتين.. المتسولة شعتلة تبتهج بالعليمي
أين يكمن الصواب الديني يا ترى.. لدى المطاوعة أم «الحوثيين»؟!
في عاشرة أيلول الثورية هل أعاد «الحوثيون» حقا صناعة تاريخنا الوطني
لست جزعا.. فسيد الشهداء يسكن في جوانحنا
غرام ماركسيتي المشهود لأصحاب اللحى الثائرة
لاهوتية المساوى ورجعية الفتاوى
حمائمية بايدن وصقورية ترامب عليهم لعنتي
هجين المبادئ لدى الزميل فكري قاسم
أغنية الموالاة وزوامل القحوم في مواجهة النازيين والنازيين الجدد
أي إله يمجد «دواعش» سورية بإرهابهم الهمجي؟!
مستقبل سورية الحالك بين الإرهاب الديني والتناحر الطائفي والانبطاح
عبدالله أمير..رحيل في غير أوانه
«كل أسود مقدس.. ولا نامت أعين الجبناء» شرعية المسوخ
همجية الخونج المستفحلة تطال كل مظاهر الحياة الإنسانية
مشروع إحياء الجبهة الوطنية الديمقراطية هل سينطلق من مبدأ الإقرار بعثرات الماضي؟!
«الكوكلوكس كلان» على الطريقة الخونجية
سيد الشهداء ثائر حتى النهاية
هل يتعين علينا كـ«مهمشين» إبداء الولاء لوطن كل ما فيه يرمز للدنس؟!
تهليل أشباه الرجال لرحيل نصر الله
الرحيل المبكي لمحمد الشراع
كيس طحين.. وقتيلين «مهمشين»
عليمي الإمارات.. المذلول حتى النخاع
ما بين الإسلام السياسي والإسلام الثوري.. أين يكمن الصواب يا ترى؟!
المصادفة والدين الجديد
ترامب وغبطة المرتزقة بعودته لعرش «اليانكي»
أمريكا وشغف العدوان المتصهين ضد بلادنا
الجبولي ومليشياته الإخوانجية المبندقة تسحل آدمية أبناء الشمايتين
الرهان على المطاوعة.. جريمة في حق الرب والتاريخ
في رجاعية الشمايتين..القصة المتجددة للاستبداد الاجتماعي تطل بآخر فصولها المخجلة
العنصرية..مقارنة منطقية ما بين نعمة الإلحاد الحضاري ولوثة التصوفات اللاهوتية
خونج اليمن.. في خانة انتهاء الصلاحية لدى أسيادهم في «إمبراطورية اليانكي»
العربية .. طباخة الحقيقة بأيد قذرة
ثورة أيلول 2014..بين شد وجذب الحداثة والانغلاق
في تعز.. محافظان وهويتان أيضاً!
التعميد الروحي لأيلول بدماء الصماد والرهوي
على طاولة فخامة الرئيس مهدي المشاط.. هل تطال عدوى الإجحاف والنسيان الرفيق ناشر العبسي أيضاً؟!
في عامها الحادي عشر.. هل نجحت «21 أيلول» في الحد من دكتاتورية البلداء؟!
موسم البرع السبتمبري
المناخ التكفـيري الناشــئ في محيط «المهمشين»..إلى أين؟!
حدثان في طفولتي
الدكاك يسلخ روحه الوطنية المنكسرة هذه المرة في «بناء على ما تهدم»
ذكرى الجلاء..والثورة المغدورة
صحيفة «لا» الشرارة التي لا تزال متقدة في ربيعهـــا العاشـــر
مع انقضاء الذكرى الثامنة والخمسين للاستقلال .. هل أفلح الحزب الاشتراكي في تأطير تجربته الإنسانية حيال «أخدام» و«مهمشي» جنوب ما قبل الوحدة؟!
هل يفلح «مثليو الجنس» الخليجـي في تفكيك شعوبنا وأوطاننا؟!
«إسرائيل» تتغوط في فنائنا والمطاوعة يتبولون على أسرّة نومنا
مع انقضاء الذكرى الرابعة والعشرين لاستشهاده ..الرفيق جار الله عمر.. الأيقونة الكفاحية المفقودة للأبد
حل «الانتقالي» لا يكفي.. ما لم يتم اجتثاث الورم الإخوانجي
حلم الانصهار المستحيل بين كيانات المرتزقة

أحدث التعليقات
أبورعد الاعنابي على «محفوظ عجب».. وجوه تتكرر!
عبدالغني الولي على الغذاء والدواء أساسيات تتعرض للإهمال والتدمير
فاروق ردمان على عن الجدل الدائر حول تغيير مقررات التعليم!
انور حسين احمد الخزان على فضول تعزي
الخطاط الحمران بوح اليراع على قضية شرف ثوري لا شرف حجر
جبرشداد على الحسين منا ونحن منه
jbr.sh على كل زمان عاشوراء وكل أرض كربلاء
إبراهيم على هروب «إسرائيل» من الفشل إلى الجحيم
يحيى يحيى محمد الحملي على فجوة خطيرة في ثقافة الشباب العربي
جلال سعيد صدام الجهلاني على تاريخ التدخلات العدوانية السعودية في اليمن وامتداداتها (1 - 4)
القتل فقط..هو كل ما يجيده خونج الرذيلة
- محمد القيرعي الأحد , 20 أغـسـطـس , 2023 الساعة 8:11:55 PM
- 0 تعليقات

محمد القيرعي / لا ميديا -
في الحادي والعشرين من تموز/ يوليو الفائت اغتالوا السيد مؤيد حميدي، منسق برنامج الأغذية العالمي، في تعز، ثم أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، إذ باشروا -وبغرض إدانة جريمتهم المروعة تلك علنا والاستفادة من تداعياتها إلى أقصى مدى ممكن- بتشكيل لجان تحقيق متعددة لكشف ملابسات الجريمة!
ومن ناحية أخرى شنوا حملات قمع وتنكيل أمني مروعة وواسعة النطاق بغية تصفية حساباتهم مع العديد من خصومهم السياسيين والاجتماعيين في المنطقة، في استغلال انتهازي مروع لجريمتهم ذاتها، وذلك قبل أن يقدموا يوم الثلاثاء الفائت (15 آب/ أغسطس الجاري) على اغتيال كبير محققي البحث الجنائي المكلف بملف القضية ذاتها في محافظة تعز السليبة، والمعين بمباركتهم أصلا لكشف تفاصيل جريمتهم السابقة بحق حميدي، والتي يبدو أن المحقق القتيل (العقيد عدنان المُحيّا، وهو بالمناسبة من ضباط الأمن السياسي رفيعي المستوى) كان على ما يبدو على وشك الوصول أو الاطلاع على بعض خفاياها المحظورة، ليردى على ضوئها قتيلا هو الآخر، لضمان عدم انكشاف الحقائق.
ومن يدري ما الذي تخبئه جماعة حزب الإصلاح المهيمنة في هذا الشأن يا ترى لاستغلال جريمتهم الأخيرة تلك بحق ضابط البحث على نحو أفضل، وبالوتيرة ذاتها التي استفادوا بها من الأولى، وبما يحقق لهم أفضل النتائج الممكنة لفرض المزيد من تسلطهم وتعطشهم اللامتناهي للسلطة والدماء!!
فهم (أي مطاوعة الرذيلة) لم يجيدوا في حياتهم شيئاً البتة، وعلى امتداد تاريخهم الحركي والوجودي المشؤوم في بلادنا، سوى القتل، والقتل فقط؛ القتل لخصومهم، والقتل لحلفائهم ومواليهم، وللإنسانية من حولهم، باستثناء أنفسهم فقط.
فالقتل هو الزاد النظري والأيديولوجي للمطاوعة للصمود في وجه أعاصير الرفض الشعبي والاجتماعي المتنامي لوجودهم، فبدونه ما كان يمكن لهم أن يحكموا أو يهيمنوا، كما أنه (أي القتل) يعد بالنسبة لهم أبرز مصادر الإلهام والتأمل الفقهي لإدراك مدى القوة التي تعود بالنفع على من يتفرد مثلهم بقمع الحياة العامة، وتقرير حياة البشرية من حولهم، وموتها أيضا؛ فهو الأبجدية التي ابتدؤوا بها تاريخهم الجهنمي، مثلما سيكون أيضاً خاتمة وجودهم في قادم الأيام، سواء طال أمدهم أم قَصُر.
فالقتل بات واقعاً ومستفحلاً فينا منذ ابتلتنا المشيئة بتلك الوجوه الملتحية التي أطلت على قيمنا ومجتمعنا على شاكلة يهود الدونمة في الأستانة*، الذين أشهروا إسلامهم فيما احتفظوا بيهوديتهم سراً، لينخرطوا بعدها كالسرطان وباسم إيمانهم المزيف في كل مفاصل الدولة العثمانية، مقوضين إياها من الداخل، بصورة كان لها أثرها الرئيسي والعميق في تسريع انهيارها الكلي عقب انتكاستها الكارثية في الحرب العالمية الأولى.
فالقتل عمل شاق وخبيث وقاسٍ وجبان، ولهذا السبب، ربما، ارتبط وبشكل يكاد يكون حصرياً في تاريخنا الاجتماعي والوطني بتاريخ وتقاليد المطاوعة، لا كمهنة حركية فحسب، وإنما كأداة للسياسة والتبشير، إلى حد أنهم استمرؤوه فينا، هم وأسيادهم في التحالف، الذين جلبتهم فتاوى المطاوعة في المقام الأول، بحيث لم يفرقوا في هذا المنحى ما بين صبي في حافلة مدرسية أو رضيع ألقموه قذيفة مفرقعة عوضاً عن ثدي أمه، أو بائع أعلاف مسن في سوق ماشية، أو متسولة مهمشة تجرجر أطفالها الجوعى سعياً وراء ما تيسر في سوق شعبية مزدحمة، أو مريض ينازع الموت في سرير مشفى، أو عرائس يخطين نحو أقفاص السعادة التي تحولت بفعل العدوان إلى توابيت تحوي جثامينهن الممزقة والمغتالة باسم الدفاع عن "الشرعية".
وإلى أن تتوقف أبجدية القتل والدم والدمار والمآسي والدموع النازفة والمنهمرة دون توقف من بدن الأمة بأسرها، باسم الدفاع عن الفضائل الوطنية والدينية، ما علينا سوى انتظار الخلاص الذي قد يأتي إما على شكل قذيفة خونجية وإما لفتة تعاطف سماوية تخلص بقايا هذا الشعب من طغيان قتلته.
* الأستانة كانت في عهد الدولة العثمانية مقر إقامة سلاطين الدولة ومركز حكمهم الديني والسياسي.

.jpg)







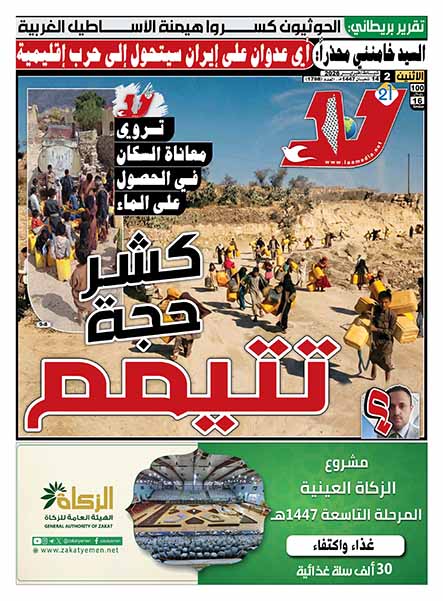






المصدر محمد القيرعي
زيارة جميع مقالات: محمد القيرعي