في تمجيد القرآن.. النص الكلي
- محمد ناجي أحمد الخميس , 30 نـوفـمـبـر , 2017 الساعة 4:14:56 PM
- 0 تعليقات

يرى الجرجاني أن الإعجاز القرآني مرتبط بالنظم، كنسيج تتأمل في مكوناته الصوتية والدلالية والنحوية والبلاغية.
وهو ما نراه إزاحة مستمرة للدلالة المتحركة في بيانها، وبديعها، مع دلالة الكون المختزلة فيه.
ويرى ابن عربي أن القرآن هو تماهٍٍ لكل أشكال الديانات، فكلها رسوم وطقوس لحقيقة إلهية ووجودية واحدة.
ويرى أدونيس في كتابه (النص القرآني وآفاق الكتابة) الصادر عام 1993 عن دار الآداب -بيروت، أن القرآن هو الكتاب كما سماه الوحي، فهو (يجمع في بنيته أشكال الكتابة جميعاً. كأنه أعاد الكتابة إلى فطرتها، قبل الكتابة وفي ما وراء الأنواع الكتابية. وكأنه وضع هذه الأنواع بين قوسين أو ألغاها، ليخلق نوعاً آخر)، لهذا فالقرآن استعادة للكتب السماوية المنزلة، عودة إلى أصولها قبل التحريف، والتراكم التاريخي الذي أضافه إليها حذفا وإزاحة مفسروها، وكهنة النصوص المستأثرون بحركة دلالاتها.
القرآن جاء منفتحاً على النصوص، وعلى الأزمنة والأمكنة والأعراق. إنه إذابة لكل أشكال التعبير والبلاغ، والشعوب والألوان؛ أي أنه إنشاء وخلق للإنسان الجديد، ونشأ عنه قارئ جديد، وذوق جديد. وهو بحسب أدونيس طريقة في التعبير، تلغي الفروقات التقليدية بين الفلسفة والأدب، وبين العلم والسياسة، وبين الأخلاق والجمال. إنه طريقة تخترق المقاربات المعرفية التقليدية من حيث المنهج، الموجد للإنسان الكامل، الذي هو على صورة الله. القلب المتجاوز للألوان والأشكال والصور (إن الله لا ينظر إلى صوركم، ولكن إلى القلوب التي في الصدور) إلى البنية العميقة المولِّدة للإنسان.
هو بحسب أدونيس (نموذج من الكتابة تتداخل فيه أنواع المعرفة، فلسفة وأخلاقاً، سياسة وتشريعات، اجتماعاً واقتصاداً. وتتداخل فيه مختلف أنواع الكتابة الأدبية، سرداً وحواراً، اقتصاداً وتاريخاً، حكمةً وأدباً. إنه في آن فلسفي أدبي اجتماعي تاريخي، يجمع بين الطبيعة وما وراءها). لهذا يراه أدونيس مفتاحاً لفهم العالم الإسلامي.
حين نجد ابن عربي يتنقل في تأويله بين القرآن والكون والأنثى، فهو يتحدث عن جوهر التوليد. وحين يتماهى الحلاج مع الحقيقة الوجودية والأنثى، فهو يجاهد للوصول في مسالك الحقيقة الإلهية التي يأتي القرآن كتجسيد لها، وصورة كتابية لكون يماثل الإنسان في كينونته المختزلة للعالم الأكبر.
أحدهما نصاً/ كتاباً، والثاني مادة وظلاً، وكلاهما: القرآن والإنسان حركة في المادة وحركة في العلامات. في تواتر لا يتوقف في الزمان والمكان.
إنه (الدَّهشُ) الذي جعل سعيد بن المسيب يقول (أنا لا أقول في القرآن شيئاً).
هو على مستوى الرؤيا، يصفه الوحي بأنه (الكتاب) و(الفرقان) و(النور) و(الهدى) و(الرحمة) و(الشفاء) و(المبين) و(الموعظة) و(البشير) و(النذير). لكنه (شفاء) بالمعنى الكينوني، الذي تنتقل به الأمة من الدونية إلى العلو، ومن التخلف إلى الفاعلية الحضارية، ومن الاستضعاف إلى الاستخلاف. وليس (الشفاء) هنا شعوذة عملت السلفية والوهابية على تحويله إلى تمتمات وتمائم، وحروز وطقوس، تغيب العقل لتخرج (الجن) الـ(متلبس بالإنسان) حسب زعمها! وقد تم دعم استقالة الوعي مادياً وإعلامياً وتعليمياً وتربوياً، ليتضخم الإسلام النفطي على حساب (الشفاء) الوجودي!
القرآن هو (النذير) من أن الاستمرار بطريق التبعية والتقليد والخنوع لايعني سوى استطالة الغياب في جحيم الدونية، والاتباع لآلهة العصر وآباء الماضي!
وهو الإبانة والوضوح للطريق الواحد، طريق الحق والخير والجمال، في مقابل طريق الباطل والشر والقبح. بلاغة الجمال في مقابل بلاغة القبح.
(القرآن) هو (النور) و(نور على نور) و(الهدى) المؤسس على الاختيار (يهدي الله لنوره من يشاء)، وهو (رحمة) للعالمين دون تمييز.
(القرآن) كما يصفه (الوحي) (قول مختلف) ومغاير لما سبق (قرآناً عَجَباً).
هو بحسب أدونيس في كتابه آنف الذكر (الكتاب الذي ينطبق عليه وصف مالارميه للكتاب الذي يحلم بكتابته (ينبوع للحقيقة تشرب منه الإنسانية جمعاء)، وهو بوصفه كتابة، يتجاوز السابقة عليه الدينية والدنيوية: يكتب الدين بلغة شعرية، ويكتب الدنيا بلغة دينية. وهو في تمحوره أساساً على اللغة، يؤكد أن الكائن هو جوهرياً، لغة.. طبيعي والحالة هذه ]كما يقول أدونيس[، ألا يشبه شيئاً خارجه، أن يكون جنساً كتابياً لذاته وفي ذاته: نثراً لا كالنثر، وشعراً لا كالشعر، وكتابة لا كالكتابة، ولغة لا كاللغة. إنه البداية والنهاية: كتابة في مستوى الكون).
(القرآن) نص لغوي، حمال أوجه في دلالاته، ولهذا تعددت تفاسيره من تفسير تقليدي قائم على المأثورات، وتفسير بالرأي والاجتهاد، وتفسير صوفي، وتفسير فلسفي، وتفسير فقهي، وتفسير اجتماعي، وتفسير أدبي.

.jpg)










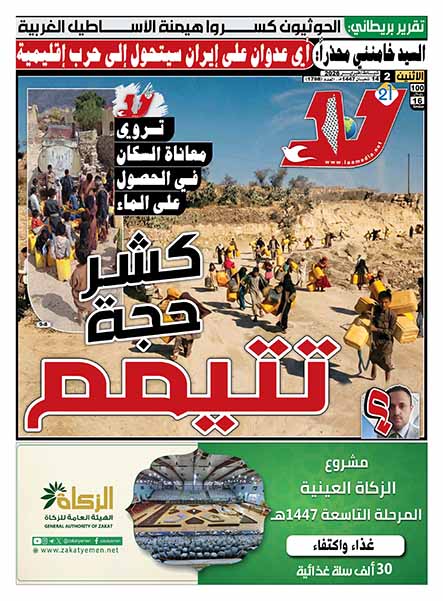




المصدر محمد ناجي أحمد
زيارة جميع مقالات: محمد ناجي أحمد