
مقالات عبدالمجيد التركي
خط أحمر
لا تراجم وبيتك من زجاج
وهم الحضارة!
الجارة السارقة
الجارة السارقة 2-2
الحثالة الملكية (1)
الحثالة الملكية 2-2
أن تكون (أنت)لا سواك
معنى الاكتمال
وهم الإمارات
أم الدنيا
كن حذاءً
مرجام الغيب 2-1
مرجام الغيب 2-2
بيت المخترعين
الكيان السعودي
كيف تريدون أن نكون؟!
السرطان السعودي
ضريبة النجاح
علي صالح عباد
العرضي ونيوزيلندا
رئيس الفندق
جنود من عسل
كلُّ شيء تلامسه شفتاها يطير
قبل العدوان
لكي لا يُقال!!
حكايات للتدجين!!
وسقط البشير
أوباش الصحراء
كنيسة نوتردام
من هم الرافضة؟
الغداء الأخير
فقهاء البلاط
جريمة جديدة
إنه علــــي...
مطــــار أبهـــــا
ديسكو إسلامي!
صديقي الذي فـي الرياض
حديث المطارات
الإصلاح.. وعلمانية تركيا
المملكة الساقطة
قرن الشيطان
رسالة من الرياض
فرعون العصر
انقلاب معادلات العدوان
المجلس الانتقامي
هادي.. حصان أعرج
عملية الردع
هذه فتاواهم!!
في ذكراه العشرين
بغاة الأرض وبغاثها
فطاف عليها طائف
ضربة أرامكو.. نصف موت
ابن سلمان.. الماضي إلى حتفه كفرعون
الزبيري وسبتمبر!
مثقفون على الورق
نصر من الله..
مبادرة سلام!
تحوُّلات المرتزقة
شعب عاطفي
دويلة المراحيض
في ذكرى مولد النور
شجون عن المولد والهجرة
أحاديث السلفيين
عـن الحسيـن
الطب الحلال
طواحين هواء
حضارة الغبار
خيط البالطو
الورد حرام!
لماذا نحن؟
الذات: فردوس مفقود
ثرثرة
اقتربت الساعة
كلُّ ما يلمع
كورونا.. تجدوا ما يسركم
تورنيدو!
ينبُع.. ولدينا مزيد
عن البردوني
هو الله
اللهم شماتة
أحرجتمونا فعلاً
الدنيا أدوال
بطولات مملكة البعير
ملك السخافة
شرف المحاولة
صدقات مؤذية
حجُّوا فـي دياركم..
رمضان كريم
ذكريات سيئة
موسم الموت
غرفة مسحورة
حكايتي مع الكتب
الردع الرابعة
الخطيب الكذاب
مجرد أقنعة لا أكثـر
مجنون.. ومرتزقة
رعب المطر
وسقطت ورقة التوت
في ذكرى البردوني
عن الحسين
تزوير التاريخ
مملكة القبح
لا يعنيني كل هذا
تزوير
ديمة خلفوا بابها..
فيروس ترامب
في مولده الشريف
وأشرقت الأرض بنور ربها
أسأنا إليه أكثر..
زمن الغوغاء
لم تعد لحومهم مسمومة
محمد المنصور
الوحا الوحا..
تفاهة الإمارات
ثقافة القطيع
يوم اللغة العربية
بين فيروسين
سنة جديدة
همجية أمريكا
أشياء لا تعنينا
ترامبيون
الثورة المسروقة
ثورة الخلافة
دوشة فبراير
كتابان للبردوني
«ونراه قريبا»..
هل ستصمد السعودية أكثر؟
طعنة الذليل
ذكرى جمعة الكرامة
والبادئ أظلم
مقامرة بن سلمان
البحث عن نصر
شهر الله
يوم الكتاب العالمي
العميقون
انتصرت فلسطين
طفولة مهدورة
ست سنوات من الفشل
مطار صنعاء.. 60 عاما من الحصار
حديقة البركاني
ثياب التقوى
اليمن الحبيب
عيد العافية
رؤية مختلفة
العدوان الكوني
تاريخنا..
جسر شهارة
أوهام العدوان
«أسماءٌ سمَّيتموها»..
عالم منافق
للحرية ثمن
أتى أمر الله
الفقر والإبداع
نوبل كرمان
محمد بن عبدالله.. المعجزة التي تشرق كل يوم
سقوط الجبروت
عبثية الحرب
وجوه تزاحم الأحذية
انتقام الذليل
ماذا تريد السعودية؟
النصر أو النصر..
الرمـح يطعن بأوَّله
أنا يمني
المنتخب والراجع
أحقاد متجددة
عام جديد من العدوان
مريم الحضرمية
أوروبا الجديدة!
عويل الإمارات
الإمارات.. هشاشة الزجاج
الإمارات.. أسرع اشتعالاً
انتفاخ العدوان
معركة مصير..
منطق الفتوحات
ثوب الآخرة
الأزهر الذي لم يعد شريفاً
«كما ردها يوماً بسوأته عمرو»
تأديب السعودية
شهر مبارك
وهم الوصاية السعودية
ألاعيب السعودية
مقدمات لا يقرؤها أحد
فتاوى متطرفة
أرشيف العدوان
جينات اللصوص
صنعاء.. أم الدنيا
أُمة الهاشتاج
تغريبة إنسانية
استرجاعات حادة
أضاحٍ وضحايا
المأزق المتجدد
أحقاد أموية
من جراب الذكريات
إشاعة التطبير
أين نحن؟!
إحباط منتصف العمر
اختلاف أمتي..
المرحومة!
سرقة جهود المغتربين
اليمن البلد المنهوب
رسالة إلى سلفي
لكي لا يُقال!
البردوني والمولد النبوي
دماء لم تجف
الورطة الكبرى
صنعاء.. أم الدنيا
ليس أكثر من «أسد المفرشة»
معاناة المغتربين
مدينة أزال.. والأزل
المثل الذي دفعت المملكة السعودية ثمن جهلها به باهظا... لا تراجم وبيتك من زجاج
مأزق المونديال
من تشجع؟
السفير التعيس
عن تراث البردوني
لا جدوى!
نصوص لقيطة
الشاب الخلوق!
دويلة الإمارات.. حضارة الغبار
عودة إلى الذات
حياةٌ واحدةٌ في المُكلاَّ لا تكفي
حوار مع مثقف سعودي
حوار مع مثقفة سعودية
الجامع الكبير
وجهاً لوجه
سبحان الذي أسرى
زحمة الوجوه
فضيلة الصمت
تسليع الإنسان
شهر مبارك
شهر الله
شهر التخفيضات
والله لا يؤمن..
علبة غراء لإنقاذ آثار شهارة!
تهمة التفكير
مليءٌ بالفراغ
بين العقل والقلب!
حق الرأي
أبي المتدفق كالماء
الترسانة الهشَّة
من صندوق الماضي
الخطبة الخطبة..
مأساة اليمني
مثل أهل الكهفِ وحدي..
معنى المعنى
تساؤلات طفولية
ما يعيبه إلا جيبه!
خطوط متوازية
الذكاء الاصطناعي
اختلاف أمتي!
ورد الليل
حفلة تنكريَّة
الطوفان..
بين الوهم والحقيقة
طعنة الذليل
وألين أفئدة..
اليمن في الصدارة
«اجتماع طارئ للحشرات»
غزة.. تسقط الأقنعة
زحام الفراغ
شجون الغريبة..
شعراء.. وثقة مهزوزة
طغيان الكيبورد
متى يرفع العرب رؤوسهم ولو لمرة واحدة؟
«ويثبّت أقدامكم»
لمن لمن؟
تحالف عربي إسرائيلي
أشبه بالمعجزات
اليمن يواجه منفرداً
أمهات غزة..
اليمن.. عود الثقاب الأخير في ليل العرب
اليمن الشامخ منذ الأزل
هذا هو الخزي المبين
غراب قابيل
شهر مبارك
شياطين رمضان
خواطر من مقبرة الرحمة..
عن الشعر الحميني
تهمة المعرفة
اسمها ليس عورة
صفحة من كتاب شهارة
سقطرى.. فهرس الدهشة والجمال
بين الحداثة والتحديث
تأملات مبكِّرة
المستقبل للشعر.. لا للشكل
شهارة.. مآثر توشك على الاندثار
كبرتُ كثيراً يا أبي..
معقم الباب
غزة المخذولة
العدو الهش
صديقة «إسرائيل»
الرد الإيراني
شهداء الفجر
عن البردوني و«مهرجان أبي تمام»
أوهن من قلب العنكبوت
عن البردوني في ذكراه الـ25
مولد النور
رحمة للعالمين
معركة كرامة
كان يجب أن يستشهد هكذا
معركة كرامة ومصير
حداثة منطفئة..
الكتابة.. شرف لا يستحقه الأدعياء
محاولة لقول شيء مختلف
عن الشعر..
هكذا نحن..
لنكن واقعيين..
من أصداء البحر الأحمر
مقدمات لا يقرأها أحد
الساعة ساعتك..
احتفال الموتى
عبدالمجيد التركي
أحتاج حياة أخرى
أشياء غير مهمة..
عمل آخر غير الصحافة
تسابيح لم تنقطع
هكذا أنت..
تراب الآخرة
هكذا أنت..
حكايتي مع الكتب
زمان الكتب
كمثل الجسد الواحد
شهر الرحمة
«وجعلناه مثلاً»..
خواتم مباركة
صواريخ لا تفزع أحداً
جريمة رأس عيسى
«المحويت».. دهشة لا تتسع لها الخريطة
مفارقة
عار مجاني!
كن أنت..
«مقبرة شهارة»
مدرهة الحاج
إيران.. معركة مصير
شاهد قبر
مسقط الروح
ما يشبه السيرة
شهارة.. والسُّرَّة المدفونة
عيون خائفة..
الإنسان.. وصداه
«ذهب الذين أحبهم»..
«خفف الوطء»..
فذلكة لغوية..
حفار القبور
حياة غير مفهومة..
حكايات من المقبرة..
جريمة حرب
«ذهب الذين أحبهم»..
الشرف العربي!!
مجرد رقم..
قلق المعرفة
في حلق الطاحون
مجرد «لايك»..
«اليمن متحف مفتوح»..
وجع المعرفة
«الإنسان الكامل»..
حياة جديدة..
مرايا مهشمة..
مثل ضوء وحيد..
جرائم شرعية
عام جديد
اعتياد الموت
أمين الصندوق
نماذج مشوهة
حبيب الله
عَلِيُّون
معنى الرتابة..
شات جي بي تي
المُعنى الكوكباني
حوار صحفي مع حفار القبور
لست مثل أبي

أحدث التعليقات
أبورعد الاعنابي على «محفوظ عجب».. وجوه تتكرر!
عبدالغني الولي على الغذاء والدواء أساسيات تتعرض للإهمال والتدمير
فاروق ردمان على عن الجدل الدائر حول تغيير مقررات التعليم!
انور حسين احمد الخزان على فضول تعزي
الخطاط الحمران بوح اليراع على قضية شرف ثوري لا شرف حجر
جبرشداد على الحسين منا ونحن منه
jbr.sh على كل زمان عاشوراء وكل أرض كربلاء
إبراهيم على هروب «إسرائيل» من الفشل إلى الجحيم
يحيى يحيى محمد الحملي على فجوة خطيرة في ثقافة الشباب العربي
جلال سعيد صدام الجهلاني على تاريخ التدخلات العدوانية السعودية في اليمن وامتداداتها (1 - 4)
ذكريات سيئة
- عبدالمجيد التركي الأحد , 7 يـونـيـو , 2020 الساعة 11:12:43 PM
- 0 تعليقات

عبدالمجيد التركي / لا ميديا -
طالما شغلتني كلمة «طوبى».. ولم أقتنع أنها شجرة في الجنة، فما جدوى تعريف شجرة واحدة بين ملايين الأشجار؟
وهي بالتأكيد لا تشبه شجرة الغريب، ولا شجرة دم الأخوين.
في مدرسة الخير لتحفيظ القرآن، لم نكن نحفظ القرآن فقط، فقد كنا نشرب حب التابعين وتابعيهم، وتابعي التابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كما شرب بنو إسرائيل حب العجل في قلوبهم.. وأخبرونا أنه لا بد أن يكون حبنا للصحابة والتابعين أكثر من حبنا لآبائنا وأمهاتنا وأطفالنا.. لم أجرب هذه الأخيرة لأنني يومها لم أنجب أحدا، فقد كنت في الـ14 من عمري.
كانوا يعبئون جيوبنا وعقولنا بالأشرطة وكتب الجيب الصغيرة، وتلك الكتب التي تكون عناوينها بخط يشبه الشوك، تعرفون هذا الخط جيدا، فهم يشوّكون أية مفردة تشير إلى الشرك، كأنهم ينصبون لنا فخاخا.
ذات يوم، طلبوا مني أن أقف أمام المصلين لألقي خاطرة.. وفي اليوم التالي طلبوا مني أن أفرش الشال بعد صلاة الجمعة لجمع تبرعات لمسلمي البوسنة والهرسك الذين كانوا يتعرضون لإبادات جماعية، ولن أنسى رقم تلك الجرافة الصفراء التي كانت تجرفهم وتلقي بهم في حفر كبيرة ثم تهيل عليهم التراب كما لو أنهم نفايات نووية.
في سن الـ15، كنت قد قرأت كتبا كثيرة كـ»حصن المسلم، العائدون إلى الله، آيات الرحمن في جهاد الأفغان، قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام أبيدوا أهله، ماذا يعني انتمائي للإسلام، فقه السنة، زاد المعاد في هدي خير العباد، لماذا أعدموني، معالم في الطريق، رجال حول الرسول، ثم اهتديت، تفسير الجلالين، وكتاب (تحفة العروس) لابن قيم الجوزية»، فقد كنت أخطط للزواج في ذلك السن كي لا أستعجل على الذهاب إلى الحور العين.
كان زواجي في الـ17 حرزاً وحصناً من البحث عن الحور العين بين أشلاء الشهداء. لم أكن أنوي أن أدخل الجنة وأنا أمشي على الجماجم والدماء، فقد كان عقلي راجحا، وكنت أعرف أين موقعي في هذه الحياة.. لكني لم أكن أرى موضع قدميّ، فبقيت مكاني حتى اتضحت الرؤية وبدأت أول خطوة في طريق كل ما فيها يقين، وفي كل خطوة سلامة.
«لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما»، ونردد: سُلّما يا سُلّما.. وحين آوي مساء إلى فراشي أتخيل سُلّم الجماجم هذا قبل أن أنام، وأبحث عن جمجمتي التي تم اعتبارها جزءاً من ذلك السّلم الذي لا أدري من سيستخدمه ويدوس على جماجمنا ويصعد إلى قبة البرلمان في الانتخابات القادمة!
«مرحباً بكم أيها الأشداء على الكفار، الرحماء بينكم».. كانت هذه التحية (الصعترية) أول ما سمعته من الشيخ عبدالله صعتر، ونحن في مخيم صيفي بحي القادسية، شارع تعز.
التفت يمينا وشمالا.. فلم أجد الأشداء ولا الرحماء..
كان إطفاء الخيام مقررا في الساعة التاسعة مساء لكي نخلد للنوم، وقبلها بعشر دقائق كانوا يطفئون الكهرباء ويعيدونها في نفس اللحظة كإشارة للاستعداد للنوم.
كنت أخبئ القات العنسي في الخيمة وأتناوله في الظلام، كما كنت أخفي مسجلاً صغيراً وشريط كاسيت عنوانه «نداء البعيد».

.jpg)










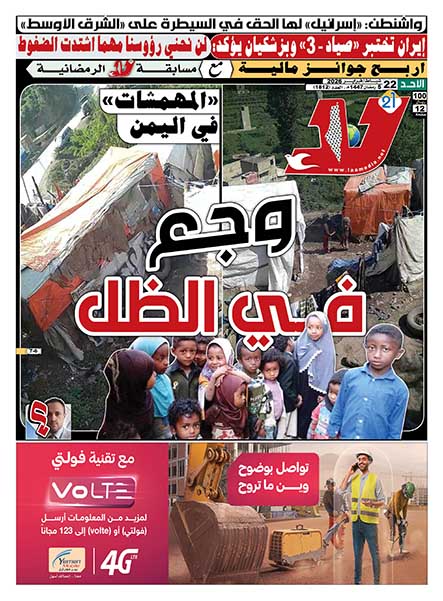


المصدر عبدالمجيد التركي
زيارة جميع مقالات: عبدالمجيد التركي