«الزمن الجميل».. هـل كـان جميـلاً حقــاً؟! الحلقة 27
- مروان ناصح الأربعاء , 1 أكـتـوبـر , 2025 الساعة 2:00:37 AM
- 0 تعليقات

مروان ناصح / لا ميديا -
الكاتب.. بين سلطة الإبداع ومكتب الخدمات الأدبية
(كيف تحوّلت الرواية إلى منتَج يُطلب عبر الإعلانات؟)
في "الزمن الجميل"، كان الكاتبُ يعيش في الظل، ويكتب بنور داخلي لا تراه الأعين. لم يكن يبحث عن صوره في المعارض، ولا عن توقيعه في حفلات التدشين. كان يكتب ليعيش، لا ليُصفَّق له.
أما اليوم.. ففي ركن صغير من إحدى منصات الإعلانات، تقفز أمامك عبارة مذهلة:
"أكتب لك روايتك.. من فكرتك أو من لا شيء، باسمك الكامل، ولَك حق التوقيع والنشر".
من لا شيء؟!
أيّ زمن هذا، يُعرض فيه الحُلم الأدبي على هيئة خدمة توصيل للمنازل؟!
بين الأمس واليوم: الكاتب موظف أم مُنتحل؟
في الماضي، كان الكاتب يُعدُّ شبه نبيٍّ، ينزوي، يخشى أن يُؤخذ عليه ضعفٌ في الصدق أو ميلٌ إلى الزيف.
أما اليوم، فقد صار بعضهم "كاتب ظلّ" لمن لا ظلّ له، و"أجير سطور" لمن لا يعرف القلم من الممحاة.
هل كان ذلك مقبولًا؟
ربما حين يتعلّق الأمر بتوثيق سيرة، أو تحويل يوميات عجوز إلى حكاية حقيقية.
لكن حين تُستولد الرواية من فراغ، وتُنسب زورًا، وتُوقَّع باسم شخص لم يعرف خيبات شخصياتها، فهنا لا نكتب، بل نُمثّل.
من الكاتب الملهم..
إلى بائع المجد الأدبي
في الزمن الجميل، كانت الرواية ابنة عرق، ومخاض، وتأمل، وخسارات.
أما في "زمن الخدمات الأدبية الفاخرة"، فقد صارت:
سلعة يطلبها من "يحلم" بأن يكون كاتبًا.. لكنه لا وقت لديه.
بطاقة عبور اجتماعي لمن يهوى صورته مع روايته، أكثر من الرواية ذاتها.
فرصة استثمارية لمن قرّر أن ينشر مجده مقابل أجر.. وينام وهو "كاتب" على غلاف كتاب لا يعرفه.
حين يفقد الأدب روحه
في الزمن الجميل، كان الكاتب يخجل من تزوير الحرف، وكان القارئ يثق بما يقرؤه.
أما الآن، فقد صارت الرواية أداة تزييف ناعم، و"صفقة" تُبرم في الخفاء بين من يدفع.. ومن يكتب.
النتيجة؟
روايات بلا نبض.
كتّاب بلا تجربة.
قرّاء يشعرون أنهم خُدعوا، فيفقدون الثقة لا بالكاتب فحسب.. بل بالكِتاب نفسه.
هل من استثناء مشرّف؟
نعم، لا بد من الإنصاف:
ثمة من يملك سيرة جديرة بأن تُروى، لكنه لا يعرف كيف يكتب.
ثمة من يملك الفكرة، ويتعاون بصدق مع كاتب حقيقي، فيُنتج عملًا مشتركًا.
لكن هؤلاء لا يخفون الحقيقة، بل يضعون على الغلاف:
"كتب بالتعاون مع...".
أما أولئك الذين يشترون الرواية كما يشترون بذلة سهرة، فهُم لا يصنعون أدبًا، بل يصنعون خدعة.
خاتمة
في "الزمن الجميل"، كان الكاتب يُنادى باسمه.. لا بلقبه.
وكان القلم حارسًا للهوية لا خادمًا لمجدٍ زائف.
أما اليوم، فقد دخلت الحروف سوق العروض:
"رواية كاملة خلال أسبوعين.. والاسم كما تشاء".
فهل كان زمن الأمس أجمل، أم أن جماله كان في خوفه من الكذب؟
وهل نكتب اليوم لنُقنع.. أم لنبيع؟

.jpg)









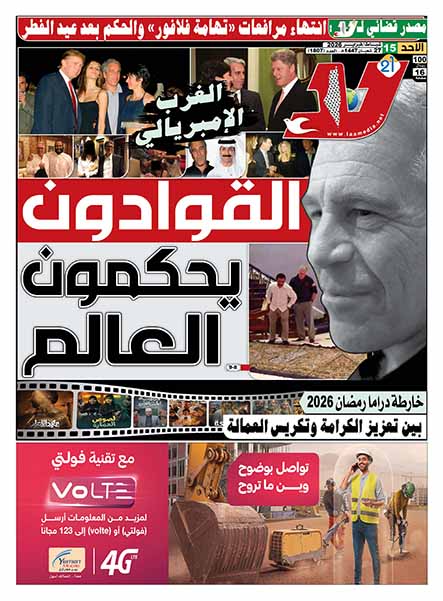
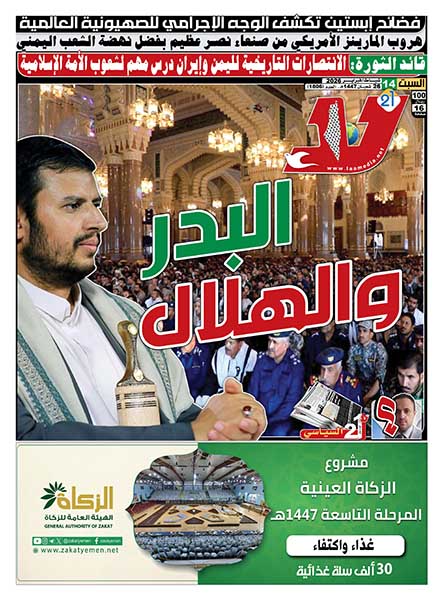




المصدر مروان ناصح
زيارة جميع مقالات: مروان ناصح