خطورة التأصيل التوراتي للصهيونية والصراع معها
- موفق محادين الأثنين , 4 أكـتـوبـر , 2021 الساعة 7:38:00 PM
- 0 تعليقات
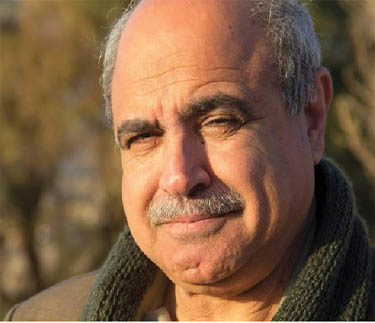
د. موفق محادين / لا ميديا -
رغم أن الإسلام ونصوصه المقدسة يحفلان بآيات ومأثورات تميز بين قبيلة «بني إسرائيل» وبين اليهود وتحذر منهم ومن مكائدهم، راح مشايخ النفط والغاز والعثمانية الجديدة والدوائر البريطانية، الأمريكية، يحرفون الكلام عن مواضعه و»يجتهدون» بتأويل أكثر من آية قرآنية تبريرا للغزو الصهيوني واحتلاله لفلسطين العربية، ومن ذلك ما جاء في سورتي «الإسراء» و»المائدة».
ففي الأولى ما نصه بعد آية غرق فرعون: «وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا» (الآية 104)، وفي الثانية الآيات من (19 ـ 22): «وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين».
أيضا، فإن عدم ورود كلمة فلسطين في القرآن، وورود اسم المسجد الأقصى مرة واحدة في سورة «الإسراء»، يوظف على نحو مريب مما يستدعي باستمرار الفصل بين تاريخ اليهود وقبيلة «بني إسرائيل العربية» المتهودة، باعتبار ذلك جزءا من التاريخ العربي المتنوع، وبين «إسرائيل» الحالية باعتبارها امتدادا إمبرياليا للاستعمار الأوروبي ثم الأمريكي، ولا علاقة لها بقبيلة «بني إسرائيل العربية» القديمة.
وبالمثل إذا كانت هذه القبيلة جماعة بدوية صحراوية جوابة، فإن فلسطين عنوان لحضارات عريقة ولأرض تاريخية لا تنفيها الأسماء المتعددة لها بل تؤكدها من أرض كنعان إلى سورية الجنوبية.
في ضوء ما سبق، ومنعا لاختلاط الحابل بالنابل، وحتى لا توفر التأويلات المشبوهة لفتاوى ومشايخ النفط والغاز والعثمنة والأطلسي، أي غطاء للعدو الصهيوني و»صفقة القرن»، فلا بد من فصل واضح قاطع بين اليهود العرب القدامى وأيديولوجيتهم التوراتية الرعوية العنصرية، باعتبارها أحد مظاهر الوجه السلبي من تاريخنا العربي، وبين اليهود الاشكنازيم وأصولهم الخزرية التركية والمشروع الصهيوني الذي انخرطوا فيه خدمة للدوائر الاستعمارية، فهم ليسوا عربا ولا يحق لهم الادعاء بوطن موعود وبأي شبر عربي، وبإمكانهم الحديث أو الحنين إلى موطن أصلي في بلاد الخزر لا في بلادنا.
والجدير ذكره أن ستالين والكومنترن (المكتب السياسي للأممية الشيوعية) سبق واقترحا في العقد الثالث من القرن العشرين إقامة حكم ذاتي لليهود في منطقة الخزر المذكورة بدلا من فلسطين (وثائق الكومنترن).
متى نتحرر من الرواية التوراتية للشرق؟!
من المؤسف أن بعض الاستشراق الألماني بشقيه الهيغليي والماركسي وبعض الاستشراق الروسي هو الذي فتح أو دعا إلى فتح النقاش حول الروايات التوراتية للشرق، باعتبارها شكلا من (التدوين) الأيديولوجي العنصري، وكان على الشرقيين العرب وغير العرب أن يفتحوا هذا الملف، بل إن الثقافة الشرقية فيما يخص تاريخ الحضارات والأديان مخترقة إلى حد كبير من الروايات التوراتية، التي سعت إلى شطب حضارات الشرق القديمة العظيمة التي سبقتها، مثل الفرعونية وحضارات بلاد الشام والرافدين، بل وعملت على شيطنتها.
ولو دققنا في هذه الروايات لوجدناها تطيح بأهم الصفحات الحضارية الشرقية عن طريق الخلط بين حوادث واختلاقات محددة وبين مجمل هذه الصفحات.
لقد تحولت قصة فرعون وموسى إلى موقف عام ضد الحضارة الفرعونية برمتها، وكذلك ما يقال عن «السبي المزعوم» الذي حول بابل إلى حضارة ملعونة، وأصبح الشرقيون يقاربون حضاراتهم القديمة بعيون يهودية، فصلت بين الدعوة الإسلامية وبين الحضارات العظيمة التي سبقتها وشكلت البيئة المناسبة لها.
ومن المظاهر الأخرى، الموقف من الحضارة الحجرية، فقد ميزت اليهودية بين الحجارة غير المشذبة (المقدسة) حيث تسري فيها الروح اليهودية، وبين الحجارة المنحوتة التي تمثل الوثنية والوثنيين، وبالمثل موقفها من الشعر والشعراء وكذلك من الزراع، فاليهودية حالة من القبائل الرعوية القمرية الجوابة.
ويلاحظ المتمعن في الروايات اليهودية العداء المستحكم للحضارات الحجرية مثل حضارة الفراعنة وحضارة أهل بابل ونينوى في العراق القديم، فمن تأويلهم لرحلة إبراهيم وخروجه من العراق إلى تأويلهم لخروج «بني إسرائيل» من مصر على يد أحد الفراعنة، إلى تعييرهم لبعض قادتهم الذين تزوجوا من أهل الحجر (الحضارات الحجرية) إلى ربطهم بين روايتهم عن السبي، وبين بابل الحجرية.
والمهم من كل ما سبق أن القراءات اليهودية المذكورة تنسف الرواية الصهيونية عن هيكل سليمان المزعوم باعتبار فكرة الهيكل بحد ذاتها تتناقض مع (المقدسات) اليهودية.
إلى ذلك، وتحت تأثير «الإسرائيليات» في التراث العربي، ثمة تأويلات وشطط في قراءة بعض النصوص المقدسة عربيا، لا تنسجم مع الروح الإسلامية والمسيحية الحقيقية، ومن الشطط في تفسير النص «والشعراء يتبعهم الغاوون» إلى الشطط في تفسير قول منسوب إلى الخليفة عمر: «لا تستنبطوا» أي لا تصبحوا مثل الفلاحين (الأنباط)، بل إن باحثا مثل محمد شحرور في شطط معاكس، حاول أن يربط بين الكفر والفلاحة مستعينا بأسماء بعض القرى والبلدات في بلاد الشام ومصر (كفر كذا...).
أما الشطط الذي يقترب من الأراجيف بحق النصوص المقدسة هو مقارنة ما حدث لبابل ومصر الفرعونية (الحضارات الحجرية) بسبب الموقف من اليهود، مع ما حدث لقوم عاد (قد يكونون أسلاف الأنباط) وإقحام تأويلات معينة لآيات أخذت خارج سياقها وردت في سورتي «الحجر» و»الشعراء»: «وكانوا ينحتون الجبال بيوتا»، «وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين».
والأغرب من كل ذلك، الحضور الكبير لحاخامات متعصبين في قلب التاريخين الإسلامي والمسيحي، لم يتورعوا عن إطلاق المزاعم، بل الأراجيف السوداء بحق النبي محمد والنبي عيسى، ومن هؤلاء موسى بن ميمون الذي يعده اليهود المؤسس الثاني لتوراتهم الملفقة، وقد وصلت به الوقاحة درجة وصف بها النبي محمد بالنبي الكذاب، ووصف عيسى بالنبي الدجال.
ووجه المفارقة هنا أن ابن ميمون هذا كان مستشارا لأحد أهم قادة التاريخ الإسلامي وهو صلاح الدين الأيوبي الذي حرر القدس من غزو الفرنجة، لكنه سمح بتأثير ابن ميمون لليهود بدخول القدس بعد معركة حطين في تناقض واضح مع العهدة العمرية.
ومن الأمثلة الأخرى على الاختراقات التوراتية التأويلات التي تناولت قتل قابيل لهابيل وتصوير البشر كأبناء للقاتل، وحكاية لوط وابنتيه وتصويرنا كأبناء سفاح، وتأويل حكاية إبراهيم وولديه على نحو مخالف للروح الإسلامية، وتصوير العرب كعبيد و»غوييم» من أبناء هاجر في خدمة اليهود كأحرار مزعومين، وكذلك السور التي دعت «بني إسرائيل» إلى دخول فلسطين مثل سور «الإسراء» (104) وسورة «المائدة» (19-23).
ولم يكن المسلمون وحدهم ضحية الرواية التوراتية، فقد كان اختراقها الأكبر في الوسط المسيحي، حين جرى ضم التوراة والإنجيل في كتاب واحد باسم «الكتاب المقدس»، وذلك رغم أن اليهودية لا تعترف حتى اليوم بمجيء المسيح، وتعتبر المسيح الذي يوقره مسيحيو ومؤمنو العالم، مسيحا دجالا.
وقد جرى التحول المذكور على دفعتين: الأولى: خلال فترة قسطنطين واتساع الإمبراطورية الرومانية في مرحلة الرق وتبنيها المسيحية واكتشافها أنها فكرة خلاصية دون شريعة، فأكملتها بالشريعة اليهودية الصحراوية التي تتناقض كل التناقض مع جوهر المسيحية الزراعية.
والثانية: خلال تحول أوروبا من الإقطاع إلى الثورة الصناعية البرجوازية وحاجتها إلى صفقات مالية بعد أن انتقل المرابون اليهود من دعم الإقطاعيات المنهارة في أوروبا، إلى دعم البرجوازيات الصناعية والدول الملكية الصاعدة، فتوقفت حملات الملوك والكنائس ضدهم وفتحت أبواب الأندية البرجوازية أمامهم وأعلن الفاتيكان براءة اليهود من دم عيسى، وتبنى الرواية العبرانية وخاصة الواردة في «إنجيل متى» التي ردت المسيح إلى سلالة داود وزعمت أنه اختتن في القدس، وخالفت أقوال بولس حول «مسيحية الأمم/ة» التي لا تشترط الإيمان بالعهد القديم.
إلى ذلك، يعلن هيغل ثم تلاميذه (الشباب) أن اليهودية في أحسن أحوالها «وعي شقي» ويعلن انجلز (رفيق ماركس) أن يهود الشرق لم يعرفوا الحضارة قط وأنهم كانوا قبائل همجية متخلفة يؤجرون خدماتهم بين البلاط الفرعوني والبلاط الفارسي، ولم يكتفوا بسرقة الأغنام، بل سطوا على تراث الشرق ونسبوه مشوها لهم.
أما ماركس في سجاله مع اليهودي العلماني برونو باور فيقول إن تحرر اليهود في أوروبا ليس مسألة دينية، بل مسألة اجتماعية اقتصادية، فعلى اليهودي أن يتحرر أولا من يهوديته، بل وعلى العالم نفسه إذا أراد التحرر من الرأسمالية أن يتحرر من الربوية اليهودية. وفي قراءات أخرى تدحض أية علاقة بين اليهودية والمسيحية وتؤكد أن هذه العلاقة علاقة حديثة ناجمة عن تحول الثورة الرأسمالية الصناعية الأوروبية إلى رأسمالية ربوية يهودية، فإن البيئة التي ولدت فيها اليهودية مناقضة تماما للبيئة المسيحية.
فاليهودية ظاهرة رعوية لجماعات غازية أو جوابة (جوالة) تقدم خدماتها التجارية والعسكرية للغزاة وتجار القوافل، وتنسجم بالتالي مع الثقافة الليلية التي تناسب الصحارى، وتتخذ من القمر تأويلات أيديولوجية بطرياركية لها. أما المسيحية فظاهرة زراعية نهارية شمسية تشبه طقوس وثقافة تموز وأدونيس واوزيريس التي تحتفي بالأم والابن والتثليث عموما وليس للتقسيم السابق أية علاقة ببعض التأويلات التي تجد قواسم مشتركة داخل الإسلام نفسه بين اليهودية وتأويلات حول أهل السنة والجماعة، وبين المسيحية وبعض التأويلات الشيعية.
ويشار كذلك إلى أن الأناجيل المعروفة والثانوية لم تذكر الإله اليهودي «يهوه» أبدا.
كاتب ومحلل سياسي أردني

.jpg)









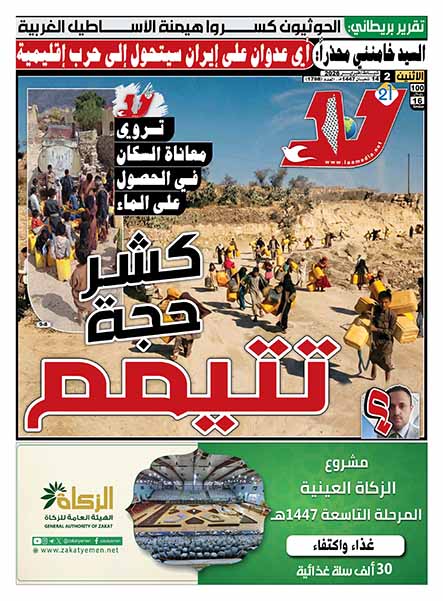






المصدر موفق محادين
زيارة جميع مقالات: موفق محادين