ملحق «لا» 21 السياسي - العدد (1811)
- تم النشر بواسطة «لا» 21 السياسي

بين اعتقال الأسئلة واقتتال الإجابات.. اسمعوا وعوا
في الحياة العامة لا تتحول الوقائع الصغيرة إلى قضايا رأي عام إلا حين تمس العلاقة بين الدولة والمجتمع. وقد يبدأ الجدل من مقال؛ لكنه إن لم يبق مقالاً فسيتحول إلى نقاشٍ حول موقع الكلمة في المجال العام وحدود التعامل معها.
إن ما كتبه خالد العراسي لم يُستقبل باعتباره رأياً قابلاً للنقاش فحسب، بل باعتباره حدثاً يستدعي إجراءً. وهنا يتشكل السؤال: هل النقد جزء من وظيفة المجال العام أم هو خروج عليه؟
فالدولة التي تعتبر الملاحظة خصومة تُضيّق على نفسها أدوات التصحيح، بينما الدولة التي تستوعبها توسّع مساحة الاستقرار.
القضية -إذن- لا تتعلق بشخص الكاتب، بل بمبدأ التعامل مع الخطاب العام. فالأخطاء التي تُناقش داخل الإطار المؤسسي تتحول إلى إصلاح، أما التي تُدفع إلى الهامش فتتحول إلى أزمة. ومن هنا يصبح النقاش حول المقال نقاشاً حول آلية التصويب، لا حول صاحب النص.
في السياق، وفي ذكرى رمضان المظلومية العاشر، يعلن شرف حجر إضرابه عن الطعام كسبيل احتجاج أخير، بعد تعثرٍ جديدٍ طاحت به اللجنة التاسعة في مشوار اللجان المكلفة بتنفيذ توجيهات السيد القائد الصادرة لرفع مظلوميته وإنصافه. وهنا لا يعود الأمر متعلقاً بشخص أو قضية فردية، بقدر ما يصبح مؤشراً إلى أزمة آلية: كثرة لجان وقلة حلول، وتكرار إجراءات دون نهاية واضحة.
إن الفرق بين الدولة التي تُهدئ الناس، والدولة التي تُقنعهم، هو المسافة بين الوعد والتنفيذ. فالمظالم حين تُرحَّل بين اللجان تتراكم في الوعي العام كدليل عجز، لا كإجراءات عمل. وعندها يتحول الاحتجاج من خطاب إلى فعل، ومن مطالبة إلى صرخة أخيرة.
وفي السياق ذاته، وإن في بُعدٍ أوسع، تقف رداع كحالة اجتماعية تبحث عن علاقة طبيعية مع سلطتها: قانون يُطبَّق بمعيار واحد، وإدارة تُراجع قراراتها، وثقة متبادلة لا تُبنى بالشعارات بل بالممارسة اليومية للعدل. فالمدن لا تحتاج إلى خطابات تطمين بقدر حاجتها إلى إجراءات واضحة يشعر بها الناس في حياتهم.
الدولة لا تُختبر حين تُمدَح، بل حين تُنصَح؛ فإن ضاقت بالنصيحة اتسعت الأزمات، وإن اتسعت لها ضاقت بالفوضى.
ولهذا فإن السؤال لا يقف عند حدود كتابة مقال، بل يمتد إلى كل مظلومية مؤجلة أو قضية عالقة لا تجد طريقها إلى المعالجة. فحين يغيب المسار الواضح للإنصاف يتحول الأمل إلى انتظار، والانتظار إلى احتقان.
لهذا لن يبقى السؤال: ماذا كتب خالد العراسي؟
ولماذا أضرب شرف حجر؟
ولا حتى لماذا يحدث ما يحدث في رداع؟
بل السؤال الأعمق: كيف تُدار العلاقة مع المجتمع حين يتكلم، وحين يتألم؟ وبأي منطق ستُكتب الخاتمة؛ بمنطق الاحتواء أم بمنطق الانتظار؟
عندما يخاف البحر من اليابسة.. «تل أبيب» تضع خوذة سباحة
يبدو أن كيان الاحتلال اكتشف أخيراً أن اليمن ليس اتجاهاً في تطبيق الملاحة، بل جبهة. فالكيان، الذي كان يقيس أمنه بعدد الكيلومترات، صار يقيسه بعدد المسيّرات.
اليوم تتدرّب قواته على صدّ «تسلّل بحري» من صنعاء إلى «إيلات» (أم الرشراش)، وتضع البحر الأحمر ضمن خرائط الدفاع الداخلي. باختصار: تحوّل باب المندب من ممر تجارة إلى عقدة نفسية. ولهذا اعترف إعلامه مرغماً: «لا أحد يستخف بنوايا وقدرات الحوثيين».
وبدلاً من حساب زمن وصول الصاروخ، صارت قوات الجريمة تتدرّب على وصول المقاتل. لم يعد الحديث عن اعتراضٍ في السماء فقط، بل عن اشتباكٍ على الأرض، وحتى داخل المستوطنات.
ولهذا لم يعد القلق عسكرياً بحتاً، بل نفسيّاً: مدينة «إيلات»، التي بُنيت كمنتجع، تُدار اليوم كقاعدة حدودية: بطاريات مدفعية، كتائب إضافية، تعبئة سكان، وحدات محلية، تدريبات اقتحام مضاد... والأهم اعتراف صريح: لا يوجد «إسرائيلي» يشعر بالأمان التام.
المفارقة أن «تل أبيب» لا تستعد لحرب بدأت، بل لحرب تخشى أن تبدأ من حيث لا تريد. فكلما فشلت في غزة، اتسعت الجغرافيا من حولها تلقائياً؛ الجنوب يفتح الشرق، والشرق يفتح البحر.
أما واشنطن فتفعل ما تجيده دائماً: تحشد كي تفاوض، وتفاوض كي تحشد. حتى إعلامها يقول بوضوح: «إدارة ترامب أقرب إلى حرب كبرى في الشرق الأوسط أكثر مما يدركه معظم الأمريكيين»، أي أن الحرب ليست خطأ حسابات، بل طريقة حساب. وفي الخلفية يصرخ بعض الأمريكيين من نتنياهو نفسه: «نتنياهو يخدع ترامب واليهود الأمريكيين مرة أخرى». لكن أحداً لا يتوقف؛ لأن المشكلة لم تعد قرار حرب، بل عجز عن التراجع.
«إسرائيل» تحتاج التصعيد كي تستعيد الردع. وأميركا تحتاجه كي تحافظ على الهيمنة. بينما المنطقة تتحمّل اختبار النظام العالمي الجديد.
اليمن هنا ليس أقوى عسكرياً من الجميع؛ لكنه أخطر معادلاتياً: من يهدّد الممر يهدّد السوق، ومن يهدّد السوق يهدّد السياسة. لهذا يخافون من صنعاء أكثر مما يخافون صاروخها؛ فالصاروخ قد يُعترض، أما الفكرة فلا.
حين يختلف اللصّان على الغنيمة..يذبح أحدهما الآخر
لم يكن الخلاف السعودي - الإماراتي مفاجأة في صنعاء؛ كان مجرد موعدٍ متأخر لوصول الحقيقة.
فالتحالف، الذي قُدِّم يوماً باعتباره «جبهة واحدة»، لم يكن سوى شركتين استثماريتين تتقاسمان خريطة، لا دولتين تبحثان عن استقرار. منذ 2015 دخل الطرفان الحرب في اليمن بشعار واحد، لكن بأهداف مختلفة: الرياض أرادت حدوداً آمنة ونصراً سياسياً سريعاً، وأبوظبي أرادت موانئ ونفوذاً طويل الأمد. اليمنيون وحدهم كانوا الهدف المشترك.
اليوم، وبعد سنوات من القصف والحصار، اكتشف الحليفان أن المشكلة ليست في صنعاء، بل فيهما.
التقارير الغربية نفسها باتت تتحدث بصراحة: السعودية تريد إطفاء الحريق لأنها احترقت اقتصادياً وأمنياً، والإمارات تريد إبقاء الجمر مشتعلاً لأنها تبني نفوذها فوق الرماد.
لهذا تحديداً ظهر التناقض فجأة، في اليمن والسودان والبحر الأحمر: الرياض تبحث عن هدنة تحفظ ماء الوجه، وأبوظبي تبحث عن واقع جديد يضمن الموانئ والممرات.
المفارقة أن الحرب التي أُعلنت لمنع «الخطر الإيراني» انتهت إلى خوف سعودي من حليفها أكثر من خصمها، بينما تحوّل شعار «استعادة الشرعية» إلى صراع على من يمتلك الجزر والسواحل.
حتى واشنطن لا ترى في الخلاف مأساة، بل سوقاً: كل طرف يعرض استثمارات، صفقات، وولاءً أكبر.
ومن يدفع أكثر يحصل على «القلق الأمريكي» من الآخر.
أما صنعاء فتنظر للمشهد ببساطة: ثماني سنوات من الحرب لم تُنتج دولة تابعة، بل أنتجت تنافساً بين رعاتها.
لقد دخلوا اليمن معاً لإخضاعه، وخرجوا منه مختلفين على من خسر أكثر.
وفي النهاية، لم تسقط صنعاء، بل سقطت فكرة أن التحالفات المصنوعة من المال يمكن أن تصمد أمام الجغرافيا.
من سور المدرسة إلى سماء الحرب.. رمضان الذي لم ينكسر
كان رمضان في طفولتنا يبدأ من خلف سور المدرسة، لا من رؤية الهلال.
من ركضةٍ خاطفة، وعلبة تونة مهربة، وعلبة زبادي تُفتح كأنها مؤامرة صغيرة ضد الجوع. لم يكن إفطار الظهيرة خيانةً بقدر ما كان اعترافاً مبكراً بضعف الجسد، وقوة الرغبة. كنا نقسم اللقمة بيننا بعدلٍ صارم: «نصف لك، ونصف لي»، ثم نعود إلى الصف ببراءة من يخطئ؛ لأنه يريد أن يكون صالحاً.
ومع الغروب، ننقلب فجأة إلى رجالٍ صغار. كوافٍ بيضاء، سِبَح أطول من أصابعنا، وخطوات متثاقلة نحو الجامع. هناك، قبل الأذان، كانت الحلقة تتكوّن بلا ترتيب: تمرٌ في منديل، «سمبوسة» دافئة، خبز، «لحوح»، قارورة عصير، وصحن «عصيد» يتوسط الجميع كقلبٍ مطمئن. لم يكن أحد يسأل: من أحضر ماذا؟ كان الفطور ملكاً للجميع، والنية تكمل ما ينقصه الجوع.
ثم كبرنا، وكبر معنا رمضان؛ لكن العالم لم يكبر بالبراءة نفسها. جاءت الحرب، وتغيّر صوت المدينة. لم يعد الأذان وحده يشقّ الغروب. انطفأت أنوار، وتقلّصت موائد. صارت «السمبوسة» أقل، و«اللحوح» يُقسَّم بحساب، والعصير يفقد برودته، و«العصيد» تتواضع كأنها تعرف أن البلاد في امتحانٍ قاسٍ.
ومع ذلك... لم ينكسر المعنى.
يد الأم بقيت كما هي، توزّع القليل كأنه كثير. الدعاء صار أطول، والصبر أعمق، والأذان لم يعد إعلان وقت فحسب، بل إعلان صمود. صار الإفطار نجاةً مزدوجة: من الجوع، ومن يومٍ ثقيل على وطنٍ يتنفس بصعوبة.
في الحرب نأكل أقل؛ لكننا نحمد أكثر. نضحك أقل؛ لكننا نتمسك ببعضنا أكثر. نخاف، نعم؛ لكننا نرفع أيدينا أعلى.
من سور المدرسة إلى سماءٍ مثقلة، تغيّر الطعم؛ لكن الإيمان باقٍ. لم تعد التونة سراً، ولا الزبادي مؤامرة، ولا «السمبوسة» مجرد عجين... صارت رموزاً لذاكرة تقاوم. «اللحوح» صار وجه أم، و«العصيد» دفء بيت، و«المعصوب» جرعة سكر نحتاجها لموازن مرارة الأيام.
رمضان لم يكن يوماً في وفرة الطعام، ولا في ادعاء الصوم الكامل. كان -وما يزال- في المحاولة، في القسمة العادلة للّقمة... وللألم.
كنا أطفالاً نفطر سراً خلف سورٍ صغير، ثم ندّعي البطولة مساءً. واليوم نصوم خوفاً، ونفطر رجاءً، ونتعلم أن الثبات ليس أن يختفي الجوع، بل أن يبقى المعنى. ومع كل هلال، نعود -دون أن نعترف- إلى تلك الحلقة البسيطة التي لا يسأل فيها أحد: من يملك؟ بل يقول الجميع؛ رغم الحرب، ورغم النقص، ورغم الخوف: «هذا لنا جميعاً».
«زبادي» طوال السنة..«شفــــــــوت» فــــــــي رمضـــــــــــــــان
ليس الصيام في اليمن امتناعاً عن الطعام فحسب؛ إنه تمرينٌ طويل على الاحتمال. صيامٌ عن الرواتب المنتظمة، عن الكهرباء المستقرة، عن الطمأنينة التي لا تقطعها الأخبار...
عامٌ كامل من الإمساك، عن الشكوى أحياناً، وعن الغضب كثيراً. لكن حين يأتي رمضان، لا تمتلئ الموائد بقدر ما تمتلئ القلوب.
تخرج «الشَّفوت» إلى الضوء، بطبقها البسيط المغمور باللبن، كأنها درسٌ في اللين بعد عامٍ من القسوة.
وتتوزع «السمبوسة» مثل جيوبٍ صغيرة تحفظ ما تيسّر من الفرح، هشّة من الخارج، دافئة من الداخل، تشبه هذا الشعب الذي يبدو مُتعباً لكنه يخفي حرارة الحياة.
أما «بنت الصحن»، بطبقاتها المتراصة وعسلها المنسكب، فهي ليست حلوى فقط؛ إنها صورة اليمن نفسه: طبقات من التاريخ والوجع والأمل، يجمعها عسل الصبر فلا تتفكك.
وفي زاوية المائدة، تقف «العصيد» بثباتها المعروف، كأنها تجسيد للتماسك الشعبي؛ بسيطة في مكوّناتها، ثقيلة في حضورها، لا تحتاج إلى تكلّف كي تكون مشبِعة.
حتى التمر الهندي، بحموضته الخفيفة، يذكّر بأن الحياة لا تُذاق بحلاوتها وحدها، وأن المرارة جزء من النكهة، لا نقيضها.
في اليمن، الإفطار ليس لحظة كسر الجوع فقط، بل كسر العزلة. يُقسَّم الخبز كما تُقسَّم الهموم، ويتحوّل الفقر إلى مشاركة، لا إلى خجل.
اليمني الذي صام عاماً عن الاستقرار، لا يفطر في رمضان على الشبع وحده؛ يفطر على اجتماع العائلة، على دعاء الأم، على ضحكة طفلٍ ينتظر قطعة إضافية من «بنت الصحن»، وعلى يقينٍ صغير بأن الله لا ينسى أحداً.
هنا، يصبح الطعام لغةً أخرى. تصير «الشفوت» طمأنينة، و«السمبوسة» ستراً، و»بنت الصحن» وعداً بأن العسل ممكن، مهما طال زمن المرارة.
لهذا تبدو العبارة، رغم قسوتها، صادقة: اليمنيون يصومون طوال العام، ويفطرون في رمضان.
يفطرون على بعضهم. يفطرون على ما تبقى من دفءٍ في عالمٍ بارد. ويؤجلون جوعهم الأكبر (الجوع للعدالة والسلام) إلى فجرٍ قادم؛ لكنهم، كعادتهم، يضعون له مكاناً محفوظاً على المائدة.

.jpg)












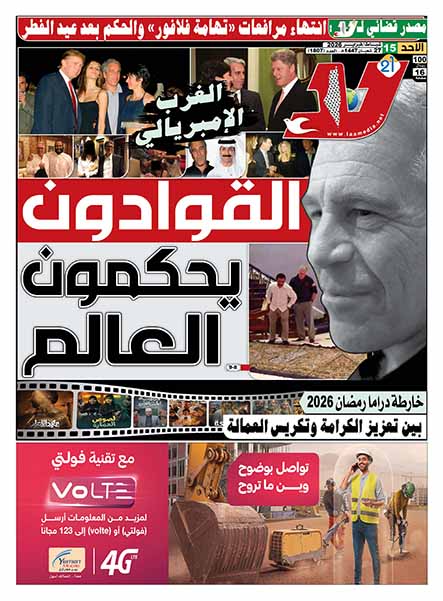
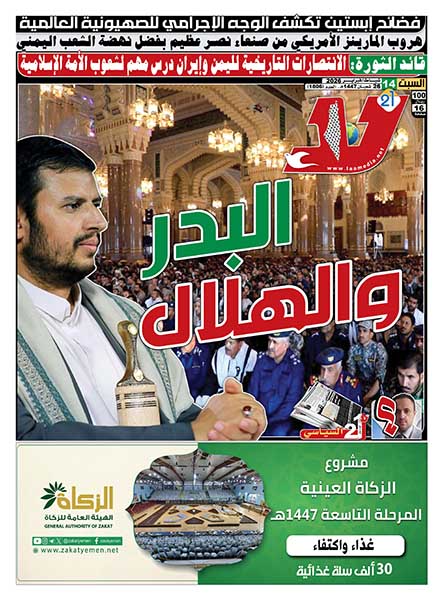


المصدر «لا» 21 السياسي