«الهولوكوست».. وقد تحولت إلى مذبح كوني أمام «يهوه».. الغرب الحريات هشيم لـ«محرقة» زائفة
- تم النشر بواسطة نشوان دماج / لا ميديا

نشوان دماج / لا ميديا -
لا شيء أقوى وأكثر رسوخاً من رواية يتم الترويج لها فتصبح تاريخاً. وحده الترويج قادر على تغليب روايته وجعلها حقيقة مطلقة لا تقبل الدحض بالنسبة للتاريخ. وما التاريخ في النهاية إلا رواية أحادية تم الترويج لها، بحيث يكون نصيب الحقيقة فيها ضئيلاً جداً، ودائماً ما يكون المرء بحاجة إلى بحث وتدقيق حتى يستطيع استخراجها من بين كل ذلك الركام.
المصطلحات التاريخية هي الأخرى عبارة عن فخ كبير عادة ما ينتهي بك إلى الوهم. فمصطلح كـ«السامية» لا يعود المقصود به مجموعة شعوب وأعراق ذات جذور مشتركة أو واحدة، بل تماهى إلى درجة أنه لا يعنيه من تلك الجذور شيء، فأصبح ذا مدلول مغاير لما هو عليه في الأساس: صهيونية بلا جنسية أو هُوية، عثرت لها على موطن اسمه فلسطين، بعد أن كانت عبارة عن وهم.
كان لا بد هنا من رواية تستطيع استيعاب هذا التحول في مدلول «السامية» من شعوب وقوميات إلى مجرد حركة عنصرية، فكان الاضطهاد، وكانت المحرقة و«الهولوكوست». رواية اعتمدها التاريخ فـي لحظة ما ليجعلوا منها حقيقة مطلقة. هكذا هو الأمر تماماً، وبالتالي فإن مَن يشكك بتلك الرواية فهو يعادي التاريخ ويعادي السامية، بل ويعادي الحقيقة.
أما الغرض من اعتماد تلك الرواية تاريخاً، مع أنها لا تستند إلى أي دليل حقيقي وصادق بقدر ما روج لها اليهود في أوروبا، فهو من أجل تهجير اليهود وتأسيس كيان لهم على أرض فلسطين بعد الحرب العالمية الثانية، وفوق هذا وَصْمُ العالم بعقدة ذنب أبدية.
مدان أنت يا ضمير العالم
يدفع العالم بأكمله ثمن رواية اعتُمدت تاريخياً في لحظة ما، عن اضطهاد على يد الألماني الآري أدولف هتلر. ففي كل عام يُحيي العالم «ذكرى الهولوكوست»، التي حسب زعم التاريخ/ الرواية راح ضحيتها ستة ملايين يهودي قضَوا في الحرب العالمية الثانية على أيدي النازيين والمتعاونين معهم. ولأن تلك الحرب انتهت بشكل رسمي في 15 آب/ أغسطس 1945، فقد أُعلِن ذلك اليوم يوم حداد رسمي في الكيان الصهيوني، وعدد من الدول المتعاطفة، حيث يتم إنزال الأعلام في جميع المؤسسات العامة، وتدوي صفارات الإنذار في جميع مستوطنات/ مغتصبات الكيان لدقائق صمت على أرواحهم، وغيرها من الفعاليات الحزينة.
وحده هذا العدد «الضخم» من البشر المضطهدين على يد النازية، كان له -بفعل الرواية الرائجة التي أصبحت تاريخاً- أن يجعل ضمير العالم مُداناً إلى الدرجة التي لا يستطيع معها التكفير عن جريمة لا يعلم عنها شيئاً. أما مئات الملايين الذين قُتلوا فعلاً على يد النازية أو بسببها في تلك الحرب، فمجرد أرقام يُمَر عليها مرور الكرام. وربما لو كُتِب للنازيين النصر لرأينا روايتهم هي التي تُعتمد تاريخاً، ولرأينا كيف أنهم كانوا منسجمين إلى حد بعيد مع الصهيونية.
ستة ملايين يهودي تم إحراقهم! ليس الحديث هنا عن جهنم ما، يمكن لها أن تستوعب هذا العدد المهول، وإنما عن أفران غاز تم إعدادها كيفما اتفق لحشر كل أولئك «المضطهدين» دينياً أو عرقياً.
وإذا كان اليمنيون منذ عشرات القرون وإلى اليوم يدفعون ثمن رواية اضطهاد النجرانيين وقتلهم حرقاً وإحراق كنائسهم في عهد الملك يوسف (ذو نواس)، هذا والعدد يتراوح من ألفين إلى عشرين ألفاً، بحسب الرواية التي أصبحت تاريخاً هي الأخرى؛ فكيف بستة ملايين؟! لا شك أن على العالم أجمع وبلا استثناء، وإلى الأبد، أن يدفع الثمن، أمماً وشعوباً وأوطاناً وأجيالاً وقوميات... بل وستظل تلك اللعنة تلاحق الجميع دون استثناء. إنه الشعور بالذنب، الذي يكاد يكون عالمياً، إزاء تلك الرواية التي اعتمدها التاريخ وأصبح الجميع يدفعون ثمنها، ربما دون حتى أن يدروا أنهم يدفعون الثمن! من يُقر بها يدفع الثمن، ومن يتبرأ منها يدفع الثمن، ناهيك عمن يشكك بها، فهذا الأخير يدفع الثمن الأكبر!
«الهولوكوست» مصطلح ديني يهودي
التاريخ نسي، مثلاً، كل ضحاياه في الحربين اللتين سميتا عالميتين، والذين كانوا بمئات الملايين، وهو إن جاء على ذكرهم فمن باب الإحصائيات الرقمية لا أكثر. أما عندما يأتي على شيء اسمه «الهولوكوست» فإنه يكون قد توقف تماماً وتحول إلى مناحة، أمام ذلك العدد الزهيد المشكوك فيه أصلاً. وذلك لأن الرواية فقط كان ولا يزال لها الحظ الأوفر من الترويج. إنها الرواية التي استطاعت تحويل الكون بأكمله إلى «هولوكوست»؛ باعتبار أن «الهولوكوست» (Holocaust)، وهي كلمة يونانية، لا تعني مجرد «التدمير حرقاً»، كما تشير الموسوعة البريطانية؛ ولكنها في الأصل مصطلح ديني يهودي يشير إلى «القربان الذي يُضحَّى به للرب ويُحرق حرقاً كاملاً غير منقوص على المذبح».
بالتالي فإن «الهولوكوست» هو المذبح الذي قد لا يكفي العالم بأسره، من بشر وحيوان وشجر وإنس وجن وملائكة وشياطين... أن يكون هو القربان للتكفير أمام الإله «يهوه» عما حدث بحق «أبنائه»، وبالتالي هو مِن السطوة بحيث يصبح التشكيك به أو السخرية منه أمراً فوق احتمال الاحتمال!
إنكار «الهولوكوست» معاداة للسامية
أصبحت «معاداة السامية» هي التهمة التي يجدها كل من يشكك أو ينكر «الهولوكوست» (محرقة اليهود النازية). كما أصبحت سلاحاً سياسياً تستخدمه الحركة الصهيونية لابتزاز العالم وتضخيم إحساسه بعقدة الذنب تجاه اليهود من جانب، وللتغطية على الجرائم التي يمارسها الكيان الصهيوني على العرب من جانب آخر.
وفي ظل هذا التحول، اكتسب مصطلح «معاداة السامية» أبعاداً جديدة، حتى في المعاجم. على سبيل المثال: نجد أن دائرة المعارف العبرية تصف معادة السامية بأنها «أي ظاهرة كراهية لليهود أينما كانوا». كما أن معجم «وبستر» الأمريكي، في طبعته الثالثة الصادرة عام 2002، قد أضاف إلى التعريف المعتاد لمصطلح معادة السامية (وهو «العداء لليهود كأقلية دينية وعرقية») تعريفاً ثانياً يصف المعادي للسامية بأنه «المعارض للصهيونية والمتعاطف مع أعداء دولة إسرائيل».
وعمدت الدوائر الصهيونية إلى احتكار قضية معاداة السامية واستخدامها كسلاح سياسي ضد خصومها. كما وسعت المجال الدلالي لهذا المصطلح بحيث شمل حتى الأديب المسرحي الإنجليزي وليم شكسبير، الذي كتب مسرحية بعنوان «تاجر البندقية».
عقوبة من ينكر الهولوكوست
ألمانيا
في نيسان/ أبريل 1994، أعلنت المحكمة الدستورية الألمانية أن أي محاولة لإنكار حدوث «الهولوكوست» لا تتمتع بحماية حق حرية التعبير التي يمنحها الدستور الألماني، مما دفع البرلمان الألماني أن يضع قانوناً يجَرِّم أي محاولة لإنكار «الهولوكوست»، ويوقع بمرتكب هذه الجريمة عقوبة قدرها السجن خمس سنوات، بصرف النظر عما إذا كان المتحدث يؤمن بما ينكره أم لا.
النمسا
قد يعاقب الإنسان بالسجن إذا أنكر وجود غرف الغاز التي أقامها النازيون أثناء الحرب العالمية الثانية. وفي عام 1992 قامت الحكومة النمساوية بتعديل القانون لتجَرِّم أي محاولة لـ»إنكار أو التخفيف من شأن أو مدح أو تبرير أي من جرائم النازية، سواء بالكلمة المكتوبة أو المذاعة». ويتضمن القانون المعدل السجن لمدة ستة أعوام لكل من ينكر «الهولوكوست».
فرنسا
عام 1990 أقر مجلس الشعب الفرنسي «قانون فابيوس ـ جيسو»، الذي يحظر مجرد مناقشة حقيقة وقوع «الهولوكوست» في الحرب العالمية الثانية. ويجيز القانون الحكم على من يشكك في مسألة استئصال اليهود وإبادتهم، بالسجن لمدة سنة وغرامة تصل إلى 300 ألف فرنك (قبل التعامل باليورو).
سويسرا
مقاطعة دي تور السويسرية منعت كتاب «الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية»، للمفكر روجيه جارودي من التداول، وحكمت محكمة على ناشر عرض الكتاب بالسجن أربعة أشهر.
الولايات المتحدة
في العام 2004، وقع الرئيس الأمريكي جورج بوش (الابن) قانون «تعقب الأعمال المعادية للسامية عالمياً»، وهو القانون الذي صاغه وحشد التأييد اللازم لتمريره في الكونجرس السناتور اليهودي المتطرف توم لانتوس، ألد أعداء العرب والمسلمين. هذا القانون يسمح بوضع لائحة بجميع الأعمال المعادية للسامية في العالم، ولائحة بعمليات الرد الواجبة على هذه الأعمال. تتمثل خطورة هذا القانون في عدد من المسائل، ومنها أنه يشمل العالم بأسره، وليس مواطني الولايات المتحدة كما هو الحال في قانون جايسو الفرنسي أو قانون معاداة السامية في النمسا، وبالتالي تعطي الولايات المتحدة الأمريكية لنفسها الحق في توزيع الاتهامات والعقوبات عبر دول العالم أجمع.
ضحايا عالميون
وصل الإرهاب الفكري، بذريعة معاداة السامية، إلى مستويات غير مسبوقة في أوروبا، وإلى درجة سحب درجة الدكتوراه من باحث ومؤرخ فرنسي يدعى هنري روك، شكك في رسالته العلمية في أن يكون ضحايا «الهولوكوست» قد وصل عددهم إلى ستة ملايين. وهي سابقة أولى في تاريخ البحث العلمي والأكاديمي في فرنسا.
في الثمانينيات، شن الإعلام الموالي لـ»إسرائيل» والصهيونية حملة شعواء على المفكر والفيلسوف الفرنسي روجيه جارودي، وصوره على أنه عنصري ومعادٍ للسامية، فقاطعته صحف بلاده؛ إلا أنه لم يتراجع عن مواقفه، وفي مرحلة هامة من تاريخ الرجل أصدر كتاب «الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية» عام 1995.
شكك جارودي في الرواية الصهيونية لـ»الهولوكوست»، فحكمت عليه محكمة فرنسية عام 1998 بالسجن سنة مع وقف التنفيذ، وغرّمته 120 ألف فرنك فرنسي (50 ألف دولار)، متهمة إياه بالعنصرية، وبإنكار جرائم ضد الإنسانية.
لم يكن جارودي أول من دفع ثمن تشكيكه بـ»الهولوكوست»، ولا أول من اتهموه بمعاداة السامية، فهناك عدد كبير من المؤرخين والباحثين لا يُقِرُّون بتلك الأكاذيب، فدفعوا الثمن هم أيضا.
أما أول من شكك بأسطورة المحرقة وغرفة الغاز النازية فهو الباحث الفرنسي بول راسينيه، وكذلك الأديب الفرنسي لويس فرديناند سالين، الذي ظل يسخر من غرف الغاز المزعومة باستخدامه تعبير «غرفة الغاز السحرية»، وهذان دفعا ثمناً كبيراً، أقله وصمهما بمعاداة السامية!
وتم اعتقال المؤرخ البريطاني ديفيد إيرفينج في النمسا عام 2006 على خلفية أفكاره المناهضة لتلك الأكاذيب اليهودية: «لا توجد أي وثيقة فيما يتعلق بغرف الغاز».
ومن آراء إيرفينج في «الهولوكوست» قوله إن معظم مَن ماتوا في معسكرات الاعتقال النازية لم تتم إبادتهم، وإنما ماتوا بسبب أمراض مختلفة مثل التيفوئيد.
بروفيسور الهندسة الأمريكي آرثر بوتز وضع كتاباً أثبت فيه الاستحالة الهندسية لغرف الغاز. أما عالم الكيمياء الألماني جيرمار رودلف، المسجون حالياً في أمريكا، فقدم دراسة أثبت فيها أن الغاز الذي يفترض أنه استخدم ضد اليهود، والذي يفترض أن تبقى له آثار على مدى قرون في التربة، لم يوجد أثر له قط في معسكرات الاعتقال النازية.
الباحث الفيزيائي الفرنسي روبرت فوريسون، الذي تعرض لأربع محاولات اغتيال، يقول هو أيضا إن «أسطورة غرف الغاز النازية كانت قد ماتت يوم 21/ 2/ 1979 على صفحات جريدة «اللوموند»، عندما كشف 34 مؤرخاً فرنسياً عجزهم عن قبول التحدي بصدد الاستحالة التقنية لهذه المسالخ الكيمائية السخيفة».
يضيف فوريسون: «خلال التاريخ عرفت الإنسانية مائة محرقة حافلة بخسائر رهيبة في الأرواح وكوارث دموية؛ ولكن معاصريها تعودوا أن يتذكروا واحدة فقط: محرقة اليهود، حتى أصبحت كلمة «المحرقة» تخص اليهود فقط، دونما حاجة إلى القول: محرقة اليهود».
وبحسب فوريسون، لم تؤدِّ أي محرقة سابقة إلى دفع تعويضات مادية تشبه تلك التي طلبها ونالها اليهود لقاء كارثة «الشواة» التي يصفونها بأنها فريدة من نوعها وغير مسبوقة، وهو الأمر الذي كان يمكن أن يكون صحيحاً لو كانت عناصرها الثلاثة (الإبادة المزعومة لليهود، غرف الغاز النازية المزعومة، الملايين الستة من الضحايا اليهود المزعومين) حقيقية.
في عام 1991 نظم جنتر ديكيرت، زعيم الحزب الوطني الديمقراطي الألماني، محاضرة استضاف فيها محاضراً أمريكياً قال خلال محاضرته أن قتل اليهود بالغاز لم يحدث مطلقاً. ونتيجة لذلك تم تقديم ديكيرت للمحاكمة وعوقب طبقاً للقانون الذي يحظر أي إثارة للأحقاد بين المجموعات العرقية.
وفي آذار/ مارس 1994 حوكم ديكيرت مرة أخرى وحكم عليه بالسجن لمدة عام واحد مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة خفيفة، مما أدى إلى تعرض القضاة الذين حاكموه لموجة من الغضب والنقد من القضاة الآخرين، بسبب ضآلة العقوبة التي حكموا بها، وقد أدت هذه الانتقادات التي تعرض لها القضاة إلى تدخل المحكمة الفيدرالية التي أبطلت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة مرة أخرى.

.jpg)












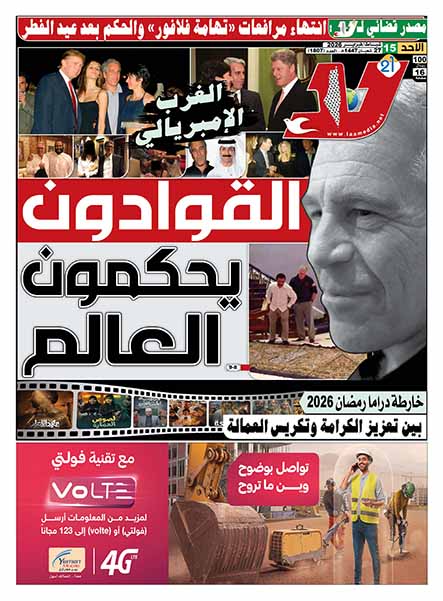
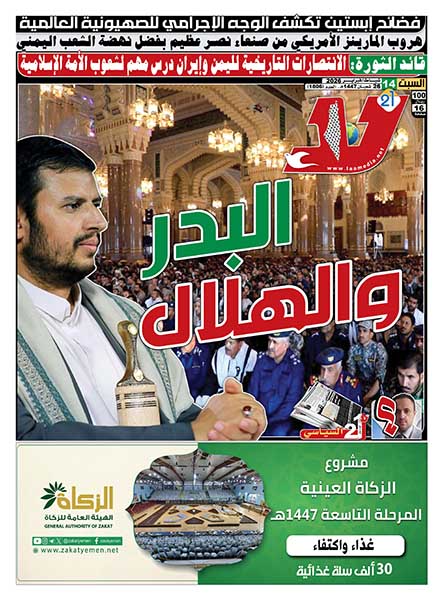


المصدر نشوان دماج / لا ميديا