من «المعلامة» إلى «مغازي الليل» ..البردوني الصغير مجاهد الصريمي:وضع الإعلام كارثي ولو أن سيد الثورة التقى بالجبال لتأثرت
- تم النشر بواسطة صلاح العلي / لا ميديا

بيت شعري لصلاح الدكاك في العدوان يعادل كل ما كتب عنه
الحلقة الأخيرة:حوار صـلاح العلـي-
عرفت مجاهد منذ 3 سنوات، وحسدته كثيراً، على عالمه الخاص، وفلسفته الشخصية عن الحياة والوجود، ومقدار الاهتمام الذي يملكه والعزيمة التي تتفجر داخله، وصلابته أمام قسوة الأيام والمحيط والعقبات المنهكة التي حاولت إعاقته وفشلت بجدارة.. وها أنا أحظى بشرف أول حوار صحفي معه.
في هذا الحوار –الذي أردناه عن حياة مجاهد التي لا يعرفها جمهوره المحب- يحكي لنا مجاهد فصولاً من طفولته وشبابه، متنقلاً بين المأساة والفرح والفقد والحب، عن صراعه مع المحيط الذي حاول أن يكبله خلف قضبان «العمى» الذي لا يتمنى مغادرته إذ صارا صديقين..
يقدم مجاهد شهادته عن حياة عاصرها، هي حقبة حكم دامية عاشها البلد في ظل سلطة البطش والإجرام.. وككل لحظاته، يخوض هنا محاكمة مفتوحة لكل زيف وكذب وقصور وتضليل... إليكم الحوار..
اليوم لكل موهبة ولكل صوت وقود يحركه، ما وقودك أنت الآن؟
بالتأكيد الوضع الراهن، لا أستطيع أن أجد نفسي بمعزل عن المخاض العسير الذي تعيشه بلادنا اليوم.
بماذا تعبر لنا عن علاقتك بالمايكروفون؟
أصبحت أحس به على الرغم من كونه جماداً، وهو يحس بي، وصرت أجد نبضات قلبي هي موجات الأثير التي تصل لكل العالم.
الشعر أبقى من المايكرفون
لو خيرت بين الشعر والمايكروفون.. من تختار؟
الشعر طبعاً.. لأنه المدى الباقي والزاد الذي لا ينتهي، وهو فعلاً من يخلد الإنسان.
البردوني وهو يخاطب أبا تمام، يقول إن الأديب إذا ذوى أو مات هو يولد من جديد عبر شعره.
أما المايكرفون فلطالما وجد إعلاميون كثر، وعندما تركوه أو تقاعدوا، سريعاً ما يتم نسيانهم، وبعضهم مات دون أن يملك حبة أسبرين، ولا أحد يعرف عنهم شيئاً.. البردوني لم يبق إلا شاعرا وليس مذيعاً، وهو لديه فعلياً ما لا يقل عن 5 آلاف حلقة إذاعية، أين هي! أيضاً عبد الملك العيزري الذي ارتبطنا بالعديد من برامجه، وهو صاحب بيان الصعقة، إعلان اغتيال الرئيس الحمدي الذي تلاه وهو يبكي، من يعرف عنه شيئاً اليوم أو عن أسرته التي لا تجد من يطعمها كسرة خبز!
القحوم والليث فرسان الزامل
من يطربك من الفنانين ويحمسك من المزوملين؟
من الفنانين ربما هو ذلك الشخص الذي ارتبط بالحقل وبالمغترب وبالأديب وبالمحب والمرأة ومعاناتها، وارتبط بالجندي، وارتبط باليمنيين عموماً من خلال «رددي أيتها الدنيا نشيدي»؛ أيوب طارش عبسي.
أيضاً، محمد أبو نصار، ليس فناناً فحسب، بل هو الصوت الذي لطالما شدنا إلى مدرسة حاولت الوهابية أن تمحوها من ذاكرتنا، الآل والعترة، وجسدها في أغانيه، ولم نعرف أن الإمام أحمد كان شاعراً إلا منه.
من المزوملين أو المغردين، كان أولهم الشهيد لطف القحوم رحمة الله تغشاه، كان فارس الإنشاد والزوامل اليمني، لأنه قال وفعل.. وبعده وهو لايزال متشحاً سيفه ومطلقاً رمحه في سماء العدوان، الأستاذ عيسى الليث.
بيت من الدكاك يرجح كفة الميزان
ومن الكتاب والأدباء؟
بالطبع الأستاذ البردوني يأتي بالمقدمة.. وبزمننا الحالي، ولو قلت لي أن أقارن كل ما قيل في العدوان مع بيت شعري لصلاح الدكاك لقلت إن هذا البيت رجح كفة الميزان، ولا أقول هذه مجاملة لأنني أقابل مع «لا»، وأنا أقول هذا من قبل وقلته على الهواء وسأقوله اليوم وغداً، وهذا رأيي الشخصي ولا ألزم به أحداً.
بالدرجة الثانية وبالشعر الشعبي بالذات، هو الأستاذ بسام شانع، تجد في شعره العنفوان اليماني والثقافة القرآنية، يتحرك كانعكاس طبيعي للهوية اليمنية.
من بين زملائك الإذاعيين.. الذي يروقك أداؤه وحصافته؟
الأستاذ عبد الله علي الفرح، هو شخص نبيه ومتفحص دقيق وتواق للمعرفة وملاحظ دقيق.
حالة الإعلام الوطني مأساوية
على جانب آخر مجاهد.. بالنسبة للإعلام الوطني، ما الذي ينقصه؟ وما الذي يفترض به أن يفعله؟!
أنت تريد أن تفجر قنبلة، أو تريد أن أحبس! لأن الحالة المأساوية التي يعيشها الإعلام الوطني اليوم كبيرة جداً.. برأيك وبرأي السامعين والقراء والمشاهدين وحتى الجن، هل وجدت من الإعلام الوطني ترجمة واقعية لأي خطاب من خطابات السيد القائد الموجهة للإعلاميين بالذات، أو خطة عمل قائمة على أساس ترجمة عملية لما يجري في الميدان، هل وجد حافز أو باعث إعلامي يشعرك بأن هناك مؤسسة إعلامية وطنية متحملة المسؤولية إلى جانب رجال الرجال في الميدان؟!
وجدنا اليوم في الإعلام الوطني الشللية والمحسوبية، وضحالة الفكر التي لا حد لها، خاصة في المؤسسات الرسمية التابعة لوزارة الإعلام، عندما تتابعها تشعر بالغثيان والصداع لضحالة ما يقدم فيها.. مع احترامي لكل من يحترم ذاته ورسالته.
إننا لم نجد غير (مفسبكين) مخصصين للحملات الإعلامية ضد هذا وذاك في الداخل.. قبل فترة قريبة حظوا بلقاء سيد الثورة، هل ترجموا الصورة التي وضعهم فيها؟
والله لو قدر لسيد الثورة أن يلتقي بالجبال لغير فيها ولاستجابت له.
بالله عليك، مثلاً إذا افتتحت إذاعة لمواجهة العدوان، نجد أن هناك إذاعة مقابلة تفتتح لمسخ مواجهة العدوان! أين وزارة الإعلام مما يجري اليوم على الساحة الإعلامية!
أين مكمن الخلل برأيك؟
عندما يسند العمل لغير أهله... وعلى رأي المثل «من أكل بالثنتين اختنق»!
على المعنيين أن يتقوا الله في عملهم، ويوكلوا المهام إلى أهلها، وأن تتواصل الرقابة والمتابعة للإنجازات والمحاسبة... على المعني ألا يوزع نفسه في نفوس كثيرة. عليهم أن يطلقوا العنان للناس في أن يفكروا بما يجب أن يقال، لا أن يفكر لهم غيرهم..
يجب أن يكون هناك مؤتمر إعلامي شامل ومرجعية قوية للإعلام من الأكفاء والموثوقين، وليس المتسلقين الذي سريعاً ما نجدهم فارين إلى الرياض! مؤتمر يناقش القضايا الوطنية والاجتماعية وما يجب أن يفعل ويكون في حالة انعقاد وتقييم دائم.
اتحاد الإعلاميين بلا جدوى
في هذا السياق، ما تقييمك لاتحاد الإعلاميين؟ وما الذي أنجزه برأيك؟
لم ينجز شيئاً للأسف، عولنا عليه أن يكون بديلاً ثورياً، ولا جدوى، حتى إننا لم نجد تضامناً منهم مع مظلومية يتعرض لها أي زميل! أنا وجدت مزاحمات واختراع أسماء لا أكثر، ولم أجد بصمة لهم.
الفارس الذي يداهم الوقت!
العمى والمذياع والأم والخيال.. البردوني يبعث مجدداً
صلاح العلي
لو أن لي من حسنة اكتسبتها من مغادرتي عملي الصحفي ذات يوم، فستكون تعرفي بالضرير الجالس في زاوية الغرفة..
شاب يضع نظارة سوداء، متلهف لبدء مشواره يترقب ويقيس المحيط، يتلمس فيهم الموافقة أم لا.
كعادته غريب أينما حلّ، أو ربما الموجودات حوله غريبة ووجوده يظهر نشازها... سمع "مجاهد" صوتاً يحدثه من طرف الغرفة ففز كطريدة، من الفرح مدركاً أنه صوت أستاذه القديم، ويمد يده في المسار الذي قدم منه ذلك السرور الكاسر عن "صاحب النظارة السوداء" شعوره بالغربة والوحدة وخوف يدق قلبه برفض آخر عقيم لا سبب له.. شيء من الطمأنينة تُرَبِّتُ على فؤاد "مجاهد" بأن أحداً سيكون إلى جانبه ويدعمه ليقبل بتجربة أداء كمذيع.
كنت أتابع بصمت غريب حركات زميلي الكفيف وانتشاءه وهو يتحدث ويسرد تفاصيل وقصصاً ومواقف قضايا... ويقول شعراً ويقترح أعمالاً...
وللأسف، وأنا أرى تخمة التوظيف في تلك التي عملنا فيها، رأيت "مجاهد" وصديقه الكفيف الذي قدم معه عبئاً آخر يضاف إلى كاهل العمل. تحاشيت في اليوم الأول أن نكلف أنا وهو بتقديم الفترة المباشرة المسائية معاً، إثر هاجس أننا لن نتمكن من إدارة الحديث لسبب أن زميلي لا يرى! لكنه سريعاً ما بدد ذلك الهاجس.
ومنذ اليوم الأول ارتجز مجاهداً فارساً يجتاح الأثير ويبدد رتابته، فتفتح له القلوب والآذان والأفئدة، ويبدأ الهاتف بالرنين تتالياً للمداخلة مع المذيع... يلقي بالكلمات حمماً فوق رؤوس العدا فتفر "كأنها حمر مستنفرة، فرَّت من قسورة"، ويرد على التساؤلات والأطروحات كفيلسوف ستيني متشبع بالحكمة والتجربة، لا عشريني كانت الحياة عاثرة معه وحجرة عثرة في طريقه الطويل الذي لم يحد عنه ويقبل مغادرته.
لست البردوني، والآخرون أيضاً، بتلك القدرات العبقرية حين كان مديراً لإذاعة صنعاء يقيم قدرات الأشخاص ويعرف أهليتهم من عدمها.. كنا جميعاً متعلمين وحديثين على العمل الإذاعي، غير أننا كنا نرى في العدسات السوداء، لا خلفها وإلى صاحبها.
ولو أن "مجاهد" استسلم لسطحيتنا تلك وغادر، لكان الإعلام الوطني قد خسر كثيراً، سيخسر بردونياً آخر. ولكان الذين انطلقوا إلى الميدان مقاتلين، تفاعلاً مع برنامجه، لايزالون في منازلهم. لكنه رأى واجبه أن يعلم الجميع درساً لكيف يرون من حولهم وماذا يرون. ولو أن كل إعلاميينا بقدر إيمانه ويقظته ومسؤوليته وهمته، لكان حال الوطن اليوم مختلفاً كثيراً جداً.
والحقيقة أننا جميعاً نرى، لكن "مجاهد" يُبصر.
عرفت "مجاهد" مثابراً مداهماً للوقت لا العكس.. يعكف على هاتفه السمعي يقلب فيه صفحات الكون، ويطالع فيه كل منحى.. ثم يأتي الوقت ليختلي بآلة (بريكنز) الجديدة الخاصة بطباعة البريل (أحرف خاصة للمكفوفين) يمحور فيها أفكاره ونقاط حديثه التي سيتكلم بها مع جمهوره. لقد جعل من ضوضائها سيمفونية يعزفها كل مساء على وقع أسماع متلهفة أدمنت نبرته وحديثه.
وليس هناك لعنة ستلحق بشخص كتلك التي أغرقت اللص حين طاوعته يداه أن يسرق آلة الكتابة الغالية الثمن. أتذكر ملامح مجاهد حينها، إن ذلك الحزن يوازي فقدانك طفلاً ملأت خيالك مشاهدات لمستقبله وأحببته بكل ما فيك.. كان مجاهد أباً سرق منه طفله فاحترق كبده تألماً عليه.
كان من حظ البردوني أن لم يكن في بيته عدا علبة كبريت لتسرق، لكن "مجاهد" سُرقت منه يداه وعيناه.
وحدث أن تعرض بعدها هذا المكلوم للسرقة حين كان يجهز منزله للزواج، ليتفاجأ أن عدة أجزاء من غرفة نومه اختفت أثناء النقل، وحين حكى لي كان يضحك! فليس كل شيء عزيزاً، والأشياء التي تكون عزيزة على المرء فإنها تكون نادرة.
ناقشوا "مجاهد" في الشعر أو السياسة أو التاريخ أو الحروب أو الفنون والأدب، ستجدوه مليئاً كجوجل وأكثر، واطلبوا رأيه في قضية تعيشها البلاد، يخبركم رأيه بكل جرأة، ولن تجدوا مثل جرأته وصراحته.
لقد كانت الحياة أعجز من أن تمنع "مجاهد" برغم فقدان بصره من النشاط على مواقع التواصل الاجتماعي, ففي فيسبوك وتويتر وواتس آب وماسنجر وغيرها، تجده حاضراً للدرجة التي تجعلك لا تصدق أن الرجل فاقد البصر!
درس مجاهد اللغة العربية في جامعة صنعاء. لم تمنعه المسافة الواقعة بين سكنه في "الصافية" وبين الجامعة القديمة في شارع الدائري، من رحلة شبه يومية على الأقدام لعدم امتلاكه أجرة الباص. يمسك برفيقه الكفيف هو الآخر مقوده العصا وذاكرته الفولاذية، مع تقبله برحابة صدر الأضرار الجانبية الناجمة عن الرحلة مشياً على الأقدام وسط الشوارع المزدحمة وتقاطعاتها وجنون المركبات والدراجات النارية.
ومنذ زمن طويل توقف صديقي "مجاهد" عن العتاب للآخرين لخذلانهم إياه. وثابر لأخذ زمام الحياة بيديه، يرى بقلبه لا بعينيه، ويؤكد أنه على دين "استفتِ قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك".
إن "لا" هي كلمة باهظة الثمن والكلفة، خاصة لمن هم بحال مجاهد الصريمي، بيد أنها ضريبة أحب دفعها لأنه أحب طريقه الذي يشمخ فيه برأسه عالياً ويعلو فوق كل زيف وظلامية. ومنذ طفولته لم تتوقف الضريبة عن قرع بابه..
ومن المؤكد أن "مجاهد" بمقدوره أن يوظف ما لديه من ملكات للتكسب الشخصي، وله القدرة أن يبيع لسانه وعقله، ولم يكن الحال ذاته سيبقى، لكنه اشترى نفسه وفضل كبرياءه وشموخه وكدحه حتى الوصول أمام كل المغريات التي لن تعفّه من المساس بذاته الإنسانية، والحال ذاته مع عمله الحالي، إذ بمقدور "مجاهد"، ويحق له ذلك، أن يهتم ببرنامجه المسائي وحسب، وهو مجهود جبار ورسالة كاملة، لكنه يرفض إلا المشاركة بمهام أخرى ككتابة حلقات برنامج "سفينة النجاة"، وغيرها من الأعمال..
لذا كان فارساً لا يترجل عن الركب الذي اختاره ورهن نفسه وحياته به. وهنا امتلك ذاتاً نبيلة وإنسانية عالية الرقي وابتسامة خجولة لا تعرف نفاقاً. لقد امتلك ذاتاً لم تستطع مفسدات الدنيا أن تخدش عفتها وحياءها المذهلين.
إن هذه الأصوات العالية التي لا تخمد شعلتها هي الأصوات الخالدة التي لا تموت... ومجاهد الصريمي هو برودني آخر تخلد فينا.

.jpg)












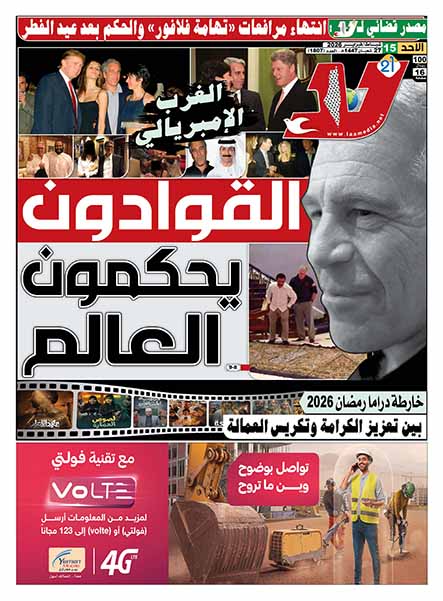
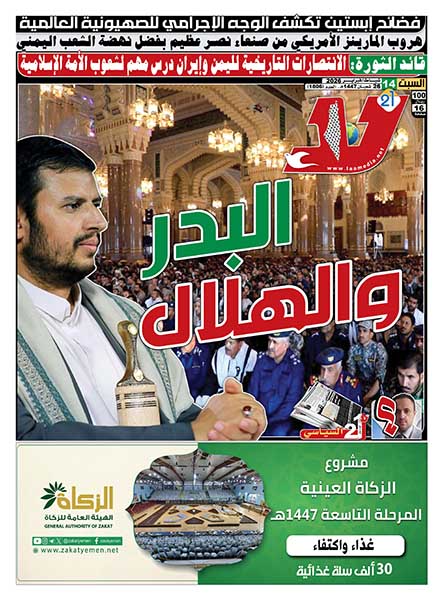


المصدر صلاح العلي / لا ميديا