ربيع اليمن وأزمة الدولة بين خيارين:ثورة شعبية أم دولة فاشلة؟
- عبدالملك العجري الأحد , 13 فـبـرايـر , 2022 الساعة 6:32:43 PM
- 0 تعليقات

عبدالملك العجـري / لا ميديا -
كانت اليمن ثالث دولة عربية بعد تونس ومصر اكتسحتها موجة ما سمي حينها بالربيع العربي. وفيما عدا هذا القاسم المشترك اتخذت اليمن مساراً مختلفاً، في مصر وتونس قادت الدولة الحوكمة الوطنية وتولى الجيش الإشراف على سير العملية الانتقالية والإصلاحات الدستورية والديمقراطية لمؤسسات الدولة، في حين كان الأمر مختلفاً تماماً في اليمن، دخل المجتمع الدولي والإقليمي بقوة على مسار الأحداث، وكان دورهم حاسماً في ضبط مسار ونتائج الأحداث وتصميم نموذج الانتقال من خلال «المبادرة الخليجية» والتوجيه المفاهيمي والنظري لمؤتمر الحوار والإشراف على المرحلة الانتقالية، وإبقاء القضية اليمنية قيد النظر الدولي.
ورغم إصرار المتظاهرين في الساحات على توصيف أحداث فبراير بالثورة الشعبية نظير ما حدث في تونس ومصر، إلا أن مقاربة المجتمع الدولي لليمن على حد ياسين سعيد «أنه بلد أخذ يشكل خطراً على نفسه وعلى أمن الإقليم والمجتمع الدولي»، دولة هشة ونظام منقسم على نفسه وتنذر المواجهات المحتملة بين طرفي النظام بانهيار الدولة ما يستدعي التدخل الخارجي لإرساء الاستقرار على نحو ملح، وعلى حد وثيقة مخرجات الحوار الوطني.
«عندما أصبح الوضع السياسي عام 2011 ينذر بحرب أهلية لم يكن تأثيرها ليقتصر على اليمن فقط، بل قد يمتد للتأثير على دول الجوار وعلى أمن خطوط الملاحة البحرية، وجد المخلصون من أبناء اليمن ومكوناته أنفسهم ومعهم المجتمع الدولي عموماً والخليج خصوصاً أمام مسؤولية تاريخية وإنسانية تقتضي التدخل السريع لاتخاذ مخرج وحل سياسي ينزع فتيل المواجهة ورسم خارطة طريق للانتقال السلمي عبر المبادرة الخليجية 3 أبريل 2011م».
في مرافعة ياسين سعيد عن الثورة والمبادرة أشار إلى أن الانقسام الرأسي للنظام سهل لـ»صالح» تجييره لصالحه في تصوير الوضع على أنه صراع داخلي، لكن الأخطر من ذلك أن الانقسام الرأسي للنظام أفرز انقساماً رأسياً للمجتمع أيضاً، ذلك أن أي ثورة تحدث عادة نتيجة للتناقض الشديد بين مصالح الطبقة المسيطرة وبين بقية فئات الشعب المسحوقة ذات المصلحة. وثورة فبراير فـي بدايتها كانت تعبيراً عن هذا التناقض، لكن عندما تحولت ساحة الجامعة من منصة لثورة الشعب إلى منصة لإعادة تصدير رجالات العهد القديم المنشقين عن صالح من قيادات الإصلاح والجنرال علي محسن وأسرة آل الأحمر، فإنها كفت عن كونها ثورة وطغى عليها الوجه الحزبي، لاسيما أن الفصيل المنشق عن نظام صالح يتشابه مع هذا النظام لحد التطابق فـي خصائصهما ومصالحهما الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وتخلي المتظاهرين عن استقلاليتهم وتمسك جماهير الأحزاب في الساحات بقياداتها دفع الأحزاب الأخرى إلى التمسك بقياداتها، ودفع جماهير المؤتمر المسحوقة التي لا يختلف وضعها عن وضع معظم فئات الشعب اليمني إلى التمسك بقياداتها، وربما لو حافظ الشباب في الساحات على استقلالهم وواصلوا مطالبهم لما استطاع صالح أن يتمادى في استخدام القوة، وربما كان التنازل لصالح ثوة شعبية أسهل على صالح ونظامه من التنازل لصالح شركائه المنشقين عنه.
في النهاية كانت مقاربة المجتمع الدولي والإقليمي هي التي حكمت المرحلة الانتقالية، والخيار الذي فرضه الرعاة الإقليميون الدوليون على النخب السياسية في السلطة والمعارضة، وكل ما في الأمر أن تقديم المشترك نفسه معبراً عن الثورة سهل للمجتمع الدولي والإقليمي إيجاد طرف للإمساك به لاحتواء وتكييف الثورة وضبط حدود التغيير، بما يخدم مصالحهما الاستراتيجية، وفي نفس الوقت إظهار الاستجابة لتطلعات الشعب بالانتقال السلمي للسلطة، فاليمن أصبح لديه زعيم جديد الذي هو مطلب اللقاء المشترك لا سيما الإصلاح وآل الأحمر.
لا نريد هنا أن ندخل في سرد مسار أحداث وقائع العملية الانتقالية أو محاكمة أهداف المتظاهرين بقدر ما نريد استكشاف أهم المفاهيم والتدابير التي يستعين بها المجتمع الدولي لإعادة بناء الدول الفاشلة في ضوء قدرتها على معالجة أزمة الدولة اليمنية، وحتى تتضح الصورة من المهم أن نلقى نظرة سريعة على خلفية الدولة الفاشلة كمفهوم دولي وتقييم الأساليب والأدوات التي يعتمدها لإعادة بناء الدولة الفاشلة.
* * *
يعد مفهوم الدولة الفاشلة من أهم المفاهيم الاستراتيجية التي توجه السياسة الخارجية للولايات المتحدة والمجتمع الدولي بداية من التسعينيات مع نهاية الحرب الباردة، إذ اعتبرت الدولة الفاشلة أو الهشة خطراً يهدد الاستقرار والأمن الدوليين.
تُعرف الدولة الفاشلة أو الهشة بأنها تلك التي تعاني من عجز في القيام بوظائفها في رعاية وحماية مواطنيها ومسؤولياتها السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وعجز الطبقة السياسية عن مشاكلها لوحدها والخروج من دورة الفشل من دون تدخّلات خارجية مكثّفة.
ارتبط ظهور مفهوم الدولة الفاشلة، بالتغيّر الحاصل في هيكليّة النظام الدولي بعد انتهاء الحرب الباردة، وإثر الفراغ الذي تركه سقوط الاتحاد السوفييتي على انهيار الدولة في عدة مناطق من العالم والتهديدات المرتبطة بها، والانتهاكات الخطيرة التي تسببت فيها لحقوق الإنسان في الصومال وهايتي وكمبوديا والبوسنة وكوسوفو، إضافة لبروز الولايات المتحدة الأمريكية الدولة القائدة للنظام العالمي، واعتمادها رؤية استراتيجية جديدة لإعادة هندسة النظام الدولي.
وجاءت أحداث 11 سبتمبر 2001م لتعد المسرح لأجندة مختلفة تتصل بتهديدات أمنية جديدة زاد من الاهتمام العالمي بمخاطر الدول الفاشلة وراج توجه سياسي وأكاديمي يربط بين ظاهرتي الدول الفاشلة والأنظمة السلطوية وانتشار الإرهاب والهجرة، والفقر، ودعا إلى دمج سياسة التدخل الخارجي لإعادة بناء الدولة الفاشلة على جدول الأعمال الدولية، وتطوعت الولايات المتحدة لحمل هذه المهمة، وفرض الديمقراطية كاستراتيجية لمحاربة الاستبداد والإرهاب بحجة منع تحول هذه الدول لملاذات آمنة للإرهاب الدولي، وتهريب السلاح، وتدفق المهاجرين وغيرها من المخاطر باعتبارها شرطاً أساسياً لتوفير الأمن العالمي.
وساعد التحول الديمقراطي السهل والسريع لدول أوروبا الشرقية -بمساعدة الولايات المتحدة والغرب الرأسمالي- وارتفاع عدد الدول التي تتبنى النظام الديمقراطي وأعداد الناس الذين يعيشون في ظل نظام ديمقراطي وتوسع الالتزام العالمي باقتصاد السوق الحر، على انتشار روح تفاؤلية تقدم الديمقراطية الليبرالية كحل سحري لكل المشاكل، وأنها يمكن أن تنتشر في أماكن وفي أي ظروف بنفس المرونة (سنعرج لاحقا على أسباب سهولة انتشارها في أوروبا الشرقية)، ومن ثم أصبح جوهر عملية إعادة بناء الدولة يركز على قضايا التحول الديمقراطي الليبرالي وحقوق الإنسان والمشاركة والإصلاح السياسي والاقتصادي.
تتألف الاستجابة الدولية لمواجهة مخاطر الدولة الفاشلة من أدوات سياسية ودبلوماسية وتنموية واقتصادية وأمنية وعسكرية حسب درجة المخاطر لإعادة بناء الدولة الفاشلة أو الضعيفة، فقد تكون مباشرة تنطوي في أغلب الأحيان على عمليات قسرية أو عسكرية كما حصل في العراق وأفغانستان، أو عن طريق الإشراف الأممي أو الإقليمي على الحوكمة الوطنية، أو غير مباشرة مثل قرارات مجلس الأمن وممارسة الضغوط السياسية والعقوبات الاقتصادية وأدوات الهيمنة الناعمة لتطويع الدولة المستهدفة، إضافة لجعلها ركيزة أساسية في عمل المؤسسات الاقتصادية الدولية كالبنك وصندوق النقد الدوليين اللذين أصبح على عاتقهما -على حد الدكتور الأفندي- التأثير في السياسات الاقتصادية للدول في الاتجاه الذي يرسخ نظام الحرية الاقتصادية وإطلاق المبادرات الخاصة، وعلى المستوى الرسمي سعت الإدارات الأمريكية ومجتمع المانحين إلى ربط عونها ودعمها الاقتصادي لدول العالم الثالث بإجراء إصلاحات اقتصادية جذرية.
لكن حصاد ثلاثة عقود من التدخل لبناء الدول الفاشلة أو المتهمة بالفشل الذي حملت لواءه الولايات المتحدة جاء مخيباً لكل التوقعات، ومثل الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وسيطرة «طالبان» بعد عشرين عاماً من الجهود الأمريكية بحجة بناء دولة ديمقراطية في أفغانستان، قمة الانكشاف، ولا يختلف الوضع في العراق (اليمن كما سيأتي يقدم شاهداً إضافياً على فشل الحوكمة التي يهندسها ويشرف عليها الخارج)، وبحسب العديد من المراقبين أدت هذه التدخلات إلى إجهاض قدرة المجتمعات والنخب الوطنية على ابتكار الحلول الوطنية وإجهاض التطور الطبيعي للدولة، وبدلاً من دعم قدرات الدول الضعيفة والتكامل معها طغى عليها وحشرها خارج عملية البناء، أي حين يجري أداء وظائف الدولة فإن القدرة الأهلية لا تتزايد، على حد عبارة الخبير الأمريكي فوكوياما.
التدخل الدولي في تعامله مع الدول الفاشلة مثل الطبيب الذي يقدم ذات الوصفة لكل مرضاه ولكل الأمراض، وكما لا يتوقع تماثل أي منهم للشفاء كذلك التدخل الدولي يقدم مصفوفة معالجات جاهزة وموحدة لكل البلدان المعنية في كل مكان وتحت أي ظروف وشروط، لذلك لا نجد دولة واحدة نجحت، وفشلت اقتصاديات السوق والسياسات الاقتصادية المشروطة للدول المانحة ووصفات البنك والصندوق الدوليين (التكيّف الهيكلي) في تحقيق الأحلام الوردية التي قطعتها لدول ما بعد الاشتراكية، وكان الاعتقاد أن هذه الإصلاحات (الخصخصة ورفع الدعم وزيادة الضرائب) كفيلة لوحدها بتحقيق النموّ والتطوّر والقضاء على الفقر. وجاءت نتائجها مغايرة، فتحرير التجارة والتوسع في الانفتاح الاقتصادي -على حد عدد من الدارسين- كانت إحدى آليات إنتاج الفقر على نطاق واسع، لأن البيئة الاقتصادية العربية لا تمتلك الشروط الضرورية للكفاءة الإنتاجية والتنافسية، وهو ما أدى إلى زيادة نسبة البطالة وإلى تكريس التخلف والتبعية وتدمير الرعاية الاجتماعيّة، وإثراء النُخَب، والتمييز الطبقي، وتنظيم المجتمع على مبادئ الربح والجشع، لا على مبادئ خدمة الحاجات الإنسانيّة. وباعتراف ميلتون فريدمان عميد اقتصاد السوق الحر عام 2001م قال في العقد السابق «كان لدي ثلاث كلمات أقولها للدولة المتحولة من الاشتراكية، وهي خصخص خصخص خصخص، لكني أخطأت بعد أن تبين لي أن حكم القانون ربما أكثر محورية من الخصخصة» انظر (ص66، بناء الدولة).
خلاصة خطة التدخل الدولي لإعادة بناء الدول الفاشلة وتحويلها لدول ديمقراطية تبدأ بفرض إجراء مصفوفة من التعديلات الهيكلية والدستورية تسمح بوجود شكل من التعددية والانتخابات غالباً ما تكون شكلية، والالتزام بالوصايا العشر للبنك والصندوق الدوليين، ومنظمة التجارة العالمية تقدم شروط الاعتماد في نظام السوق العالمية، وباعتبار الولايات المتحدة هي الراعي العالمي لنظام العولمة تتولى السفارة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي توزيع صكوك القبول وخلع الألقاب الديمقراطية على القوى والأحزاب التي تسمع الكلام، وصكوك الحرمان الديمقراطي على الأحزاب والقوى والدول الخارجة على إرادة راعي النظام العالمي مهما كانت شعبيتها وحجم تأييدها الشعبي، وتضع القيود وتفرض العقوبات على من يحاول الخروج عن الوصايا العشر للبنك الدولي ومجتمع المانحين أو يخفق في محاكاة القيم الغربية كقيم كونية، وبجانب السفارات تقوم منظمات المجتمع المدني الغربية بتدريب النخب السياسية والمدنية كيف يكونون ليبراليين لائقين، ونظراً لعدم وجود تعريف محدد للدولة الفاشلة معترف به دولياً «فمثله مثل الدول المارقة ومحور الشر ورعاية الإرهاب وحقوق الإنسان.. إلخ» يتم تسييسه وتكييفه لخدمة مصالحها أو استخدامه مبرّراً لاجتياح بلدان معينة.
ويكفي أن تخفق دولة ما في محاكاة السلوك المتوقع منها من قبل ما يسمى «العالم الحر» ليقصفوها بالدعاية الإعلامية السوداء وتشويه صورتها محلياً وعالمياً وإخافة قطاع المال والاستثمار منها، ويمطروها بأصناف العقوبات السياسية والاقتصادية، وانتهاك سيادة الدول دون وجود قيود قانونية دولية واضحة على سياسة التدخل، إذ يكفي أن يراود دولة من الدول القوية بعض مشاعر القلق من الدول الأضعف في جوارها أو حيث مصالحها لتبرير التدخل الاستباقي عسكرياً وغير عسكري، وعلى حد فوكوياما «واجب الغرب التدخل ونزع السيادة عن الدول الضعيفة وتولي حكمها نيابة عن المجتمع الدولي ضمن مفهوم جديد للسيادة المشتركة».
وغير ذلك يكون الهدف الأساسي للتدابير التي يتخذها تحقيق المصالح الاستراتيجية للدول الكبرى والنافذة أكثر من تركيزه على المشاكل الداخلية، كما يتم إغفال دور السياقات الخارجية في إفشال الدول النامية، وتأثير الطبيعة الاجتياحية والمتوحشة لنظام العولمة في توسع رقعة الاضطرابات الاجتماعية، وغياب العدالة والتكافؤ بين دول الغرب الغنية ودول الجنوب الفقيرة، والارتفاع الدراماتيكي لديون دول البلدان النامية، وانتهاك سيادتها وتهديدها بالتفكيك، وصعود ظاهرة الإرهاب المعولم.
النتيجة التي يمكن استخلاصها من كل هذه التجارب كما يقول مؤلف كتاب «انتقام الجغرافيا» بأن موروث الجغرافيا والتاريخ والثقافة تفرض حدودا لما يمكن تحقيقه في مكان بعينه.. وأن المقدر للعالم أن تحكمه أنواع مختلفة من الأنظمة «وأن الطريقة الأسلم أن يترك للشعوب فرصة التطور بقدراتها وخصائصها الذاتية، وأن تصل إلى الديمقراطية بطريقتها الخاصة وفي وقتها المحدد، وأن يترك لها أن تتعلم من الغرب ما يحتاجه وما هو مستعد له والانفتاح على تجارب بلدان شرق آسيا الناجحة ومؤسساتها الإقليمية التي توفر تنمية أكثر عدلاً، بدلاً من فرض القيم الغربية والوصايا العشر للبنك ومنظمة التجارة على الشعوب كقيم عالمية، وبعبارة أخرى نعم للتحديث ولا للتدخل.
ربيع اليمن: أزمة الدولة ونظرية «اليمن الخطر»
تصنيف اليمن كدولة مهددة بالفشل لم يبدأ في 2011م وأحداث الربيع العربي، وإن دخل معها مرحلة جديدة، فالتحذيرات الأمريكية والبريطانية من فشل الدولة بدأت في مرحلة أبكر، ومنذ 2007م وفي 2009م تكررت الدعوات للحكومة اليمنية بضرورة التفكير بجدية في التحول نحو الديمقراطية الحقيقية وإجراء إصلاحات إدارية واقتصادية وإلا فإن اليمن في طريقها نحو الفشل.
وهي التصريحات التي كانت تتلقفها المعارضة آنذاك لإدانة نظام صالح دون إدراك لتداعيات الاستقواء بالخارج، السياسة التي طبعت أداء النخب السياسية في السلطة والمعارضة، على سلب اليمن حقوقه السيادية وفقدانه السيطرة على قراره الوطني من دون أن توصله إلى برّ الأمان، وما حصل في 2011 شاهد إضافي، فاليمن منذ السبعينيات كانت قيد النظر السعودي، وبموجب قرار مجلس الأمن (2014/2011م) انتقلت لتصبح قيد النظر الدولي الذي بدوره أعاد تفويض الخليج والسعودية بالإشراف على تنفيذ الانتقال السياسي، أي أن التفويض السعودي في اليمن -هذه المرة- أصبح مسنوداً بغطاء دولي وإقليمي.
لن ندخل في مناقشة مبررات تصنيف اليمن دولة فاشلة باعتبارها المقاربة التي حكمت المرحلة الانتقالية إنما مدخلاً مفتاحياً لفهم وتفسير مسار الأحداث بعد 2011م ومعرفية خلفية وآليات ووسائل المجتمع الدولي لمساعدة الدول الهشة في تصميم «المبادرة الخليجية» والمرحلة الانتقالية عموماً، ومدى نجاعتها وكفايتها لمعالجة الأزمة لإعادة بناء قدرة الدولة على أداء وظائفها أم أنها كانت تدفعها نحو المزيد من الفشل والانهيار.
دوافع التدخل الدولي والإقليمي
التدخل الإقليمي والدولي في اليمن لم يكن لأهداف إنسانية أو لحماية الشعب اليمني أو لإحداث تغيير حقيقي يلبي مطالب الثورة والشعب اليمني بقدر ما هو القلق المزعوم من «اليمن الخطر»، وتأثير انهيار الدولة في اليمن على المصالح الأمريكية وتحول اليمن لملاذ آمن للإرهاب، والقلق من إمكانية صعود طبقة سياسية جديدة غير متحمسة أو متفاعلة مع أولويات الاستراتيجية الأمنية الأمريكية في اليمن أو مع استمرار إشرافها على إعادة هيكلة الجيش والأمن في الاتجاه الذي يضمن استمرار الحرب على الإرهاب كعقيدة قتالية للجيش اليمني ومؤسساته الأمنية، على حد الدكتور محمد الأفندي، والاحتفاظ به مدخلاً للنفوذ في توجيه الجيش اليمني.
من جهة أخرى، السعودية منذ نشأتها تنظر لليمن مصدر خطر وقلق دائمين، فالجوار والشريط الحدودي الطويل بين البلدين قد يجعل من اليمن مصدر تهديد لأمن السعودية لاسيما مع رداءة وعدم جاهزية القوات البحرية وحرس الحدود اليمنية، كما تنظر لليمن ساحة نفوذ لا غنى عنها للحفاظ على التوازن الإقليمي وتخشى من تأثير التغيير في اليمن على التوازن الإقليمي لاسيما تجاه النفوذ الإيراني والتركي. وغير ذلك يرى كثير من المراقبين أن بناء دولة قوية أو ديمقراطية لم يكن من الأهداف المرغوبة للسعودية الراعي الحقيقي للمبادرة.
كما يمثل باب المندب مضيقاً مهماً للمصالح الدولية ما يجعله يولى أهمية لاستقرار المنطقة التي تعاني أصلاً من وجود دولة فاشلة وهي الصومال، إضافة للجزر اليمنية الاستراتيجية في طريق الملاحة والمهمة في الحرب الدولية على الإرهاب.
الدافع الثاني: عدم ثقة الأطراف الدولية والإقليمية وبشكل أكثر تحديداً السعودية والولايات المتحدة بقدرة النخب اليمنية التقليدية في السلطة والمعارضة على إدارة مهام المرحلة الانتقالية دون مساعدة وإشراف مباشر من المجتمع الدولي والخليج والسعودية تحديداً، وانعدام ثقة السعودية بالنخبة السياسية اليمنية ليس بالأمر الجديد وتراودها شكوك مزمنة من التوجهات السياسية للنخب اليمنية، وزاد استقدام القوات المصرية في ثورة 26 سبتمبر ثم تحول اليمن الجنوبية للنظام الاشتراكي لاستحكام هذا الهواجس لدى حكام الرياض واستقر في قناعتها أنها إن لم تضع اليمن قيد نظرها فسيذهب إلى حيث لا ترغب.
لذلك كان أحد أهم أهداف «المبادرة الخليجية» ضمان استمرار اليمن ضمن المعادلة الإقليمية والدولية سواء المتعلقة بمكافحة الإرهاب وفقاً للمنظور الأمريكي، أو استمرار احتفاظ السعودية بدور اللاعب الأساسي في المشهد السياسي اليمني وتمكينها من محاربة ما يسمى النفوذ الإيراني والإخواني أو التركي في اليمن، وتعمدت المبادرة تجاهل تبعات هذه السياسات التي كانت مسؤولة إلى حد كبير عن هشاشة وضعف الدولة اليمنية وتحديد مسار السياسة الداخلية اليمنية.
نظرية «اليمن الخطر» وأثرها على الدولة
إن النظرة الإقليمية والدولية لليمن مصدراً للخطر والتهديد مثلت بحد ذاتها مصدر تهديد لليمن والدولة اليمنية، وأنتجت متوالية من السياسات والتدخلات السافرة في الشأن اليمني أضعفت السلطة المركزية للدولة اليمنية وأوصلت اليمن إلى الفشل.
منذ الستينيات كانت السعودية تنظر لليمن مصدر خطر عليها مرة بحجة المد الناصري وأخرى المد الشيوعي وثالثة المد الشيعي وحيناً المد التركي، لم تكن مقاربة الرياض جيوسياسية فحسب وإنما مقاربة أيديولوجية تتعدى استحقاقات الجغرافيا وقيم الجوار المعتادة، جوهرها «أن يبقى اليمن ضعيفاً بما لا يشكل تهديداً للمملكة، وقوياً بما لا يشكل تهديداً لها أيضاً» (وهو المبدأ الذي صيغت على أساسه المبادرة الخليجية)، وخلال الخمسة عقود الماضية، لم تكن تتعامل مع اليمن من باب مؤسسات الدولة، بل من نافذة مراكز القوى خارجها من خلال ما يُعرف تقليديا بـ»اللجنة الخاصة»، والتأثير على القرار السياسي عبر التزكيات والتعيينات لتولي مناصب معينة في الحكومة والمؤسسات اليمنية، إضافة للجمعيات الخيرية ودعم الجماعات السلفية والإغاثية وغيرها من الوسائل الناعمة ذات الفعالية الكبيرة التي خدمت السعودية في التغلغل في الساحة اليمنية بمعزل عن الحكومة اليمنية. «نظرية الدولة الضعيفة» التي استندت لها السياسة السعودية، وإن ساعدتها في التفرد باليمن لعقود، إلا أنها أسهمت في إضعاف الدولة وتآكل شرعيتها وسلطتها.
بعد أحداث 11 سبتمبر أصبح اليمن مصدر قلق للولايات المتحدة بحجة الإرهاب والخشية على الديمقراطية، وبصرف النظر عن أهداف الحرب الأمريكية على «القاعدة» في اليمن فإن السياسات التي اتبعتها كانت على نفس المنوال الذي اتبعته السياسة السعودية بتجاوز السلطة المركزية، واتخذت من فساد السلطة وضعف قبضتها خارج المدن مبرراً لفتح قنوات تواصل مباشرة مع الزعامات المحلية أصحاب السلطة الحقيقية وتوزيع المساعدات عبرهم بحجة تجنب العمل عبر آليات الفساد التابعة للحكومة المركزية، وبذلك تتمكن، على حد باحثة أمريكية، من إضعاف «القاعدة» وفي ذات الوقت مساعدة الشعب اليمني، فتحول بذلك دون انفجار البلاد من الداخل، لكن إذا نظرنا للنتائج على الأرض فإن هذه السياسة أسهمت في إضعاف سلطات الدولة أكثر مما أضعفت «القاعدة»، وفي مفارقة ملفتة بعد ما يقارب عشر سنوات من التدخل الأمريكي لمكافحة الإرهاب في اليمن وبعد أن كان الإرهاب يقتصر على أفراد يتسللون بين القبائل اليمنية أعلنت «القاعدة» في 2009م تأسيس تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» في اليمن في تطور ملفت يعاكس الأهداف المعلنة لحرب أمريكا على «القاعدة» في اليمن، الأمر الذي يثير التساؤل كما لو أن الهدف التحرش بـ»القاعدة» وتحويل اليمن إلى ساحة للعبة مفتوحة معها ونقطة تجميع لعناصرها لأهداف لها علاقة بمطامع الهيمنة على اليمن، وصراع القطبية الدولي.
في 2011 م تطور الأمر ليصبح اليمن مصدر قلق للمجتمع الدولي، ويقرر مجلس الأمن وضع القضية اليمنية قيد النظر الدولي، وفي 2015م قررت السعودية إعلان الحرب على اليمن بحجة القلق من النفوذ الإيراني وهكذا كان القلق من اليمن بمثابة حصان طروادة الذي تسبب في خرابها.
إن نظرية «اليمن الخطر» أسهمت في إضعاف الدولة اليمنية عبر مراحلها التاريخية وتحولت إلى نوع من الدعاية السوداء التي شوهت صورة اليمن إقليمياً ودولياً، وحرضت الخارج والداخل عليه، وحين كان اليمن مستغرقاً في مشاكله الداخلية كانت هذه الدعاية غير البريئة تزيد الأوضاع سوءا وتعرقل الإصلاحات الخجولة بما فيها تلك التي يلح في طلبها المانحون والمقرضون، وكثيراً ما يتلقف الإعلام الغربي والأمريكي أدنى حادثة ويصنع منها فزاعة كبيرة بهدف حشد التأييد الشعبي لحملات الولايات المتحدة العسكرية في العالم و»اليمن الخطر» المسكون بالكائنات الشريرة دون اعتبار لما لها من تداعيات سيئة على اليمن.
إن الفرضية التي تزعم أن الصراع في اليمن قادر على إشاعة فوضى خارج حدوده تتجاهل أن شرارات الصراع الداخلي لم تتطاير خارج حدوده إلا عندما كانت قذائف الخارج تكوي اليمن بألسنتها الحارقة وكل الصراعات التي حدثت في اليمن بقيت تأثيراتها داخلية والأثر المحدود الذي يمكن تخيله لا يقارن بالآثار التي خلفتها التدخلات الخارجية.
إن القلق الدولي هو في الحقيقة ناتج عن القلق السعودي والأمريكي وهما من روجا نظرية «اليمن الخطر»، وهي هاجس سياسي أكثر مما هي حقيقة سياسية، فاليمن لم يكن مصدر خطر على السعودية وكان اليمن دائماً في موقع المعتدى عليه وكل المخاطر التي كان يتم افتراضها لا تقارن بالكوارث التي تسبب فيها لليمن.
والهواجس التي قد يكون مصدرها توجهات أو تصريحات بعض النخب السياسية سواء القومية أو اليسارية أو الممانعة لا يجب أن تكون مصدر قلق إلا إذا تجاوزت اليمن إلى التدخل في الشؤون الداخلية للسعودية أو كانت تهديداً لأمنها القومي، وبالمقابل لا تبرر أي تدخلات على حساب الدولة اليمنية وسلطتها المركزية ولا يشترط أن تكون السياسة الخارجية لليمن نسخة أخرى للسياسة السعودية.
الخلاصة: إن استمرار اليمن قيد النظر الدولي أو الإقليمي إنما يعني استمرار أزمة الدولة اليمنية، وإبقاءها مشلولة معتمدة بدرجة أساسية على الخارج، وهو في النهاية لن يستطيع أن يحل محل الداخل مهما حاول، وعندما يقرر الخروج لن يترك خلفه إلا فراغاً يتحرك ضد مصالح الداخل والخارج، ومن مصلحة السعودية المساعدة بوجود دولة قوية تستطيع أن تؤمن الاحتياجات الضرورية للناس حتى لا يتحول جزء كبير من سكان اليمن إلى فائض بيولوجي غير مؤهل إلا للقتال وممارسة العنف وتصدير عمالة رثة تشتغل في التهريب.
وفرضية أن اليمن إن لم يكن قيد نظر الرياض سيذهب لغيرها أو سيشكل تهديداً لأمنها، وأن النخب اليمنية غير قادرة على إقامة علاقات متوازنة مع الأطراف الإقليمية والدولية ولا تشكل تهديداً لأحد، مجرد هواجس لا مبرر لها، ربما إن تدخل عبدالناصر في ثورة سبتمبر أسهم في تعزيزها، لكنها كانت حالة استثنائية، فتاريخياً الإمام يحيى استطاع أن يحافظ على استقلال اليمن ولم يسمح أن تكون اليمن ساحة نفوذ لأي جهة رغم المحاولات الحثيثة لكل من بريطانيا وإيطاليا وفرنسا آنئذ، وثانياً أن السعودية منذ السبعينيات هي من فرضها كخيار دائم على النخب السياسية والدولة اليمنية، وعرقلت أي قوى أو توجهات لبناء دولة قوية ومستقلة، ثالثاً: أن خيار الاستقلالية لا يعني بالضرورة العداء ولا الخصومة ولا يمنع من إقامة أفضل العلاقات مع السعودية، واليمن قادر على إقامة علاقات متوازنة مع محيطه العربي والإسلامي ومع كل الأطراف الإقليمية والدولية من مختلف التوجهات في ضوء مصالحه الوطنية واستحقاقات الجوار وواجباته القومية والإسلامية والإنسانية.

.jpg)











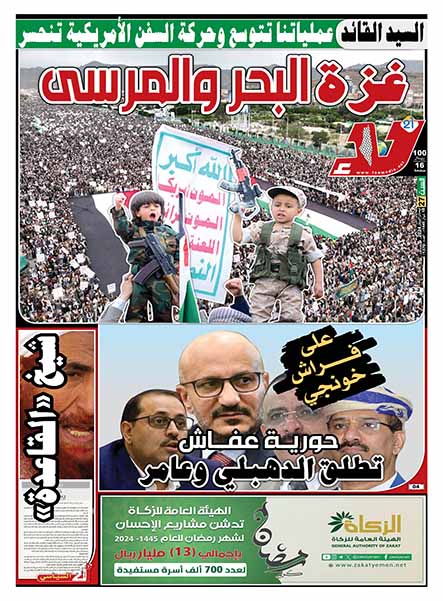




المصدر عبدالملك العجري
زيارة جميع مقالات: عبدالملك العجري