الغرب يهدد لبنان بـ«الخبز المشروط»
- محمد رسول السبت , 30 أغـسـطـس , 2025 الساعة 12:36:18 AM
- 0 تعليقات

محمد رسول / لا ميديا -
صرح توماس سانكارا، في مقابلة له عام 1987، برفضه للمساعدات الغذائية التقليدية، قائلاً: «من يقدم لنا القمح أو الذرة أو الحليب، هؤلاء لا يساعدوننا. من يريد حقاً مساعدتنا عليه أن يعطينا المحاريث، الجرارات، الأسمدة، المبيدات، دورات المياه، المثاقب، السدود... هكذا نعرّف «مساعدة غذائية» حقيقية. من يقدم لنا غذاء فحسب، لا يساعدنا، بل يطوينا كما يُدجن الوز أو الجَزر، ليبيعونا لاحقاً».
تؤكد فلسفة سانكارا أن المساعدة الحقيقية لا تأتي لإشباع الحاضر فقط، بل تمكّن الشعوب من الاعتماد على نفسها، وبناء أدواتها الإنتاجية وحماية سيادتها. سانكارا طالب بالجرارات والمحاريث والأسمدة، أي أدوات الإنتاج، كي يخلق ويؤسس لمرحلة الاكتفاء الذاتي والخروج من عباءة المستعمر الذي يعتمد على نظرية الجزرة والعصا.
لبنان يواجه تحديات مماثلة لفلسفة سانكارا؛ لكنها أكثر تعقيداً؛ بسبب البُعد السياسي والعسكري. فمنذ تشرين 2019 انفجرت الأزمة الاقتصادية، وتهاوى سعر صرف الليرة، وارتفعت أسعار السلع بشكل جنوني، فيما غرق البلد في عتمة خانقة نتيجة انهيار قطاع الكهرباء. في هذا السياق، بدأت العروض تتوالى إلى لبنان من دول عدة.
خلال العقد الأخير، قدّم محور الشرق مبادرات تحمل طابعاً بنيوياً: إيران عرضت بناء معامل كهرباء وزوّدت لبنان بالمحروقات عبر سورية، ناهيك عن عروض تسليح الجيش التي قوبلت بالرفض؛ العراق وقّع اتفاقاً لتوريد الفيول أنقذ لبنان من عتمة شاملة؛ الصين اقترحت مشاريع بمليارات الدولارات لربط لبنان بمبادرة الحزام والطريق؛ روسيا طرحت الاستثمار في مصفاة طرابلس وتزويد البلد بالنفط بأسعار تفضيلية؛ وحتى سورية، المنهكة من الحرب، فتحت ممراتها لمرور النفط الإيراني وقدمت تسهيلات تجارية وزراعية. لكن هذه العروض لم تُعتمد؛ لا بسبب ضعف جدواها، بل نتيجة الضغوط الغربية والخليجية المباشرة على السلطة اللبنانية. قبول هذه المشاريع كان سيُقرأ كتحوّل استراتيجي، وهو ما لم تسمح به واشنطن ولا شركاؤها. هنا تتجسد مقولة سانكارا مجدداً: المستعمر لا يكتفي بإفقارك، بل يمنعك أيضاً من امتلاك أدوات نجاتك.
في المقابل، المساعدات الغربية كانت في معظمها مشروطة ومجزأة: دعماً غذائياً، برامج نقدية للاجئين، تمويلاً للمدارس أو دعماً للقوى الأمنية. أمّا على المستوى البنيوي، فقد رُبطت كل الحلول بوصفات صندوق النقد الدولي: خفض الدعم، تحرير سعر الصرف، والخصخصة. هذه العروض لم تكن محايدة، بل جاءت محمّلة بشروط سياسية واقتصادية تضمن بقاء لبنان في مدار الهيمنة.
بعد عدوان أيلول على بيروت، تكشّفت هذه المعادلة بوضوح؛ إذ ارتبط الإعمار والمساعدات الدولية بشروط صريحة، مثل المساومة على سلاح المقاومة أو فرض العقوبات. أي محاولة لربط المساعدة بالتخلي عن أدوات القوة الوطنية تشبه بالضبط «الخبز المشروط» الذي حذّر منه سانكارا: دعماً ظاهرياً يبقي الدولة رهينة للمانح ويقيد سيادتها.
وفي الحالة اللبنانية، تتكرّر معادلة سانكارا بحذافيرها. فالغرب يلوّح بالمساعدات المالية المشروطة والعقوبات في آنٍ واحد، واضعاً مطلب التخلي عن سلاح المقاومة كشرطٍ مسبق لأي دعم. وهنا يُعاد إنتاج «الخبز المشروط» الذي حذّر منه سانكارا؛ خبزاً لا يُشبع، بل يُقيّد. في المقابل، ما قدّمه الشرق سابقاً من عروض بناء معامل كهرباء، وإمدادات فيول، واستثمارات بنى تحتية، أقرب إلى «المحاريث والجرارات» التي تمنح الشعوب القدرة على الإنتاج والسيادة. ومن هذا المنظور، يصبح سلاح المقاومة نفسه جزءاً من أدوات الإنتاج الوطني الأمني والسيادي.
في قلب هذه المعادلة يظهر الفرق الجوهري بين الخبز الغربي المشروط وأدوات الإنتاج الشرقية. الغرب قدّم ما يكفي لإبقاء الجسد حياً؛ لكن بشروط تجعل لبنان معلقاً بين الحاجة والارتهان. في المقابل، ما عرضه الشرق كان أقرب إلى فلسفة سانكارا: معامل كهرباء، فيول طويل الأمد، مشاريع بنية تحتية، وربط لبنان بشبكات إقليمية قادرة على إعادة استقلاله الاقتصادي. إلا أن تمسك لبنان الرسمي بخيار «الامتثال للضغوط الغربية» دفن العروض الشرقية قبل أن ترى النور، ليظل لبنان عالقاً بين فتات المساعدات وظروف السيادة الحقيقية، معادياً بذلك درس سانكارا حول أهمية أدوات الإنتاج والاعتماد على الذات.
خلاصة التجربة اللبنانية، عند مقارنتها بفلسفة توماس سانكارا، تضعنا أمام درس جوهري: السيادة الاقتصادية والسياسية لا تُمنح، بل تُبنى عبر أدوات الإنتاج والقدرة الذاتية، لا من خلال فتات المساعدات المشروطة.
لبنان اليوم يواجه سؤالاً وجودياً واضحاً: هل يرضى بالاعتماد على مساعدات ظاهرية تمنحه حياةً مؤقتة، أم يجرؤ على الاستثمار في قدراته الذاتية، بما يتيح له التحكم في موارده واستعادة استقلاله؟ كما أشار سانكارا، من يقدم لك الطعام ليبقيك حياً، يملك قرار حياتك، أما من يمنحك أدوات الإنتاج فهو يمنحك الحرية الحقيقية. إذا أراد لبنان تجاوز أزماته المتشابكة، فالحل لا يكمن في الانتظار تحت وصاية المانحين، بل في بناء اقتصاد قادر على الإنتاج والاكتفاء الذاتي، مع الحفاظ على أدوات قوته الوطنية، لتتحول الدولة من رهينة إلى فاعل مستقل قادر على رسم مستقبله.

.jpg)








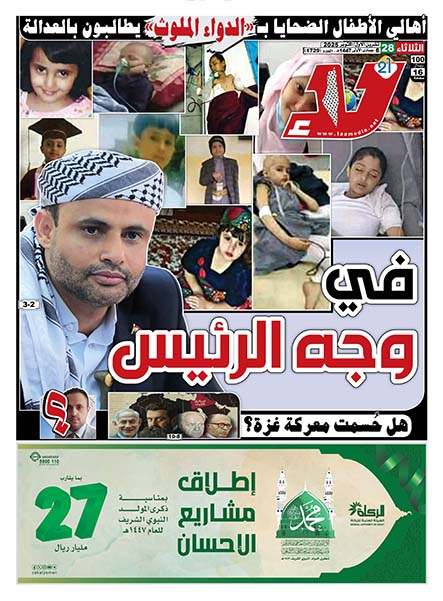


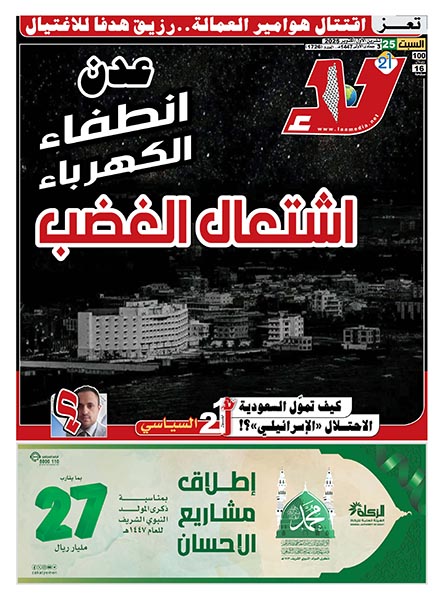



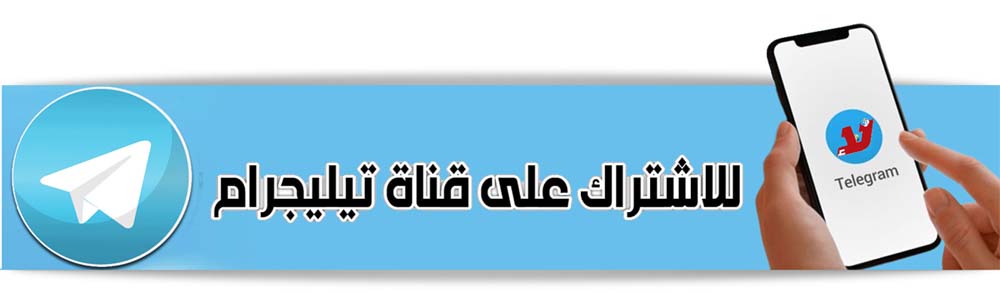
المصدر محمد رسول
زيارة جميع مقالات: محمد رسول