الماركسية والدين 3
- احمد الحبيشي الأربعاء , 11 يـولـيـو , 2018 الساعة 6:46:40 PM
- 0 تعليقات

في القرن التاسع عشر كتب ماركس وإنجلز في مقدمة البيان الشيوعي الذي يعتبر إنجيل الماركسية، أنهما قررا نشر ذلك البيان على الرغم من أن معظم أفكاره قد شاخت!
والثابت أن ماركس كان يُغيِّر أفكاره باستمرار وسط احتجاج تلاميذه، ويبرر ذلك بقوله (أنا لست ماركسياً)!
من نافل القول أن الماركسية تتكون من ثلاثة علوم، كل واحد منها مستقلٌّ عن الآخر، وهي علم التاريخ، علم الاقتصاد، والاشتراكية العلمية، بمعنى أن الماركسية منهج للتحليل، وليست عقيدة دينية جامدة.
وعندما تحولت الماركسية بعد وفاة ماركس إلى عقيدة جامدة وسلطة أيديولوجية، انقسم الماركسيون إلى شيع وفرق ومذاهب متناحرة شوّهت الماركسية، وتسببت في اغترابها عن العلم والعالم الواقعي، وأصابتها بالتجنحات والتشوهات التحريفية، وهو ما سنأتي إليه في حلقة قادمة لاحقاً.
مما له دلالة عميقة أن مسار تشوهات الماركسية كان متساوقاً مع التشوهات التي أصابت الأديان عندما اختلطت بسلطة الدولة والأيديولوجيا.
في هذا السياق يجب مقاربة بعض الجوانب المتصلة بنشوء وتطور الثقافة السياسية الاستبدادية منذ ارتباط السلطة والثروة بالأيديولوجيا الدينية، وما ترتب على ذلك من إنتاج وإعادة إنتاج ثقافة الاستبداد باسم الدين الذي تحول إلى أيديولوجيا سياسية استبدادية بعد إلحاق الدين بالملكية الإمبراطورية، وبروز ظاهرة الانحراف عن التعاليم الإلهية وتحريف الأديان والتجديف باسم الحكم الإلهي بواسطة الملوك والكهنة ورجال الدين، على نحو ما جسدته التجربة التاريخية لملوك بني إسرائيل وأباطرة أوروبا المسيحية الذين جعلوا من الله ثالث ثلاثة، (الله والملك ورجال الدين القديسين)، ثم جعلوا بعد ذلك من أنفسهم وأحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله؛ وصولاً إلى التجربة التاريخية للاستبداد باسم الإسلام على نحو ما عبر عنه الفكر الملكي المذهبي بشقيه السني والشيعي، وانتقده بعمق وإبداع شديدين الشيخ المجدد عبدالرحمن الكواكبي في كتابه الخالد (طبائع الاستبداد)، الذي يحظى بكراهية شديدة من أتباع المذهب الوهابي الإقصائي التكفيري.
والثابت أن الاستبداد ارتبط منذ عصر ملوك بني إسرائيل، وعبر عصور التاريخ المختلفة، بالدولة الدينية التي يتحول فيها الحاكم إلى ولي أمر مستبد، تحيطه طغمة من رجال الدين الكهنوتيين الذين يصبغون عليه صفات القداسة، ويأمرون الناس بوجوب طاعته وعدم الخروج عن شبر واحد من سلطانه المطلق حتى ولو جلد ظهورهم وسرق أموالهم، بدعوى أن الله ولاه على الناس في الأرض، ثم يسوغون للحاكم المستبد قتل واضطهاد المخالفين على نحو ما فعله فرعون في بني إسرائيل الذين اتبعوا تعاليم النبي موسى عليه السلام، وخالفوا التعاليم الدينية التي كان يؤمن بها فرعون وكهنته وأركان جيشه ودولته، بذريعة محاربة الخروج عن الطاعة والجماعة!
وبالنظر إلى الترابط الوثيق بين الدولة الدينية والاستبداد، فقد كان الفراعنة ومن بعدهم ملوك بني إسرائيل والأباطرة والسلاطين الطغاة، يمارسون استبدادهم المطلق من خلال غطاء أيديولوجي وجد تعبيراً له في المذاهب والفرق الدينية المختلفة التي عرفها تاريخ الأديان، واتسم معظمها بمصادرة الحرية، ومعاداة العقل بما هو مناط التكليف وأداة التفكير ووعاء المعرفة، وما ترتب على ذلك من قتل واضطهاد للأنبياء والرسل، وتكفير للعلوم والفلسفة واضطهاد للمفكرين والعلماء والفلاسفة.
ولئن ارتبط تاريخ الاختلاف بين المذاهب الدينية اليهودية والمسيحية والإسلامية بالصراع الدموي بين أتباع هذه المذاهب، والتحريض المتبادل على الكراهية في كل دين على حدة، وهو صراع كان في جوهره دنيوياً من أجل السلطة والثروة، فقد ارتبط التطور التاريخي للمذاهب والفرق الدينية المختلفة والمتصارعة بالميول نحو الإصلاح الديني على نحو ما سنأتي إليه في جزء لاحق من هذا المقال، وبالتزامن مع عودتنا إلى مناقشة بعض الآراء والأفكار التي صدرت على لسان قادة ومنظمي الملتقى السلفي العام المنعقد في العاصمة صنعاء أواخر مايو 2009م، وفي مقدمتها ما جاء على لسان (الشيخ) عبدالعزيز الدبعي من تكفير للأحزاب الوطنية والقومية اليسارية، ودعوتها للتوبة على أيدي قادة ذلك الملتقى الذي اتضح من تصريحات قادته ومنظميه أنهم كانوا يخططون لتحويله إلى محكمة للتفتيش على غرار المحاكم الدينية التي أغرقت أوروبا بدماء غزيرة سفكها رجال الدين في الأكليروس، بعد أن شنوا هجوماً مسعوراً على العقل ومنجزاته، منذ ظهور بواكير أفكار التنوير ومبادئ الحرية والعدالة والمساواة، وتوسع حركة الفتوحات العلمية والكشوفات الجغرافية والإنجازات المعرفية في القرن الثاني عشر الميلادي، وما ترتب على ذلك من مخاطر وتحديات تهدد بتقويض العلاقة المتبادلة بين الملكية والكنيسة.
مما له دلالة أن تعريف التعاليم الدينية ارتبط بالتجديف في وضع واختراع الروايات والأحاديث المنسوبة إلى الأنبياء والرسل، حيث وضع بعض الملوك ورجال الدين اليهود في بادئ الأمر كتاب (التلمود)، وزعموا أنه السيرة النبوية لموسى عليه السلام، وأصح الكتب بعد التوراة ومزامير داود. لكن التلمود اصطدم بمقاومة عقائدية صارمة من الأصوليين اليهود الذين وجدوا تناقضاً بين الكثير من رواياته وأحاديثه المنسوبة إلى موسى عليه السلام وأنبياء بني إسرائيل من جهة، وبين نصوص (التوراة) و(الزبور) من جهة أخرى.. فما كان من ملوك بني إسرائيل سوى التخلص من أسفار موسى الحقيقية وصحف الأنبياء الواردة في الزبور، عن طريق التحريف المباشر في نصوصها حتى تتوافق مع نصوص التلمود. بالإضافة إلى الزعم بأن التلمود ينسخ التوراة وصحف الأنبياء، ويغلب عليها في حال تصادم نصوص التلمود مع نصوص التوراة والزبور، لأنها كانت تختلف عن ممارساتهم، فأوعزوا إلى كهنتهم وأحبارهم لكتابة ما يريدون من عقيدة وتفسير وتأريخ على نحو ما جاء في سفر التثنية وسفر التكوين اللذين كان لهما تأثير كبير على المسار اللاحق لتاريخ الأديان، من خلال الإسرائيليات التي دسها بعض اليهود الذين اعتنقوا المسيحية والإسلام، في متون المذاهب الدينية المسيحية والإسلامية، وعلى وجه الخصوص المذاهب الأرثوذكسية والكاثوليكية والسنية والوهابية.
وقد لعبت هذه الإسرائيليات دور القاسم المشترك بين جميع هذه المذاهب في المسائل المتعلقة بتجسيد صفات الله في التلمود، وتنميط العَلاقة بين اليهود وغير اليهود، وبين السلطة والثروة والدين ورجال الدين والقضاة، ابتداءً من تشريعات الحرب والسلم والزكوات والخراج، وعقائد الاعتراف والخلاص والإرجاء والتطهير والردة والرق والميراث والنكاح وتعدد الزوجات، والموقف من المرأة وطاعة الملك بعد تجسيد صفات الله والزعم بأن الله خلق الإنسان على مثاله، وإضفاء الحكم الإلهي على الملكية، مروراً بالعقائد الخاصة بالجبرية والتوصية والتوريث، والعلاقة بين اليهود والمسيح وبين الأحبار وأنبياء بني إسرائيل، وصولاً إلى العلاقة بين الله والملك وفقاً لعقيدة سفر التثنية اليهودية، وبين الرب والملك ورجال الدين القديسين، حيث يتوحد الله بالملك ورجال الدين على قاعدة عقيدة التثليث المسيحية التي تزعم بأن ولاية الملوك تتم بمشيئة جبرية من الله، وأن رجال الدين القديسين ورثوا الروح القدس عن الله بواسطة أنبياء العهد القديم والعهد الجديد، وهو ما سنتناوله في حلقة قادمة.
في هذا السياق يجب التعرف على مسار آليات ووظائف الدولة الدينية، لجهة عَلاقة الشراكة بين العوائل المالكة لنظم الحكم في الدول الإمبراطورية، وبين رجال الدين الكهنوت في عصر ملوك بني إسرائيل وعصر ملوك أوروبا الذين توحدوا مع الأكليروس المسيحي بشقيه الكاثوليكي المركزي والأرثوذكسي على أطراف المركز، حيث كانت هذه الشراكة تجسد العَلاقة بين الدين والملكية، وتميزت بهيمنة الأيديولوجيا الدينية على رأس الدولة ممثلاً بالملك الإمبراطور الذي كان يستمد شرعيته من التماهي مع المذهب الاعتقادي السائد للأكليروس، ما جعل الملك تابعاً للكنيسة التي كانت تصر على أنْ تكون عَلاقتها بالدولة من خلال الملك وحده، حتى يتسنى لها تحييده وممارسة سلطتها المطلقة على باقي أجهزة الدولة والجيش والمؤمنين. وبتأثير هذه العَلاقة النمطية كان الملك يستمد شرعيته من تبعيته للمذهب الكنسي السائد وفقاً لعقيدة التثنية الموروثة عن التلمود وسفر التثنية، فيما كان الملك يخضع في الوقت نفسه لأوامر ونواهي ووصاية رجال الدين الذين كانوا يقدمون أنفسهم كوكلاء لله على الأرض، وورثة للأنبياء والرسل، انطلاقاً من عقيدة التثليث بوصفها أساس فكرة التفويض الإلهي في اللاهوت المسيحي.
وبوسعنا القول إن نمط هذه العلاقة بين الدين وملوك بني إسرائيل في التاريخ اليهودي، وبين الملكية والكنيسة في التاريخ المسيحي، أسهم في تحويل الدولة إلى أداة لنشر وحماية المذهب الاعتقادي النافذ، والحفاظ على المصالح المتبادلة بين الطرفين على قاعدة الموروث التاريخي للعَلاقة بين الدين والدولة، والذي تجسد في الحروب الدينية، سواء ضد أتباع الأديان الأخرى أم بين الطوائف والمذاهب المسيحية المخالفة للمذهب الاعتقادي السائد، وما ترتب على مخرجات هذه الحروب من غنائم وسبايا وعبيد وثروات ومصالح في ظل نمط الاقتصاد الخراجي الذي كان يمزج بين العبودية والإقطاع في عصور ما قبل الرأسمالية والثورة الصناعية التي أصبحت أوروبا ساحتها الرئيسة بعد أفول شمس الحضارة الإسلامية، على أثر صعود السلفية المنغلقة التي حاربت العقل، ومارست أبشع صور الاضطهاد للمفكرين والفلاسفة وعلماء الطب والفيزياء والكيمياء والفلك والجغرافيا والرياضيات والمنطق في العالم الإسلامي، وأحرقت كتبهم منذ القرن الخامس الهجري الموافق للقرن الحادي عشر الميلادي.
(يتبع)
موقع لاء الأخباري / أحمد الحبيشي

.jpg)







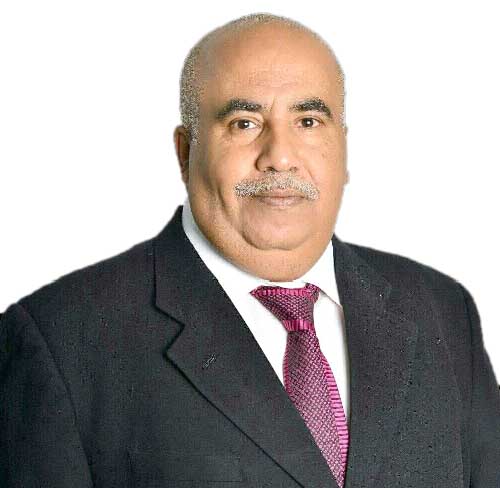

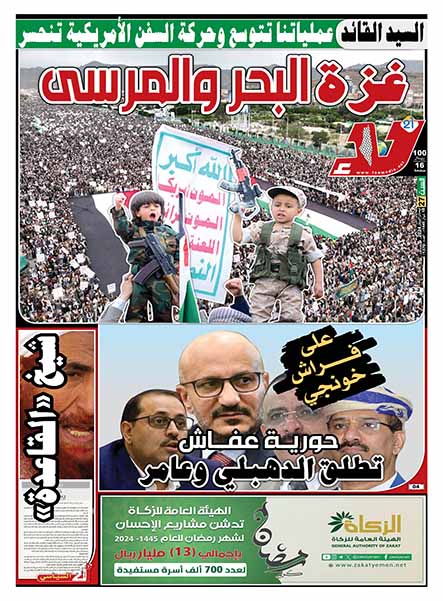






المصدر احمد الحبيشي
زيارة جميع مقالات: احمد الحبيشي