هل يحمل تهديداً لمهنة الصحافة؟.. الذكاء الاصطناعي.. الكاتب المزيف
- تم النشر بواسطة بشرى الغيلي/ لا ميديا

استطلاع: بشرى الغيلي / لا ميديا -
التحولات التقنية لا تنتظر أحدًا والذكاء الاصطناعي لم يطرق باب الصحافة بل اقتحمه بصياغة لامعة وأعصاب باردة، صار يكتب، يحرر، يلخّص، ويختم بعبارة مزيفة.. ثم يوقّع باسمك.. في قلب هذا المشهد، يولد «الكاتب الصناعي المزيف» لا هو صحفي، ولا كاتب، لكنه بارع في ترتيب الكلمات كما تحب الخوارزميات، يكتب مقالًا دون أن يقرأ، يحلل قضية لم يعشها، ويشرح واقعًا لم يمرّ به، ومع ذلك تراه في واجهة الصحف، بكامل هندامه اللغوي، يبتسم تحت العنوان! الأخطر من ذلك أن بعض الصحفيين الحقيقيين، بوعي أو من دونه، بدأوا يسلّمون أقلامهم للآلة، ليس على استحياء، بل كمن يستريح بعد عناء طويل، يولّدون الفكرة في واجهة الذكاء الاصطناعي، وينتظرون أن تخرج المقالة جاهزة ثم يعيدون ترتيب العناوين ويمضون.
وفي الزاوية الأهدأ يقف أولئك الذين لا يجدون في الذكاء الاصطناعي خطرًا، بل مخرجًا يستخدمه الكسالى لتقليل الجهد، وتوفير الوقت، لكنهم لا يدركون أن الوقت الذي يُختصر هنا يُقصّ من عمر الكتابة ذاتها، من وهجها وصدقها.. هذه ليست أزمة تقنية بل سؤال يهدد المهنة: من هو الكاتب اليوم؟ من يستحق التوقيع؟ ومن يجرؤ أن يقول: أنا كتبت؟ في هذا الاستطلاع نفتح الموضوع من قلب المهنة، وتطرقه صحيفة (لا) لأول مرة في الصحافة اليمنية كعادتها في مواكبة مستجدات التقنية الحديثة وكيفية التعامل معها وناقشنا ذلك مع أكاديميين، وصحفيين، ومحررين، ومختصين.. تحدثوا عن الخوف الصامت من تهديد الذكاء الاصطناعي لمهنة الصحافة وتكون مجرد بحث آلة بلا صحفي.. كونوا مع السياق..
الكاتب الاصطناعي!
من أبرز التهديدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قدرته على توليد محتوى زائف يبدو واقعيا إلى حد بعيد، فتقنيات «التزييف العميق» أصبحت شائعة وصارت الكتابات كغثاءِ السيل كما يبدأ استطلاعنا لصحيفة (لا) أبو فاطمة (ناشط اجتماعي): «أعرف الكثير ممن يكتبون في الفتراتِ الأخيرة مقالات مطولة وفي واقعهم لا يستطيعون كتابة سطرين على بعضهم، هذا غير الأخطاء الإملائية».
وبطريقة ساخرة وحسبما يعايش في الواقع يضيف: «والآن في ليلةٍ وضحاها صاروا كتابا صناعيين ينافسون الكبار والمشهورين، ونحن كقرّاء أصبحنا نشمئز من الكتابات بالذكاء الاصطناعي».
يختم أبو فاطمة: «وللعلم نعرفهم كقرّاء لأن الكتابة بالذكاء الاصطناعي مجرد حشو كلمات مفرغة من المعاني الإنسانية، ونحترم من يكتب بنفسه حتى لو أخطأ، فنشعر أنه إنسان وليس مجرد آلة».
الوعي لا يُصنع آلياً
ولأهمية الموضوع طرحناه لمجموعةٍ من الأكاديميين، حيث قال الدكتور علي العمار، نائب عميد كلية الإعلام لشؤون الطلاب ورئيس قسم الصحافة والنشر الإلكتروني بجامعة صنعاء: «الكثير من طلاب الدراسات العليا وطلاب البكالوريوس صاروا يستجلبون كثيرا من التكليفات البحثية عن طريق الذكاء الاصطناعي، والمشكلة الكبيرة أنهم حتى في سرقة هذه التكاليف لا يكلفون أنفسهم بقراءتها، بالتالي من السهل جدا كشفهم».
وأضاف: «لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يربط المتغيرات أو يفسر النتائج بدقة، لأنه لا يملك العقل التحليلي.. البحث العلمي عملية عقلية، والوعي لا يُصنع آلياً».
وختم العمار أن بعض الصحفيين يكتبون به بالكامل، مما يُنتج محتوى سطحيًا، مكررًا، وبلا حجج واقعية»، مؤكداً أن «الأسلوب هو هوية الصحفي، ولن يصنعه الذكاء الاصطناعي مهما بلغ تطوره».
لا يهدد المبدعين
حرصت صحيفة (لا) أن تأخذ وجهات نظر من لهم علاقة مباشرة بالتحرير الصحفي ومن تقع عليهم مسؤولية التمييز بين الصحفي الحقيقي، والصحفي المزيف.. وهنا يرى محمد إبراهيم؛ مدير تحرير مجلة «اليمنية» أن «الذكاء الاصطناعي لا يُعد تهديدًا مباشرًا للمحررين، بل أداة دقيقة تكشف من يملك أدواته المهنية ومن يفتقدها. فهو لا يُلغي المبدع، لكنه قد يُقصي من لا يستطيع التعامل معه بوعي ومهارة».
أضاف: «الذكاء الاصطناعي مثل العولمة.. يزيد المبدع إبداعًا، ويترك غير المؤهل يتخلف أكثر».
ويعتقد إبراهيم أن التحكم الواعي بهذه الأداة يمكن أن يُنتج محتوى إبداعيًا عالي الجودة، خاليًا من الحشو والأخطاء، ويختصر الوقت والجهد. لكن الانسياق خلفها دون وعي، يُضعف الصحفي ويفقده صوته، ويفرغ النص من معناه.
يشير إلى أن التحرير المهني لا يتوقف عند استلام المادة، بل يبدأ هناك، حيث تُخضع النصوص سواء كانت بشرية أو آلية لعملية تشذيب وتكييف دقيقة: حذف الحشو، إعادة بناء العناوين، دمج الهوامش في المتن، وضبط المساحة الطباعية بما يخدم هدف النشر.
ويلفت إبراهيم إلى أن الخطورة الحقيقية لا تكمن في استخدام الذكاء الاصطناعي، بل في غياب محددات تحكم هذا الاستخدام، إذ قد يدفع ذلك بعض الصحفيين لتكديس المعلومات دون ارتباط حقيقي بسياق النص، وهو ما يقتل القدرة على التعبير والتفكير النقدي.
ويختم بتحذير محسوب: «الذكاء الاصطناعي لن يُقصي المحرر المبدع، لكنه قد يستغني عن الصحفي الذي فقد أدواته وتوقف عن التطور».
يشبه عمليات التجميل
في ظل تزايد الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي في غرف التحرير، تشير دولة الحصباني (أكاديمية) إلى نقطة غالبًا ما تغيب عن النقاش: الخطر على هوية المؤسسة الإعلامية نفسها. إذ ترى أن المواد المنتجة آليًا، حتى إن بدت متماسكة، تُكرّس التشابه وتُفقد الوسيلة طابعها التحريري الخاص. وتقول إن «الأصل في المادة الصحفية أن تكون واقعية ومبتكرة، تعكس نبض الجمهور وتُقدّم قيمة مضافة، لكن المحتوى المصطنع، يشبه عمليات التجميل التي تذيب الفروق بين الوجوه، وتحوّل النصوص إلى قوالب مكررة لا تحمل تفردًا».
وتلفت الحصباني إلى تحدٍ عملي تواجهه غرف التحرير يتمثل في ضغط الكم وسرعة الإنتاج، ما يسمح أحيانًا بمرور نصوص آلية دون تدقيق كافٍ. ومن هنا تدعو إلى تطوير سياسات تحريرية صارمة، وتعيين محررين متخصصين تكون مهمتهم فحص النصوص، لا من حيث اللغة فقط، بل من حيث البنية، والترابط، والمصدر.
وتختم أن التميّز التحريري لا يأتي من التقنيات، بل من التحرير ذاته، ومن فهم السياق والابتكار في الطرح، مؤكدة أن أي وسيلة إعلامية تهمل هذه العناصر تخاطر بخسارة جمهورها وهويتها في آنٍ معًا.
أداة داعمة وليست بديلة
ومواصلة لآراء المختصين تحدث عبدالله الحسامي؛ سكرتير تحرير، بالقول إن المشكلة لا تكمن في الذكاء الاصطناعي بحد ذاته، بل في الخلط بين كونه أداة مساعدة وبين استبداله بالصحفي كليًا.
يضيف: «الذكاء الاصطناعي رائع عندما نستخدمه لتوفير الجهد والوقت، في تلخيص التقارير، ترجمة المحتوى، البحث عن مصادر، أو مراجعة النصوص.. هذا ما يجعله أداة داعمة للعمل الصحفي لا بديلًا عنه».
وشدد الحسامي على أن هذه المهارات الذكية يجب أن تُوظف داخل غرف التحرير، لا أن تُسلَّم لها المهمة كاملة، ومن يكتب مقالًا صحفيًا كاملًا عبر الذكاء الاصطناعي ويوقعه باسمه، يرتكب غشًا مهنيًا ويغش نفسه أولًا.
ويرى أن الحل ليس في محاربة التقنية، بل في تدريب الكوادر على استخدامها بوعي، ويوجه دعوته للمؤسسات الإعلامية بأن تُقيم ورشًا متخصصة تشرح الاستخدام الذكي لهذه الأدوات، وتفهم إمكانياتها كعامل جودة لا كمنتج نهائي.
وأكد الحسامي أن «من يعتمد على الذكاء الاصطناعي فقط في إنتاج المادة فهو لا يستخدم الأداة، بل يتخلى عن دوره المهني تماماً».
عندما يُنتزع العنصر الإنساني
يشدد الدكتور عبده الأكوع؛ أستاذ الاتصال الرقمي والسرد الاستقصائي المساعد بجامعة صنعاء على أن الإشكال الحقيقي في استخدام الذكاء الاصطناعي لا يكمن فقط في إنتاج المحتوى، بل في طمس خلفيته ومصدره. مؤكدًا أن تقديم النص الآلي على أنه بشري دون إفصاح هو انتهاك صريح لمبدأ الشفافية.
ويرى أن النصوص المصطنعة، مهما بدت سليمة، غالبًا ما تفتقر إلى العمق السردي واللمسة الأسلوبية التي تميز الكاتب الحقيقي، مشيرًا إلى أن المحررين ذوي الخبرة مازال بإمكانهم رصد تلك الفجوات.
في حديثه عن سياسات المؤسسات الإعلامية، يلفت الأكوع إلى أن البعض بدأ يسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي كمساعد ضمن حدود أخلاقية واضحة، أهمها الإفصاح والتحرير البشري النهائي.
ويضيف: «النص الصحفي ليس مجرد نقل معلومات، بل هو سرد يحمل رؤية وصوتًا وهوية. عندما يُنتزع هذا العنصر الإنساني، يبدو النص خاليًا من الروح، مهما كانت دقته اللغوية».
أما التحدي الأكبر، كما يراه، فهو في استمرار الاعتماد على أدوات جاهزة دون ضوابط، مما قد يؤدي إلى إضعاف البنية المهنية، وتقليص فرص الصحفيين الشباب، وتآكل الإبداع.
واختتم رأيه بتأكيد حاسم: «الذكاء الاصطناعي ليس بديلًا، ولن يكون. إنه بحاجة إلى الصحفي ليمنحه المعنى».
تشويش بصري وعدم توازن
ولأن المواد الصحفية لا تكتمل رؤيتها إلا باللمساتِ الإخراجية كون المخرج يسهم بشكلٍ كبير برؤيتها للنور.. وفي هذه الجزئية أوضح فؤاد المصباحي المخرج الفني في صحيفة «لا»- أن الذكاء الاصطناعي قد يُقدِّم لمسات إخراجية سريعة أو مُلفتة على السطح، لكنه يفتقر إلى العنصر الذي يصنع الفارق بين مخرج وآخر: الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة.
وأضاف المصباحي: «الذكاء الاصطناعي لا يهتم بالتفاصيل كما يفعل المصمم أو المخرج المحترف، وهذه التفاصيل هي ما تمنح العمل طابعه الخاص وتميّزه عن غيره». مشيرًا إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي تميل إلى نمطية ثابتة لا تُراعي المدارس الإخراجية المتعددة، سواء في الأعمال الثابتة أو المتحركة أو ذات الطابع الخاص كالتقارير والتحقيقات.
كما يلفت إلى نقطة فنية دقيقة، وهي ضعف الذكاء الاصطناعي في التعامل مع تدرجات الألوان القريبة، مثل الأحمر أو الأزرق، ما يؤدي إلى تشويش بصري أو عدم توازن في توزيع الألوان، وهو ما يؤثر سلبًا على راحة القارئ البصرية. وأضاف أن معالجة الظلال والدرجات الرمادية تبقى أحد أوجه القصور الواضحة في التصميم الآلي، إذ تفتقر هذه الأنظمة إلى الحس البصري المكتسب الذي يملكه المحترف.
ويختم المصباحي بقناعة مهنية: «المخرج المحترف لا يضع الصور والألوان عشوائيًا، بل يوازنها بصريًا وفق قواعد وأحاسيس لا يمكن برمجتها؛ لأنها ببساطة جزء من رأسماله الفني».
انتهاك أخلاقي
في خضم الجدل المهني حول الكتابة بالذكاء الاصطناعي، تُسلّط الأستاذة آسيا خصروف؛ رئيسة تحرير مجلة «اليمنية» سابقًا، الضوء على سؤال لا يتعلق بالتقنية بقدر ما يمسّ جوهر المهنة، وهو: من أين يبدأ الانحراف؟ وتجيب بالقول: «نشر مقالات مكتوبة بأدوات الذكاء الاصطناعي انتهاك أخلاقي، لكننا في غرفة التحرير نستطيع تمييز هذه النصوص، فهي تفتقد البصمة والأسلوب، مهما كانت محكمة لغويًا».
وهنا لا تدين خصروف الأداة، بل تنبّه إلى الحاجة لتدبير ذكي عند المعالجة، إذ ترى أن العقاب المهني لا يجب أن يُلغي مستقبل الكاتب، بل يُعيد توجيهه، وتقول: «لا يجب أن يكون التصحيح تدميرًا، فالأخطاء لا تعني انتهاء القيمة المهنية».
وفي تمييزها المهم تشير إلى أن أثر المحتوى الاصطناعي يختلف باختلاف المجال «في الأدب يُضعف الثقة، لكن في التعليم قد يكون أداة لتبسيط الفكرة، لا لإلغائها».
تختم خصروف برؤية واقعية، قائلة: «لن تحمينا القوانين وحدها، ما لم يتحلَّ الكاتب نفسه بأخلاقيات المهنة والمصداقية عند الكتابة».
المهنة تُبنى بالجهد لا بالنسخ
يرى أنس القاضي؛ كاتب صحفي، أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في كتابة المواد الصحفية ينسف جوهر المهنة، ويحيل الصحفي إلى مراقب بدلا من أن يكون فاعلًا. ويقول: «المشكلة ليست في أن الذكاء يكتب، بل في أن بعض الصحفيين يسمحون له بأن يكتب بدلًا عنهم».
ويضيف أن المادة الناتجة، وإن بدت منظمة، تفتقر إلى الملاحظة والعاطفة والتفرد، لأن الذكاء الاصطناعي لا يملك حس الواقع. ويشبه القاضي هذا التكرار بما حدث مع وسائل التواصل حين اجتاحها من لا علاقة لهم بالمهنة.
وحذر القاضي من أنه «إذا كتب الذكاء الاصطناعي كل شيء عنك، فأنت بلا اسم ولا صوت.. المهنة تُبنى بالجهد، لا بالنسخ».
لا توجد ضوابط جاهزة
في الجانب الأكاديمي أيضا تضيف رؤيتها لجانب الذكاء الاصطناعي، الدكتورة سامية الأغبري؛ قسم الصحافة بجامعة صنعاء أن الخطر الحقيقي في استخدام الذكاء الاصطناعي، خصوصًا لدى الطلاب والصحفيين، لا يكمن في الأداة نفسها، بل في غياب التأهيل العلمي والأخلاقي لاستخدامها.
وتضيف: «لا توجد ضوابط جاهزة، فقط اجتهادات فردية، وهذا ما يجعل الاستخدام المرتبك أكثر خطورة». مشددة على أن التقنية لا تضيف قيمة إذا لم تُستخدم ضمن سياق تربوي واضح، يُفصح فيه عن طبيعتها، وتُحترم فيه أخلاقيات المهنة، «لا يمكن قياس تأثير الذكاء الاصطناعي على وعي المجتمعات إلا من خلال دراسات علمية، فالإبهار قد يُخفي آثارًا أعمق على الإدراك».
وتقترح الأغبري إدخال مساقات تعليمية حول الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، وتدريب الطلاب على التمييز بين المعلومات الحقيقية والمفبركة. مؤكدة أن المشكلة ليست في الكتابة بالذكاء الاصطناعي، بل في التلقي غير الواعي له.
ما يُصنع آلياً لا يلتقط حرارة المشهد
في ظل الانبهار العام بقدرات الذكاء الاصطناعي يلفت الصحفي أحمد المالكي ـصحيفة «الثورة»- النظر إلى الجوهر المغيّب في النقاش: الميدان. فبحسبه، ما يُصنع آليًا لا يلتقط حرارة المشهد، ولا يَشمّ رائحة الحدث، ولا يسمع الانفعالات. كل ذلك، كما يقول، لا يُولد من خوارزمية، بل من عَين حاضرة وذهن متفاعل. ويثير المالكي نقطة نادراً ما تُطرح: خلل بيئة النشر نفسها، فالتساهل مع المواد المكررة أو التي تُولد رقميًا، يمنح «من لم يتشكل مهنيًا» مساحة لا يستحقها. وهنا لا يتحدث عن المنافسة، بل عن تآكل المعايير التي ضمنت بقاء الصحافة حيّة لعقود. ختم المالكي بتساؤلٍ: «كيف نُعيد تهيئة الصحفي ليستعيد مكانته؟» ورد أن ذلك يكون «بقدرته على التفكير، والعمق في التناول، والوعي بالأسلوب لا يقوم على النسخ بل على التحليل والتفسير».
الانسحاب النفسي من التجربة الكتابية
ولأهميةِ الجانب النفسي وتأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل الصحفي والقارئ المتلقي على حدٍ سواء، كون الذكاء الاصطناعي هناك من يتعامل معه بإفراط، والبعض الآخر بحذر، والقلة فقط من يتعاملون معه بتوازن.. يشير محمد سلطان؛ مختص في علم النفس، إلى أن الاستخدام المفرط لأدوات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي لا يمرّ دون أثر نفسي على الكتّاب أنفسهم، «إذ تبدأ الحالة بما يشبه الاعتماد النفسي المزمن، حيث يُعوّل الصحفي على الأداة في كل مرحلة: من جمع المعلومات إلى الصياغة والمراجعة. ومع الوقت، يضعف لديه ما يُعرف بالذاكرة الكتابية العاطفية، تلك المرتبطة بتجربة الكتابة كفعل شعوري داخلي، مليء بالقلق والتردد والانفعال».
ويضيف سلطان أن الاعتماد المستمر يفتح الباب أمام ما يسميه المتخصصون بـ(الانطفاء الإبداعي التدريجي)، حيث يفقد الصحفي حسه الأسلوبي، وتتراجع قدرته على الكتابة الذاتية، حتى يصبح عاجزًا عن توليد الأفكار دون دعم تقني، وتبدأ بالظهور علامات مثل الإحباط الخفي، وتراجع الحافز، وأحيانًا الانسحاب النفسي من التجربة الكتابية نفسها، رغم الاستمرار الشكلي في الإنتاج.
ويرى أن هذه التحولات لدى الكتّاب تُقابلها تغيرات موازية في سلوكيات القراء، إذ تتشكل مستقبلاً أنماط جديدة من التلقي، تُحدث تحولًا في وظيفة القراءة ذاتها.
ويحذر سلطان من أن هذا «الانحدار النفسي لا يمس الأفراد فقط، بل يعيد تشكيل وظيفة الثقافة ذاتها، فحين تتحول الكتابة إلى نشاط آلي، والقراءة إلى سلوك استهلاكي، تُفرغ الكلمة من طاقتها الرمزية، وتفقد الثقافة دورها في الربط بين التجربة والوعي، بين الشعور والمعنى».

.jpg)








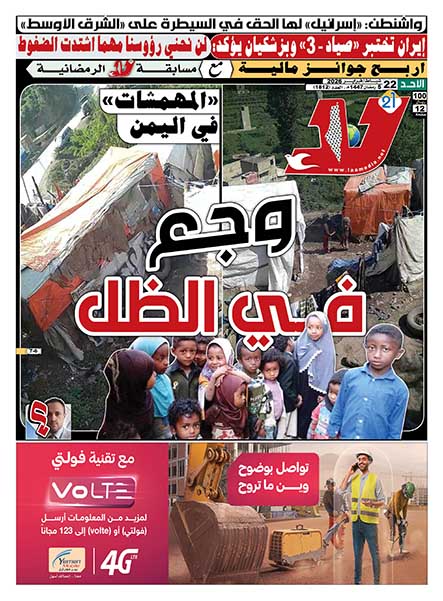






المصدر بشرى الغيلي/ لا ميديا