صحافة الترند..بين هندسة «التفاهة» وضرورة الوعي
- بشرى الغيلي الثلاثاء , 23 ديـسـمـبـر , 2025 الساعة 12:34:03 AM
- 0 تعليقات

بشرى الغيلي / لا ميديا -
في الوقت الذي تظن فيه أنك تضغط بإرادتك الحرة على زر «المشاركة» أو «الإعجاب»، هناك في الغرف المظلمة من يبتسم بخبث؛ لأنك للتو قد ابتلعت الطُّعم. نحن لسنا أمام مجرد موجة عابرة من الأخبار، بل نحن بصدد ظاهرة خطيرة تستحق أن نطلق عليها ولأول مرة مصطلح «صحافة الترند». إنها تلك السلطة الجديدة التي لا تحتاج إلى ترخيص من وزارة الإعلام، ولا تعترف بميثاق شرف صحفي؛ سلطة جعلت من أحاديث البيوت وقضايا «اللاشيء» مادة دسمة تتصدر المشهد، وتصنع من الحمقى مشاهير، ومن القامات أهدافاً مستباحة.
دعونا نقف قليلاً أمام هذا المشهد العبثي، بأسلوب المحقق الذي يبحث عن «الجريمة الكاملة»، نجد أن «صحافة الترند» ليست مجرد انعكاس لما يريده الجمهور، بل هي صناعة؛ نعم، صناعة لها مهندسون يتقنون اللعب على أوتار العاطفة والفضول. في اليمن، كما في غيرها، لم تعد القصة الصحفية هي التي تفرض نفسها بقوتها، بل «الخوارزمية» هي التي تقرر. وراء الكواليس، ثمة جيوش من «الذباب الإلكتروني»، أو ما يحلو للبعض تسميته تلطفاً بـ»النحل الإلكتروني»، مدعومة ببرامج وتطبيقات تضخ أرقاماً وهمية من المشاهدات والتفاعلات، لتوهمك -أنت المواطن البسيط- أن هذا المحتوى هو «حديث الساعة»، فتنخرط فيه بحسن نية، أو بفضول قاتل.
ولعلنا نستحضر هنا ما حدث في بعض «الترندات اليمنية» مؤخراً، حين تحولت بضع ثوانٍ من أغنية تراثية مغمورة تم «ريمكسها» بطريقة مبتذلة إلى حدث وطني شغل الناس عن قضاياهم المصيرية. أو ذلك الموقف العابر في أحد الأعراس بصنعاء، الذي تحول بقدرة قادر إلى قضية رأي عام نُصبت فيها المشانق الاجتماعية، وانتُهكت فيها خصوصيات عائلات بأكملها... هنا تتجلى «صحافة الترند» في أقبح صورها: وحش كاسر يقتات على سمعة الناس وأعراضهم.
إن ما يثير الريبة ونحن ننظر بعين فاحصة، هو التوقيت. لماذا يصعد هذا «الترند» التافه الآن تحديداً؟! الإجابة التي قد لا تعجب الكثيرين هي أن «مهندسي الترند» بارعون في فن الإلهاء. يتم ضخ خبر فضائحي، أو موقف صادم، لتغطية خبر آخر أكثر أهمية وخطورة. إنها لعبة «خفة يد» إعلامية؛ بينما تنظر أنت إلى اليد التي تلوح بالمنديل الملون (الترند التافه)، تقوم اليد الأخرى بتمرير القرارات المصيرية أو الكوارث الحقيقية دون أن يرف للمجتمع جفن.
لكن، هل «صحافة الترند» شرٌّ خالص؟!
للإنصاف، وكما ننظر للنصف الفارغ، يجب أن نرى النصف الممتلئ. قد يكون «الترند» وسيلة تربوية هائلة إذا أُحسن استغلاله. رأينا كيف أعادت بعض الهبات الإلكترونية الاعتبار للزي اليمني التقليدي، وكيف أحيت قيم التكافل في مبادرات شبابية لكسوة الفقراء في شتاء صنعاء القارس... هنا يتحول «الترند» من معول هدم إلى أداة بناء، تعيد إحياء قيم منسية وعادات أصيلة كادت أن تندثر تحت عجلات العولمة.
المشكلة الحقيقية تكمن في نوعية وطبيعة الاستجابة. وهنا نضع اللوم -كل اللوم- على النُّخَب. لا يزال الخطاب النخبوي والأكاديمي يغرد خارج السرب، أو بالأحرى «يغرد في زمن آخر». عندما يشتعل «ترند» يمس العقيدة أو القيم الاجتماعية، يخرج علينا دكتور جامعي موقر، ليواجه فيديو «التيك توك» الذي مدته 30 ثانية، بمحاضرة فيديو مدتها ساعتان، أو بكتاب من 400 صفحة!
أيها الأكاديمي، في قانون «صحافة الترند»، أنت خاسر قبل أن تبدأ. العامة لا يقرؤون المطولات، والجيل الجديد لا يملك «ترف» الوقت لسماع مقدماتك الطللية. التأثير اليوم أصبح في يد البسطاء الذين يملكون أدوات العصر ولغته. إذا أردت أن تحمي المجتمع، عليك أن تنزل من برجك العاجي، وأن تواجه «الترند» بـ»ترند» مضاد، ذكي، سريع، ومؤثر. اللغة الخشبية ماتت، ونحن اليوم في عصر «الكبسولة» المعرفية.
من المؤسف حقاً أن نرى قنوات فضائية وصحفاً عريقة، بدلاً من أن تقود الوعي، تحولت إلى صدى لمواقع التواصل. خصصت برامج كاملة لملاحقة «ماذا قال الناشطون؟»، تعيد تدوير الغث والثمين دون تمحيص أو تحذير. إنهم يروجون للتافهين مجاناً، ويفتحون الهواء لمن لا يملك فكراً ولا منطقاً، فقط لأن «أرقامه عالية».
هذه الصحافة التقليدية، التي تتناول «الترند» ببرود، تفشل في جذب الانتباه، رغم أن «صحافة الترند» هي الدجاجة التي تبيض ذهباً (أو مشاهدات) إذا ما عولجت بذكاء.
إننا أمام مد هائل، وعواصف إلكترونية لا تبقي ولا تذر. «صحافة الترند» (وهذا المصطلح الذي نسكه اليوم لنفهم واقعنا) ليست مجرد ظاهرة عابرة، بل هي الواقع الجديد. إنها تتجاوز الحدود، تزرع السخط أو الرضا، ترفع أقزاماً وتسقط عمالقة.
نخلص إلى أن الأمر لم يعد خياراً، بل ضرورة ملحة على المؤسسات والتربويين وصناع القرار، مراجعة خططهم وأساليبهم. لا يمكن مواجهة «الذباب الإلكتروني» بمبيدات حشرية من القرن الماضي. نحن بحاجة إلى «صحافة ترند» واعية تخلق الحدث ولا تنجرف خلفه، تصنع الوعي بالأدوات نفسها التي يُصنع بها الوهم. وإلا سنظل دمى تحركها خيوط خفية، نرقص على أنغام «ترندات» مجهولة المصدر، بينما تحترق قيمنا وثقافتنا بصمت خلف الشاشات.
السؤال الذي يجب أن يؤرقنا جميعاً الليلة قبل أن ننام ونحن نتصفح هواتفنا: هل ما نراه هو الحقيقة؟ أم أنه مجرد فصل جديد من مسرحية «ألهاكم التكاثر» فيها بنسختها الرقمية؟!

.jpg)









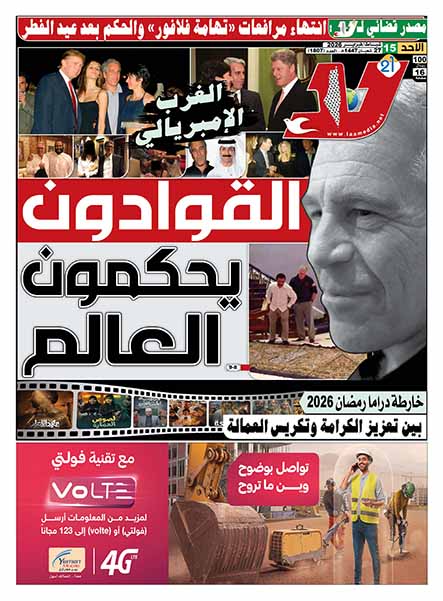
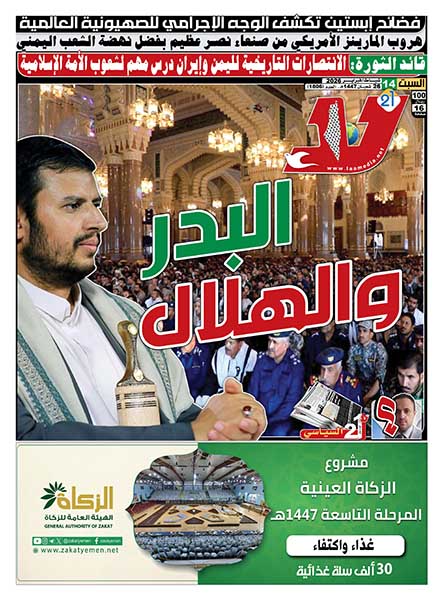





المصدر بشرى الغيلي
زيارة جميع مقالات: بشرى الغيلي