«لا» تُعيد جريمة قتل الأطفال المرضى باللوكيميا إلى الواجهة 2
- تم النشر بواسطة عادل عبده بشر / لا ميديا

تحقيق: عادل عبده بشر/ لا ميديا -
(تمهيد: عزيزي القارئ، السلام على عينيك الجميلتين. أعرفُ أن هذه المادة الصحفية ستنال من قلبك كثيراً، وقد تُعكر سكينتك بقية اليوم، وتقض مضجعك، لكنني لستُ بحالٍ أفضل منكَ، فقد أمضيتُ ليلةً ليلاء وأنا أُخيط النص بما هو أخف من أوجاع أهالي أطفال «اللوكيميا» لأضعها بين يديك بنسبة تركيز 1% فقط، وبمقدار ملعقة من بحر آلامهم، الذي صِرتُ غريقه رغماً عني، فأرجو أن تقبل اعتذاري، ولك السلام).
في القاعة الكُبرى بمحكمة غرب الأمانة، وخلال جلسة الثلاثاء 16 أيار/ مايو الجاري، لمحاكمة المتهمين في جريمة الدواء الملوث الذي تسبب بوفاة 11 طفلاً من مرضى “اللوكيميا” (سرطان الدم) في مستشفى الكويت وإصابة 10 آخرين بمضاعفات خطيرة، وبينما أنا أقف جوار منصة هيئة القُضاة، أُفتش بعيني في مقاعد القاعة، التي حجبت رؤيتها الأعناق المُشرئبة لمعشر محاميّ المتهمين. كنتُ أبحث عن أولياء الدم كمن يبحث عن شعرةٍ في كومة قِش، حتى وقعت عيناي على اثنين منهم يحاولان الوقوف بثبات خلف محاميهما، وشخص ثالث تخلف قليلاً، سانداً ذراعه اليمنى على مقعد خشبي، أوشك المقعد أن يتهاوى من فرط الوجع المُتدفق إليه عبر ذراع الرجل، الذي عرفتُ، فيما بعد، أنه يُدعى عبده محمد خموسي، والد أحد الأطفال الذين تسرّبوا من الحياة قسراً، عبر ثقب المستشفى الحكومي.
وكانت صحيفة “لا” قد نشرت في عددها رقم (1149) الصادر يوم الأربعاء 17 أيار/ مايو الجاري، تفاصيل جلسة المحاكمة والحلقة الأولى من هذا الملف الصحفي المخصص لكشف خفايا وتطورات قضية وفاة وإصابة 21 طفلاً مصاباً بـ”اللوكيميا” نتيجة تلقيهم جرعة ملوثة من دواء (methotrexate) في مستشفى الكويت، أواخر أيلول/ سبتمبر 2022. وفي هذه الحلقة (الثانية) من الملف، نترك المساحة لعدد من أهالي الأطفال الضحايا.
جيلاً من الألم
وكأنه يحمل جيلاً من الألم داخل صدره، كان المواطن عبده محمد خموسي مثقل الجسد، متعب الروح، تائهاً إلى حدٍّ كبير. تهالك على الأرض في مكان زاورت عنه الشمس، خارج مبنى المحكمة، بعد انتهاء الجلسة.
تفحصتُ وجهه ملياً قبل أن أقترب منه. رأيته يتمشى في ذاكرته فوق حقل من الأحزان. وددتُ لو أستدير وأعود أدراجي، حتى لا أنكأ جرحاً يجاهد صاحبه في لملمتهِ؛ غير أن الواجب الصحفي جعلني أمضي قُدماً.
حاولتُ استدراجه إلى مساحة حديث آمنة؛ ولا أمان سيشرق في حياة آباء وأقارب الأطفال الضحايا، إلا بعد أن ينال الجُناة جزاءهم الرادع.
بداية لم يُعِر حديثي معه اهتماماً. وحين تأكد أنه لن يستطيع معي صبرا، ألقى في وجهي سؤالاً كطلقة نافذة: “ما الذي تعرفه عن السرطان والخُزَع النُّخاعية وآلام الأدوية وأوجاع المرضى حتى تأتي لتنبش أوجاعي؟!”.
شخصتُ إليه وهلة، لا أنطق ولا أطرف. سمعتُ نفسي تقول لي بصوت لا يسمعهُ أحد غيري: “لقد وقعت في الفخ! آن أن تعترف”.
ترددتُ، ثم بصوت مرتعش قُلت: “بلى أعرف كل ذلك”.
دحرج نحوي نظرة استغراب ليستفزني لمواصلة الحديث، فقلتُ: “كان ذلك صباح التاسع من آب/ أغسطس 2019، عندما اجتاحت الحُمّى جسدي، وفَشِلَت جميع الأسلحة المضادة في التصدي لها، حينها غرس الطبيب خنجرهُ في منتصف صدري، مفتشاً عن عينةٍ من نخاع العظم، فجاءت النتيجة لتؤكد أن اللوكيميا الخبيث قد استوطن هذا الجسد الهزيل، ونشر مرتزقته بين دمي، لتبدأ بعد ذلك رحلة العناء بحثاً عن الأدوية المناسبة، في وطن تستبيحه مافيا التهريب”.
استوى أبو عبدالله في جلسته، وقد تغيرت ملامحه، ثم سألني بنبرة خفيضة: “وكيف وضعكَ معه الآن؟!”.
أجبتهُ: “صِرنا أصدقاء لا نفترق”.
ارتسم طيف ابتسامة شاحبة في وجهه، ثم قال: “ابني عبدالله كان هو الآخر قد صار صديقاً للوكيميا، الذي رافقه ثلاث سنوات ونصف السنة، ذقنا فيها العذاب بكل تفاصيله، حيث أُصيب بهذا الداء اللعين وعمره عام ونصف، وحين بلغ الخامسة كان المرض قد انحسر مهزوماً إلا من بعض فلوله”.
والد عبدالله: زوجتي رحلت بسكتة قلبية عندما تعرض نجلها للانتكاسة
عبدالله هو الرابع بين إخوته الخمسة. قبل أكثر من ثلاث سنوات قدم مع والديه وأشقائه، من محافظة حجة، إلى صنعاء بحثاً عن علاج لـ”اللوكيميا”، وتم علاجه في قسم لوكيميا الأطفال في مستشفى الكويت. تعافى من المرض بنسبة 90٪ وفقاً لوالده، ولم يكن يتبقى سوى جرعة واحدة، عبارة عن “خُزعة” في الظهر، لأخذ عينة من نخاع العظم، بهدف التأكد من نجاح الأدوية في القضاء على السرطان.
يقول الأب: “قد كان عبدالله بخير ولم يعد يستخدم الجرعات الدورية إلا في الشهر أو الشهرين مرة واحدة، وذلك اليوم، أواخر (أيلول) سبتمبر 2022، ذهبنا إلى المستشفى لنعمل آخر خُزعة (جرعة)، وكان عبدالله يومها سعيداً ومرتاحاً، لأنه تحرر من كابوس بغيض.
في المستشفى (والحديث مازال بلسان الأب) استشعر عبدالله الخوف، بمجرد أن أدخلوه غرفة العمليات الصغرى التي يتم فيها عمل خُزعة لأطفال اللوكيميا، وكانت هذه أول مرة يكون خائفاً ويصرخ لي: أخرجني من هُنا، لأنهم سيموتوني”.
لم يغادر الطفل المستشفى كما كان مخططاً له. “عملوا له الخُزعة، وبدلاً من أن نعود إلى البيت، كالعادة، بقينا في المستشفى، حيث حصلت له مضاعفات مباشرة: أُصيب بالحُمى والصداع وطرش شديد. استمر من وقت الجرعة ظُهراً حتى المغرب، ولم يكن في المستشفى سوى الممرضين، فتواصلت بالهاتف مع الطبيبة وأخبرتها بالأمر، وكان أن وجهت الممرضين بأن يعطوه مغذية؛ ولكن وضعه استمر كما هو، فأدخلوه قسم الرقود، دون أن يفيدونا بأي معلومة”.
صرخات استغاثة
في اليومين الثاني والثالث زاد الوضع سوءاً. الطفل مستمر في الصراخ من ألم يكاد يشق رأسه، وتطور الأمر إلى تصلُّب في العنق، أعجزه عن تحريك رأسه أو الالتفات يميناً أو شمال. كان يحاول الاستغاثة بوالده، يُناديه: “يا اباه غير عليَّ!”. يسمع الأب صرخات الاستغاثة، فتُمزق خناجر الألم والحيرة نياط قلبه. يلجأ إلى الأطباء للسؤال عن سبب ما وصل إليه فلذة كبده، فيأتي الرد: “لا تقلق، هو في تحسُّن”.
يقول والد عبدالله: “كانوا يعطونه منوماً من أجل أن ينام، فنُصدِّق أنه تحسَّن، حين نرى أنه هدأ ونام، ثم في اليوم الرابع دخل الطفل في غيبوبة استمرت من الصباح حتى المغرب”.
اختنقت الكلمات في حلق “خموسي” وهو يسترجع في ذاكرته اللحظة العصيبة، ثم أكمل الحديث وهو يحارب طيف دمعة ظهرت بمقلته: “قالوا: أنقذ ابنك”. سألتهم: أيش يعني أنقذه؟! ما حصل له؟! فكان ردهم: “الآن أنقذه وبعدين نتكلم”. وحوّلونا إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة، رافضين أن يعطونا ملفه الطبي أو تقريراً أو أي أوراق تشرح حالته الصحية، واكتفوا بالتواصل مع المستشفى الخاص، الذي قام هو الآخر بعمل عدة فحوصات لعبدالله بمجرد وصولنا، ورفض أيضاً أن يُسلمنا نتائج الفحوصات”.
ثلاثة أيام ونصف نهار أمضاها الطفل في العناية المركزة، وكان سائل من “القيح” يخرج من فمه، وحين يسأل الأب الأطباء عن سبب هذا القيح، يقولون: ليس قيحاً وإنما لُعاب.
في منتصف اليوم الرابع، انطفأ نبض عبدالله إلى الأبد، بالتزامن مع انطفاء قلوب عدد من أقرانه تم إعطاؤهم الخُزعة الملوثة ذاتها، وتم تفريقهم على العنايات المركزة في مستشفيات عدة بالأمانة، طبقاً لأحاديث متطابقة أدلى بها لصحيفة “لا” عدد من أولياء أمور الأطفال الضحايا.
يقول والد الطفل عبدالله خموسي إن الطبيبة المختصة بعلاج نجله في مستشفى الكويت جاءت إليه أثناء تواجد عبدالله في العناية المركزة بالمستشفى الخاص، وطلبت منه المسامحة: “جاءت إلى عندنا وقالت: المسامحة! سألناها: على أيش؟! قالت: المهم سامحونا!
عبدالله يطفئ قلب أمه
صمت الأبُ قليلاً. أسند رأسه إلى صخرة في الجدار، فتنهد الحجر، واشتعلت الشمس غضباً، حتى أوشكت أن تحرق الأرض عقاباً لصمت سكانها.
رحلة طويلة من العذاب عاشتها أسرة الطفل عبدالله، منذ بداية إصابته بالمرض الخبيث، مروراً بمرحلة تشافيه، ثم وفاته بجرعة قاتلة، وحتى اللحظة، خسروا فيها كل ممتلكاتهم، وتراكمت عليهم الديون، والأكثر وجعاً أن والدته فارقت الحياة خوفاً على فلذة كبدها، حين تعرضت صحته للانتكاسة المريعة، فرحلت متأثرة بسكتة قلبية، ليخسرها عبدالله في أشد أوقاته حاجةً لها؛ ولكنه لم ينتظر كثيراً، وحَلَّ ضيفاً عليها في العالم الآخر.
والد أويس: طلبت من المستشفى التقرير الطبي فقالوا إن هذا من اختصاص الوزير
11 طفلاً مصاباً باللوكيميا قضوا نحبهم خلال فترة امتدت بين أسبوع وعشرة أيام من حدوث جريمة إعطائهم الجرعة الملوثة في مستشفى الكويت أواخر أيلول/ سبتمبر 2022، بينما 10 آخرون حدثت لهم مضاعفات كبيرة، ومازالوا يتلقون بسببها العلاج حتى اللحظة.
من بين المُصابين بالمضاعفات الطفل أويس معتصم الوليدي، الذي أُصيب باللوكيميا وهو في الشهر الثامن من عمره، وتم إدخاله قسم الأطفال في مستشفى الكويت، حتى بدأت الحياة تبتسم في وجههِ بعد أن شارف على التعافي من المرض، طوال عام كامل أمضته أسرته ذهاباً وإياباً إلى المستشفى، إلا أن غربان الموت غاظها أن ترى وجهه ضاحكاً سعيداً، فغرزت مناقيرها السوداء في ظهره، وأطفأت فرحته، ليسود الظلام حياته وحياة أسرتهِ، التي كان هو وحيدها.
يقول والده: “كنتُ مغترباً في السعودية، عندما أخذت زوجتي ابننا أويس إلى المستشفى أواخر (أيلول) سبتمبر 2022، لأخذ خُزعة النخاع الشوكي، وعادا إلى البيت بعد أخذ الجرعة، وفي الليل أُصيب بتعب شديد وارتفعت حرارته، لا يريد الضوء في غرفته، ورقبته مُتصلبة، وجسمه خلاص، ميت!”.
صباح اليوم التالي أخذت أم أويس طفلها وذهبت به إلى المستشفى، فتم إعطاؤه أدوية خافضة للحرارة، وأخبروها ألا خوف، وأن بإمكانها العودة إلى البيت. ثم وفي مساء اليوم ذاته، تلقت الأم اتصالاً من المستشفى بضرورة إحضار الطفل في أسرع وقت.
لم تشرق الشمس صباحاً إلا وأويس مع والدته في المستشفى، وأُدخل قسم الرقود مباشرة، دون أن يُدلي الأطباء بأية معلومة، وفقاً لوالد الطفل، الذي أضاف: “في اليوم الثالث أو الرابع أرادوا تحويل أُويس إلى العناية المركزة في مستشفى خاص، فأبلغتني زوجتي بالهاتف، كانت تبكي بحرقة، لا تعلم ما الذي حدث لطفلنا الوحيد، فأخبرتها ألا تنقله إلى أي مستشفى، وأن تُبقيه في مستشفى الكويت ليتحملوا المسؤولية”.
طلب الوليدي من زوجته أن ترسل له اسم أو تركيبة الدواء الذي يحتاجه نجله، ليشتريه من السعودية ويأتي به؛ لكن الأطباء في المستشفى، وفقاً للوليدي، رفضوا رفضاً قاطعاً إعطاءها أية معلومة عن الدواء أو أي تقارير طبية عن حالته. “حتى ملفات المرضى اختفت من داخل المستشفى”.
اضطر معتصم الوليدي أن يترك عمله في بلاد الغربة، ويبيع سيارة يمتلكها بمبلغ يتجاوز 50 ألف ريال سعودي، حتى يتمكن من الخروج إلى صنعاء. “أتيت إلى صنعاء في إجازة طارئة، وجلست 9 أيام أمضيتها عند باب العناية المركزة بمستشفى الكويت، طالبتهم خلالها بأن يسلموني ملف ابني، فرفضوا، والتقرير الطبي قالوا: هذا من اختصاص وزير الصحة”.
أمضى الطفل أويس شهرين ونصف شهر في العناية المركزة، نتيجة المضاعفات الكبيرة التي أُصيب بها، ومازال حتى اليوم يتعالج من أضرارها: “الجرعة الملوثة سببت له مضاعفات خطيرة يمكن أن تؤثر في حياته مستقبلاً، حيث أُصيب بشحنات كهربائية، وجاء له مثل الصرع، حتى عيناه حصل لها ما يشبه الحَوَل، وحتى الآن مازال يستخدم العلاجات، وكل يومين ثلاثة نأخذه المستشفى”.
توقف الوليدي عن الحديث. أطرق قليلاً، ثم رفع رأسه، فإذا دمعة تتدحرج في مقلتيه. جسارته بدأت تضعف، قبضة من حديد أحسها جاثمة على صدره، ثم أبحر في وجهي وكأنه لا يراني، وقال: “أويس يموت كل يوم، وأنا ووالدته نموت معه! ضاعت أعمالنا وأعمارنا. بعنا ما فوقنا وما تحتنا، والآن نخوض شريعة طويلة، مع غرماء رفضوا تنفيذ توجيهات البرلمان والحكومة والمحكمة بدفع التعويضات. وجهنا المناشدات لقيادات الدولة وعلى رأسهم المشاط، دون فائدة، هم مستقوون بنفوذهم وجبروتهم، ونحن نستعين عليهم بقوة الله، فهو وحدهُ يعلم أننا عانينا الكثير، حتى نوم الليل ما ذقناه”.
أم فاتن: قتلونا كلنا مش فاتن وحدها
بخطى متلكئة، متثاقلة، تُنتزَع من الأرض انتزاعاً، أقبلت أم فاتن، حاملة بيديها صورة مكتوباً عليها: “الشهيدة فاتن ثابت الحوري، إحدى ضحايا جرعة السُّم بوحدة اللوكيميا بمركز السرطان مستشفى الكويت”.
تهاوت الأم على الأريكة وتحلقت حولها ثلاث وردات من زهور الجنة، هُن بناتها: “إكرام”، “جنى”، و”حلا”. كانت فاتن هي الوردة الثالثة بعد “جنى” وقبل “حلا”.
وكبقية الأطفال، عندما أُصيبت فاتن بالسرطان الخبيث تم إدخالها مستشفى الكويت، وكانت في الخامسة من عمرها، ليستمر علاجها عاماً ونيفاً، إلا أنها تميزت عن الكثير من الأطفال، المصابين بالمرض ذاته، بعزيمتها القوية وشجاعتها في مواجهة المرض.
تقول الأم: “تم علاج فاتن بالجرع الكيماوية، حتى سقط شعر رأسها كاملاً، وأصبحت صلعاء، والأطفال يتندرون عليها حين تخرج كاشفة الرأس؛ لكنها كانت قوية، لا تتأثر بتندرهم. ورغم صغر سنها إلا أنها كان لديها وعي بأن هذا المرض يحتاج إلى أن تقاومه وأن تكون معنوياتها عالية”.
نجحت الطفلة، وبمساعدة أسرتها، في مقارعة المرض اللعين، وتحسنت صحتها كثيراً، وعاد السواد إلى رأسها، وأصبح إعلان شفائها تماماً قيد جرعة. “في اليوم الذي ذهبنا إلى المستشفى لعمل آخر جرعة أو خُزعة، كانت فاتن لحظة عمل الخُزعة تبكي بشدة، على غير العادة، ففي المرات السابقة كانت ترفض حتى أن يتم تخدير موضع الخُزعة، تقول للأطباء: لا أريد تخدير، صِرتُ متعودة على الخُزعة!”.
انتقل بكاء الطفلة إلى المنزل، حيث داهمتها المضاعفات منتصف الليل، وهي المُضاعفات نفسها التي تعرض لها بقية الأطفال، ليتم إعادتها في اليوم التالي إلى المستشفى وإدخالها قسم الرقود، والسيناريو ذاته الذي حدث مع جميع الأطفال من ضحايا الخُزعة الملوثة، حدث أيضاً مع أسرة فاتن: إخفاء المعلومات والفحوصات، الامتناع عن تسليم الملف أو التقرير الطبي، وعندما زادت الحالة سوءاً، أحالوها إلى العناية المركزة في مستشفى آخر.
تقول الأم: “خلال فترة الرقود في مستشفى الكويت، كنت مع أهالي بقية الأطفال نسأل الأطباء: أيش حصل مع أطفالنا؟ فيقولون إن الأمر عادي وسبق أن حصل قبل أربع سنوات، ولا داعي للخوف... لكننا كنا نشعر بخطورة الأمر من خلال القلق الظاهر على وجوههم، وبقائهم في المستشفى على غير العادة، حتى أنهم كانوا ينامون هناك”.
بصعوبة تواصل أم فاتن الحديث: “نقلناها ليلاً إلى العناية المركزة في المستشفى الآخر، وفي اليوم التالي ذهبت لرؤيتها، كانت بحال أفضل من اليوم السابق، تكلمت معي وحاولت أن تبتسم حين رأتني، وتلك كانت آخر مرة سمعت فيها صوتها، ففي اليوم الذي يليه، أخبرونا أنها تُنازع الموت. قتلونا كلنا، مش فاتن وحدها”.
صمتت الأم. أمسكت رأسها بيديها كأنما تحاول أن تحبسه عن الفرار. تهدّج صوتها. كل نَفَس يخرج من رئتها يُهسهس باسم فاتن. الوحشة أرخت ظلالها، رغم أن الشمس تلك اللحظة عامدت الأرض في كبد السماء.
بقيت صامتاً مطرقاً، مظلم الحس، بلا ضوء، أرنو إلى الجدار، أُفتش عن ثغرة أتسرب منها، فتتلقفني نظرات الصغيرات الثلاث، مُثقلة بأحزان كالجبال. أردتُ كسر هذا الصمت الضاج، بالحديث مع الطفلة “جنى” التي تكبر فاتن بعام واحد، سألتها بغباء: هل تذكرين فاتن؟
أومأت برأسها “نعم” وقالت: “كنا نلعب الغميضة والملاحقة، وعندما تمرض أجلس أحكي لها القصص و...”.
صمتت هنيهة، ثم أضافت: “بعد موتها افتقدتُها كثيراً، وهي أيضاً تشتاق لي، لذلك تأتي لزيارتي ليلاً ونحن نيام، فنتحدث ونلعب...”.
أطبقت الطفلة شفتيها وتركت الحديث لعينيها. دموع “جنى” حرضت حتى الجدران على البكاء معها. لم أستطع البقاء، خرجتُ مهرولاً، أطوي الشوارع والشمس تجري ورائي تحمل سيخاً نارياً في يدها.
رابط الحلقة الأولى من التحقيق
👇

.jpg)












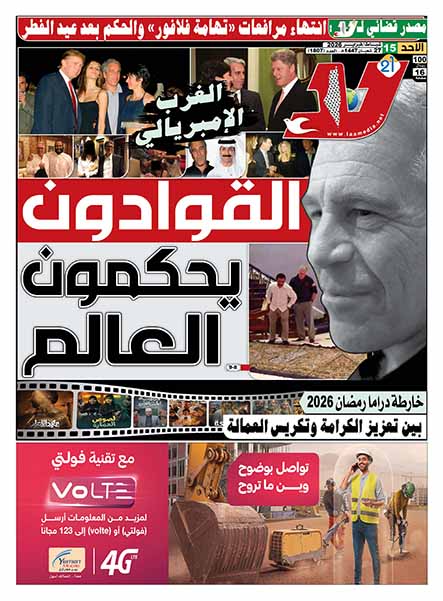
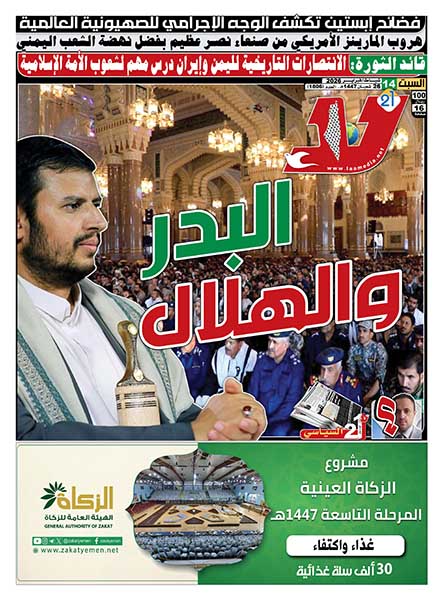


المصدر عادل عبده بشر / لا ميديا