إسماعيلياً في عهد الفاطميين ومالكياً فـي عهد المماليك ومطبعاً في عهد المطبعين.. الأزهر «ما في جبتي هذه إلا السلطة»
- تم النشر بواسطة نشوان دماج / لا ميديا

نشوان دماج / لا ميديا -
إن أي مؤسسة دينية هي في النهاية صناعة السلطة الحاكمة. فمأسسة الدين معناها أن هذا الحاكم أو ذاك يكون قد أراد للدين أن يتحول إلى جهة رسمية في دولته، وبالتالي إلى سلطة من سلطاته. وهكذا لن تجد مؤسسة دينية إلا وموقفها هو موقف السلطة الحاكمة، بدءاً من الكنيسة وليس انتهاء بأي مؤسسة دينية إسلامية، كالأزهر مثلاً.
قد يحدث لتلك المؤسسة أن تشعر في لحظة من اللحظات بأنها قد أصبحت مستقلة بذاتها من الناحية المادية ولم تعد تعتمد على هبات أو مخصصات تدفعها السلطة الحاكمة لتسيير أمورها، فتبدأ بالاستقلالية نوعاً ما في القرارات، مما قد يجعلها تصطدم في النهاية مع السلطة الحاكمة التي تشعر
بخطورة الأمر.
بداية إسماعيلية
إذا نظرنا إلى تاريخية الأزهر، سنجد أن تأسيسه كان في عهد الفاطميين، أي أنه بالضرورة لم يكن سوى لسان حال الدولة الفاطمية. حيث تقول المصادر التاريخية إنه «تم إنشاء الجامع الأزهر على يد جوهر الصقلي قائد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله في 24 جمادى الأولى 359هـ الموافق 4 أبريل 970م أي بعد عام من تأسيس مدينة القاهرة، واستغرق بناؤه ما يقرب من 27 شهراً، حيث افتُتِح للصلاة في يوم الجمعة 7 رمضان 361هـ الموافق 21 يونيو 972م، وما لبث أن تحول إلى جامعة علمية، وأُطلق عليه اسم الجامع الأزهر؛ نسبة إلى السيدة فاطمة الزهراء التي ينتسب إليها الفاطميون على أرجح الأقوال».
ولا تنسى المصادر أن تضيف أنه سرعان ما أصبح الأزهر مركزاً للتعليم، وتخرج منه التصريحات الرسمية وتُعقد به جلسات المحاكم، وأصبحت التعاليم الباطنية الخاصة بالمذهب الإسماعيلي -والتي كانت تعاليم سرية لفترة طويلة- متاحة لعامة الناس في الأزهر، وقد عين المعز القاضي النعمان بن محمد القاضي، مسؤولاً عن تدريس المذهب الإسماعيلي، وكانت بعض الفصول تُدرَّس في قصر الخليفة، وكذلك في الأزهر، مع دورات منفصلة للنساء، وخلال عيد الفطر عام 973، رُسِّمَ المسجد مسجداً رسمياً لصلاة الجماعة في القاهرة بأمر من الخليفة المعز وابنه عندما أصبح بدوره الخليفة، وجعلوا خطبة الجمعة خلال شهر رمضان في الأزهر.
وبالتالي ظهور الأزهر كان مرتبطاً بالفاطميين وتعبيراً عن مذهبهم الإسماعيلي الذي كان هو مؤسسته الدينية الرسمية. حيث «كانت دروسه تعطى بتكليف من الدولة ويؤجر عليها العلماء والمدرسون. وألقي أول درس فيه في شهر صفر سنة 365هـ/ 975م على يد علي بن النعمان القاضي في فقه الشيعة، وفي سنة 378هـ/ 988م قررت مرتبات لفقهاء الجامع وأعدت دار لسكناهم بجواره وكانت عدتهم خمسة وثلاثين رجلاً».
صلاح الدين عطل الأزهر للقضاء على المذهب الشيعي
ولو قدر للدولة الفاطمية أن تعيش مدة أطول، لظل الأزهر على حاله مرتبطاً بها ومعبراً عن مذهبها. لكن ما سيحدث هو أن الدولة الفاطمية أفلت ليرثها الأيوبيون بقيادة صلاح الدين. فكان لا بد لتلك التغيرات السياسية أن تلقي بظلالها على الأزهر. ولن يتوقع أحد غير ذلك. فبعد سقوط الدولة الفاطمية في الثالث من المحرم 567هـ/ 11 سبتمبر 1171م «أفل نجم الأزهر على يد صلاح الدين الأيوبي الذي كان يهدف من وراء ذلك إلى محاربة المذهب الشيعي ومؤازرة المذهب السني». وأول ما فعله صلاح الدين هو أنه «عطَّل صلاة الجمعة في الجامع الأزهر وأنشأ عدة مدارس سُنِّيَّة لتنافسه في رسالته العلمية للقضاء على المذهب الشيعي في مصر، واستطاع بهذه الخطوة أن يعيد إلى مصر المذهب السُّني بحيوية ونشاط، فانتهت بذلك علاقة الجامع الأزهر بالمذهب الشيعي».
ولعل في إهماله من قبل الأيوبيين تعبيراً عن أن تلك المؤسسة التي لا شك أنها كانت ماتزال على الخط الفاطمي، لم يكن ثمة من حاجة إليها بالنسبة لصلاح الدين، فهو آت من مذهب آخر، أي من مؤسسة دينية أخرى، بالإضافة إلى أن صلاح الدين لم يكن على وفاق مع الدولة الفاطمية التي ورثها أو بالأصح كان هو من أجهز عليها، وبالتالي كان لا بد له من أن يشيح ببصره عن الأزهر «الشيعي» ويلتفت إلى الفسطاط «السني» الذي بناه عمرو بن العاص، بالإضافة إلى ما بناه هو من مدارس تخدم مذهبه.
أفول الأزهر كمركز تعليم ديني
كان صلاح الدين الأيوبي الذي أطاح بالفاطميين عام 1171 معادياً لمبادئ التعاليم الشيعية التي رُوِّجَت في الأزهر أثناء الخلافة الفاطمية، لذلك أُهمِل المسجد خلال حكم السلالة الأيوبية لمصر، وحظر صدر الدين بن درباس الصلاة فيه، وهو قاضٍ عين من قبل صلاح الدين الأيوبي، وهذا المرسوم قد يكون بسبب الفقه الشافعي الذي يرى بعدم جواز خطبتين في بلد واحد، وقد يكون بسبب عدم الثقة في الجامع باعتباره مؤسسة شيعية، وأصبح مسجد الحاكم بأمر الله هو المسجد الذي تُجرى فيه صلاة الجماعة وخطبة الجمعة في القاهرة.
بالإضافة إلى تجريد الأزهر من مركزه كمسجد صلاة الجماعة، أمر صلاح الدين الأيوبي أيضاً بإزالة شريط فضة أدرجت فيه أسماء الخلفاء الفاطميين عليه من محراب المسجد.. كما أفل نجم الأزهر كمركز للتعليم الديني، فسُحِبَ تمويل الطلاب، ولم تعد دروس الفقه تعقد في المسجد، واضطر الأساتذة الذين ذاع صيتهم في عهد الفاطميين إلى البحث عن وسائل أخرى لكسب عيشهم. كما تعرضت مكتبة المسجد الضخمة للإهمال، ودمرت مخطوطات التعاليم الفاطمية التي كانت تُدرَّس في الأزهر.
انكفاء بانتظار سلطة حاكمة تعيد إليه اعتباره
لا شك أن فترة الركود التي عاشها الأزهر منذ حكم الأيوبيين وحتى مجيء المماليك قد جعلته مستعداً لأن يتخلى ليس فقط عن إسماعيليته أو فاطميته، بل وأن يطوع نفسه وفقاً لمقتضيات سلطة الأمر الواقع. ولربما أن موقفاً سلبياً كان قد اتخذه الأزهر تجاه الدولة الأيوبية عند صعودها أو في بداية تكونها هو الذي جعل صلاح الدين يهمله تماماً ويبطل دوره المؤسسي نهائياً في دولته، ولو أن الدولة الأيوبية أعادت النظر في قرار صلاح الدين أو موقفه من الأزهر لرأينا الأخير قد استجاب للمتطلبات التي تقتضيها مرحلة الأيوبيين. وربما أن هذا الموقف قد دفع ثمنه الأزهر مرة واحدة ولمدة مائة عام هي عمر الدولة الأيوبية، ولم يعد مستعداً لأن يدفع ثمن موقف مشابه مرة أخرى مع المماليك. فكان للأزهر خلال تلك الفترة أن تنتهي علاقته بالمذهب الشيعي ويعاد «إلى مصر المذهب السُّني بحيوية ونشاط».
كان على الأزهر إذن أن ينكفئ طيلة مدة الحكم الأيوبي، لكن ليس على حالته الفاطمية وإنما انكفاء المنتظر لسلطة حاكمة تعيد إليه اعتباره الذي فقده عند الأيوبيين مدة مائة عام بأكملها، ولم يعد مهماً بالنسبة له حينها أن يحدث تحول ما في بنيته المذهبية، فجاء المماليك ليكونوا هم من انتظره الأزهر بفارغ الصبر ويكون هو المعبر عن سلطتهم الشرعية كحكام جدد.
مؤسسة دينية بلباس السلطة
لم يلبث أن انتفض الأزهر من رماده كطائر الفينيق بعد فترة الركود التي أصابته، لينهض بدوره كمؤسسة دينية، لكن بلباس جديد فصّلته له السلطة الحاكمة الجديدة، أو كان هو قد تهيأ للأمر وبدل جلده من «مؤسسة لنشر المذهب الشيعي الإسماعيلي» إلى مؤسسة دينية توافق مذهب السلطة الجديدة. حيث «أعيد إقامة الصلاة في الأزهر أثناء حكم المماليك بأمر من السلطان بيبرس في 1266، ومع التوسع السريع في القاهرة، والحاجة إلى دور المسجد، قام السلطان بيبرس بتجاهل تاريخ الأزهر كمؤسسة لنشر المذهب الشيعي الإسماعيلي، وأمر بعودة رواتب الطلاب والمعلمين، فضلا عن بداية العمل لإصلاح المسجد، الذي أهمل منذ ما يقرب من 100 سنة. ووفقا للمفضل، فإن الأمير عز الدين أيدامور الهيلي بنى منزله بجوار المسجد، لمراقبة أعمال الإصلاح. وقد ذكر تقي الدين المقريزي أن الأمير أصلح الجدران والسقف، ووفَّر الحصير الجديد. وألقيت الخطبة الأولى منذ عهد الخليفة الفاطمي الحاكم في 16 كانون الثاني/يناير 1266، وقد ألقيت الخطبة على منبر جديد انتهى تجهيزه قبل الخطبة بخمسة أيام.
على أن ما تأسس في عهد الدولة الأيوبية من مدارس «سنية» لضرب الأزهر، جعلت الأخير في عهد الدولة المملوكية ليس صاحب السيادة الكاملة أو ليس المؤسسة الدينية الواحدة للدولة، لكنه مع ذلك عاد «ليؤدي رسالته العلمية ودوره الحيوي، فعين به فقهاء لتدريس المذهب السني والأحاديث النبوية وعني بتجديده وتوسعته وصيانته فعد ذلك العصر الذهبي للأزهر، كما أظهر الحكام والأعيان في العصور التالية اهتماماً ملحوظاً بترميمه وصيانته وأوقفوا عليه أوقافاً كثيرة».
كان لتلك «الأوقاف الكثيرة» التي أوقفت عليه من قبل الحكام والأعيان خلال فترة المماليك أن جعلت الأزهر يفكر بالحيثيات التي تبقيه غير معتمد كلياً على السلطة الحاكمة، فلا يكون رهن مزاجها إن هي تغيرت وجاء حكام جدد، مستفيداً من الدرس الذي لقنه إياه الأيوبيون، بحيث عندما جاء العثمانيون سنة 1517م لم يكن له أن يخشى رحيل المماليك.
الأزهر تحت عباءة الأتراك
تقول المصادر إن الأتراك أظهروا احتراماً كبيراً للأزهر، على الرغم من توقف الرعاية الملكية المباشرة له، فقد حضر السلطان سليم الأول بعد دخوله إلى مصر صلاة الجمعة في الجامع الأزهر، وذلك خلال الأسبوع الأخير له في مصر، كذلك كان يحضر الأمراء العثمانيون بانتظام لصلاة الجمعة في الأزهر، ولقد وفَّر العثمانيون رواتب للطلاب والمعلمين؛ فكان للأزهر خلال العهد العثماني أن يستعيد مركزه كأكبر مؤسسة تعليمية في مصر، متجاوزا المدارس الدينية التي أسسها صلاح الدين الأيوبي. وتضيف المصادر أنه خلال تلك الفترة، شهد الأزهر أول شيخ له ليس من المذهب المالكي وهو عبدالله الشبراوي الشافعي المذهب، بحيث لم يعد منصب شيخ الأزهر من المالكية حتى عام 1899 عندما أصبح سليم البشري شيخاً للأزهر.كان الأتراك يدركون خطورة ألا يحتووا الأزهر، باعتباره قد يشكل نقطة محورية للاحتجاجات ضد الولاة سواء داخل أوساط العلماء أو داخل أوساط الطلبة أو من عامة الناس. ولذا كانوا يغدقون عليه لكسب موقفه الذي لم يكن معارضاً على أية حال، لكن قد يحدث بعض المناوشات والاحتجاجات الطلابية أو الشعبية منطلقة من الأزهر، كاضطراب عام 1791 والذي تسبب فيه مضايقات الوالي قرب مسجد الإمام الحسين، ثم ذهب إلى الأزهر لتبرير موقفه. وقد أقيل الوالي بعد ذلك من منصبه.
لكن ذلك لا يُخرج الأزهر من كونه ظل مرتبطاً ومقرباً من الولاة العثمانيين، وخير دليل على ذلك ما شهده الأزهر في العهد العثماني على يد الأمير عبدالرحمن كتخدا، فقد خصه بالمال الكثير.
الحال نفسه مع غزو نابليون لمصر، فعلى الرغم من إبداء الأزهر مقاومة للحملة الفرنسية طيلة الفترة من 1213/1216هـ الى 1798/1801م، لم يمنع ذلك علماء الأزهر من الاتصال بنابليون الذي أنشأ ديواناً يتكون من تسعة من شيوخ الأزهر، وكلفهم بإدارة القاهرة، وهي أول هيئة رسمية من المصريين منذ بداية الحكم العثماني. فكان للأزهر أن يسوّق شخصية نابليون بين المصريين فحظي الرجل باحترام كبير ولقب بـ»السلطان العظيم». لكن سرعان ما ستسوء الأمور بين المصريين والفرنسيين، حيث سيتم في مارس 1800 اغتيال الجنرال الفرنسي جان بابتيست كليبر على يد سليمان الحلبي، وهو طالب في الأزهر. فأمر نابليون بإغلاق المسجد، وظلت أبوابه مغلقة حتى وصول المساعدات العثمانية والبريطانية في أغسطس 1801، تزامناً مع انسحاب الحملة الفرنسية.
محمد علي يحد من نفوذ الأزهر
بعد انسحاب الفرنسيين، قام الوالي محمد علي بتعيين نفسه خديويا على مصر، وسعى إلى الحد من نفوذ شيوخ الأزهر بتوزيع المناصب داخل الحكومة لأولئك الذين تلقوا تعليمهم خارج الأزهر. وبعث الطلاب إلى فرنسا تحديداً، لينشؤوا تحت نظام تعليمي غربي، وقام بإنشاء نظام تعليمي يستند إلى هذا النموذج ضمن توجهه نحو الاستفادة من العلوم العصرية الحديثة، الأمر الذي جعل المؤرخين يتحدثون عن تقدم شهدته مصر فكرياً وعلمياً في عهده، وبقي الأزهر في معزل عن هذا التحول، فأصابه الركود وضعف تأثيره وهيبته، غير أن محمد علي اختار طائفة من نوابغ الأزهر مثل رفاعة الطهطاوي وإبراهيم النبراوي وغيرهما وأوفدهم في مقدمة البعثة العلمية إلى باريس سنة 1242هـ/ 1826م.
وفي عصر الخديوي إسماعيل ظهر تأثير الحركة الإصلاحية الجديدة فقد أيقظ جمال الدين الأفغاني، الذي وفد إلى الأزهر، المشاعر والعقول وحرر الفكر من الجمود الذي ران عليه.
كما بدأت الأفكار التي ينادي بها العديد من الإصلاحيين تزداد في مدخل القرن العشرين، أمثال محمد عبده ومحمد الأحمدي الظواهري وغيرهما من المفكرين، وأخذت هذه الأفكار تترسخ في الأزهر، وفي عام 1928 عُيِّن محمد مصطفى المراغي شيخاً للأزهر وهو من أتباع محمد عبده. وقد عارضت الغالبية العظمى من العلماء تعيينه، وبدأت إدارة المراغي وخلفائه سلسلة من الإصلاحات والتحديثات التي طرأت على المسجد وجامعته، وتوسيع المناهج التعليمية خارج إطار الموضوعات التقليدية. وقد كره الملك فؤاد المراغي، وقام باستبداله بعد سنة واحدة من تعيينه وعين الظواهري مكانه، ولكن المراغي عاد إلى منصبه شيخاً للأزهر في عام 1935، وظل بمركزه حتى وفاته في عام 1945. وتحت قيادته وُسِّعَت مناهج الأزهر لتشمل لغات غير العربية والعلوم الحديثة.
صدام الأزهر مع الضباط الأحرار
كان سعي الأزهر هو الاستقلال عن الدولة ورفض تغول السلطة على مؤسسة الأزهر، فيما سلط بعض حكام مصر من خلفاء محمد علي الضوء على الأزهر، إلى أن جاءت ثورة يوليو عام 1952م، فكانت تأريخاً جديداً للأزهر، حيث وضعت الثورة يدها على الأزهر وجعلته مؤسسة حكومية مثله في ذلك مثل بقية الهيئات التي أُممت.
اتسم موقف الأزهر من حركة الضباط الأحرار بالصدام، وإن كان محدوداً، تجلى في وقوع بعض المصادمات بين بعض مشايخ الأزهر ونظام يوليو بعد قانون تطوير الأزهر ومادة الدين الإسلامي الغائبة في دستور الوحدة 1960.
اعتقد بعض المشايخ أن القانون يخرج الأزهر عن رسالته الشرعية في الحفاظ على علوم الدين، فيما كان عبدالناصر له هدف آخر من وراء هذا التطوير، وهو مواجهة النشاط التبشيري في أفريقيا بين الشعوب الوثنية حيث كانت فكرة عبدالناصر تدور حول أن يذهب الطبيب الأزهري والمهندس الأزهري والمدرس الأزهري وهكذا ليقوموا بالدورين، أي الدعوة من خلال الخدمة وتلبية احتياجات الناس.
الأزهر يبرر التطبيع الساداتي
وإذا كان عبدالناصر متصادماً مع مؤسسة الأزهر، فقد جاء السادات حريصاً على استمالة علماء الأزهر، فأصدر القرار الجمهوري رقم 350 لسنة 1975، الذي نص على أن شيخ الأزهر هو «الإمام الأكبر وصاحب الرأي في كل ما يتصل بالشؤون الدينية»؛ وأصبح شيخ الأزهر بدرجة رئيس وزراء ويتبع رئاسة الوزراء إدارياً فقط، وألغى منصب وزير شؤون الأزهر، وأضحى شيخ الأزهر يسبق بروتوكولياً الوزراء، وكان كثيراً ما يؤكد في خطاباته على دور الأزهر التاريخي في مجال «الدفاع عن الإسلام في مصر، بل والعالم الإسلامي كله».
في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1977، توجه السادات إلى «تل أبيب» وألقى خطاباً في الكنيست حول «السلام الشامل»، مستخدماً بعض العبارات العاطفية، التي لا تصلح للتأثير في الصهاينة، مثل: الإشارة إلى أن إبراهيم هو جدّ العرب واليهود، واقتران زيارته بعيد الأضحى.
قوبلت زيارة السادات بغضب عربي وإسلامي شديد، لكن شيخ الأزهر حينها، محمد عبدالرحمن البيصار «اجتهد» في إعطاء التبريرات الشرعية لإبعاد صفة الحرمة عن هذا الفعل غير المسبوق. اللافت أنه في الوقت الذي أفلح فيه السادات بأخذ غطاء من الأزهر لزيارته الكنيست، وتالياً توقيع اتفاقية كامب ديفيد، فقد فشل في انتزاع هذا الغطاء من البابا شنودة الثالث، الذي رفض الموافقة على اتفاقية كامب ديفيد، فضلاً عن زيارة السادات للكنيست، قبل حل القضية الفلسطينية.
والحقيقة أنه لم يكن هذا الموقف هو الموقف الوحيد المستغرب للأزهر، فقد وافقت مشيخة الأزهر في عهد الشيخ عبدالحليم محمود على الصلح مع «إسرائيل» باعتباره «حلالاً».
لم يصدر الأزهر فتوى بتحريم اتفاقية كامب ديفيد؛ رغم إهدارها نصر حرب العام 1973 وإنقاصها السيادة المصرية، وإلزامها مصر بتأمين العدو الصهيوني وسلامته وعدم تهديده من أي طرف آخر (واقع معبر رفح لاحقاً على سبيل المثال). وأهم من ذلك كله، أن هذه الاتفاقية شكّلت الصلح الأول مع العدو، خلافاً لموقف لجنة الفتوى في الأزهر عام 1956، برئاسة الشيخ حسنين مخلوف، التي حرّمت فيه هذا الصلح بشكل واضح.
كان لشيخ الأزهر محمد سيد الطنطاوي العديد من المواقف والفتاوى المستهجنة، فهو مثلاً رفض إدانة الغزو الأمريكي للعراق، بل أقال أحد علماء الأزهر لإصداره فتوى بمعارضة هذا الغزو، فضلاً عن وضعه يده مع رئيس كيان العدو الصهيوني شمعون بيريز، وصولاً إلى فتوى غريبة أخرى تبرر إقامة الجدار العازل بين مصر وقطاع غزة بأن الجدار هو «لحماية مصر ضد أعدائها». كما أن الطنطاوي كان لديه موقف مؤيد للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
الطيب والإمارات
العلاقة الوثيقة التي تربط شيخ الأزهر الحالي، الدكتور أحمد الطيب، والنظام الإماراتي، وتحديداً ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، توثقت في العام 2013، بالتزامن مع التوسع في التحركات التي شهدتها مصر للإطاحة بالرئيس المصري المنتخب، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي، وهي الفترة التي شهدت تدخُّلاً إماراتياً فجّاً في الشؤون المصرية.
خلال تلك الفترة، جمعت عدة لقاءات بين الطيب، الذي سبق أن عمِل في جامعة الإمارات (حكومية)، وابن زايد. ففي أبريل/نيسان 2013، هنأ ولي عهد أبوظبي، الشيخَ «الطيب» بمناسبة اختياره شخصية العام الثقافية التي أعلنت عنها جائزة «الشيخ زايد للكتاب» في دورتها السابعة ونال بموجبها مليون درهم إماراتي (272 ألف دولار)، وفقاً لبيان صادر عن وكالة أنباء الإمارات. وسرعان ما نال الطيب مليون درهم أخرى عقب عزل مرسي، إذ فاز في يوليو/تموز من العام التالي بجائزة شخصية العام الإسلامية عبر جائزة دبي للقرآن الكريم. وفي 19 يوليو/تموز 2014، شهدت أبوظبي إطلاق مجلس حكماء المسلمين، الذي يمثل أحد أهم مفاصل العلاقة بين الإمارات وشيخ الأزهر ونقطة تحويلها إلى عملية مؤسسية. كما أغدقت الإمارات على الأزهر أموالاً طائلة خلال السنوات العشر الماضية.
أول فرع للأزهر خارج مصر وقُبلة على رأس «الإمام»
في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015، وقَّع شيخ الأزهر، ورئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات، اتفاقية لإنشاء فرع لجامعة الأزهر في الإمارات، ليصبح أول فرع للأزهر خارج مصر.
وفي يوليو/تموز 2017، داخل مجلسه الخاص في قصر البحر بالعاصمة الإماراتية، استقبل ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، شيخَ الأزهر، على هامش زيارته العاصمة الإماراتية؛ لترؤس اجتماع مجلس حكماء المسلمين. وانتهى لقاء ابن زايد والطيب بـ»قُبلة» على جبين شيخ الأزهر، الذي «أشاد بجهود دولة الإمارات ودورها في دعم قضايا الإسلام والمسلمين».
بعد إعلان دولة الإمارات إقامة علاقات رسمية مع «إسرائيل» في ما عُرف باتفاقات أبراهام في أغسطس/آب 2020، لم يحدث رد فعل من شيخ الأزهر، وأثيرت انتقادات بسبب عدم إعلان الأزهر موقفه، وطُرح تساؤل بشأن تخلي الأزهر عن دعم القضية الفلسطينية كما كان في السابق.

.jpg)








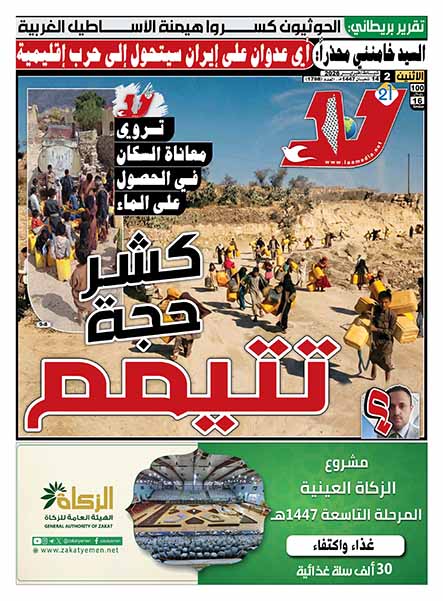







المصدر نشوان دماج / لا ميديا