الحلم العثماني من بوابة مشروع «الشرق الأوسط الجديد» الإمبريالي
- تم النشر بواسطة أحمد رفعت يوسف / لا ميديا

أحمد رفعت يوسف / دمشق/ لا ميديا -
يتم توزيع خارطة نشرها موقع «ستراتفور» الأمريكي المقرب من وكالة المخابرات الأمريكية (CIA) تظهر رؤية لتركيا في العام 2050، يمتد فيها نفوذ تركيا (في العام المستهدف) من «الشرق الأوسط» إلى البحر الأبيض المتوسط، وإلى آسيا الوسطى، وحوض بحر قزوين، حيث اليونان وجنوب قبرص وليبيا ومصر وسوريا والعراق ولبنان والأردن والسعودية وعُمان واليمن ودول الخليج وجورجيا وأرمينيا وأذربيجان وشبه جزيرة القرم وتركمانستان وكازاخستان، وتمتد إلى داخل حدود روسيا والصين عبر الأقاليم الإسلامية فيها.
قبل الدخول في التفاصيل نشير إلى بعض الملاحظات حول المناطق التي شملتها الخارطة على أنها مناطق النفوذ التركية المستهدفة وهي:
ـ لم تشمل الخارطة فلسطين المحتلة، وهذا يؤكد على ترابط أصحاب الحلم مع المشروع الصهيوني.
ـ لم تشمل تونس والجزائر التي كانت ضمن أراضي السلطنة العثمانية وهذا لم يكن عبثاً ومرتبط بما كان يعد لهذين البلدين، وكذلك المغرب الذي كان خارج السلطنة، لكنه محكوم اليوم من حزب العدالة والتنمية الشقيق بالسفاح لأخيه التركي، وبالتالي ستكون هذه الدول على ارتباط طبيعي مع الحلف التركي وتابعة له.
ـ شملت اليمن الذي عجزت السلطنة العثمانية عن السيطرة عليه بسبب مقاومة أهله الأشداء حتى سمي «مقبرة الأناضول»، وها هو المشهد يتكرر اليوم مع بني سعود.
أردوغان كأداة للمشروع الإمبريالي
وبالعودة إلى الخارطة وبعد البحث تبين أنها ليست جديدة -كما اعتقد معظم المعلقين عليها- ولم يكن عرضها عبر التلفزيون التركي قبل أيام هو العرض الأول، وإنما تم الكشف عنها لأول مرة في كتاب صدر عام 2009 بعنوان «المائة عام المقبلة»، من تأليف الباحث السياسي الأمريكي جورج فريدمان، الرئيس السابق لمركز «ستراتفور».
الكشف عن التاريخ الحقيقي لنشر الخارطة يوضح السر الكامن وراءها، لأنها تؤكد أن وضع الخارطة جاء من ضمن مشروع «الشرق الأوسط الجديد» الاستعماري (الأمريكي ـ الغربي) بإدارته الصهيونية، وكان أردوغان إحدى أدواته الرئيسية ويشغل منصب نائب رئيس هذا المشروع كما أعلن بنفسه في حشد عام لتجمع من مؤيديه.
كان الهدف الأساسي للمشروع تسليم المنطقة بالكامل للإسلام الصهيوني بجناحيه (الإخواني ـ الوهابي)، والاثنان، من صنيعة الغرف السرية السوداء للمخابرات البريطانية، تحت شعار «فليحكم الإسلام»، لكن القيادة فيه كانت للإخوان باعتبارهم الأنضج تجربة في السياسة والأكثر انتشاراً، وكان هذا المشروع من المنظور التركي بمثابة الحلم بإعادة بعث الإمبراطورية العثمانية البائدة، وهو مشروع وحلم حزب العدالة والتنمية الإخواني التركي برئاسة رجب أردوغان.
حلف المقاومة عقبة يجب إزالتها
وحتى ندرك الظروف الجيوسياسية التي مهدت لوضع الخارطة نشير إلى أن العمل للوصول إلى الهدف مشروع «الشرق الأوسط الجديد» كان يتم على مسارين:
المسار الأول: وهو الأهم، كان لا بد من إسقاط حلف المقاومة الذي كان مكوناً يومها من الثلاثي (إيران وسورية والمقاومة اللبنانية)، وكانت التقديرات تقول -وهي صحيحة- بأن إسقاط أي حلقة من حلقات الحلف كافٍ لإسقاط باقي حلقاته.
جاء غزو العراق كتمهيد لوضع مشروع «الشرق الأوسط الجديد» على سكة التنفيذ، وجرت بعدها المحاولات تارة بالسياسة وأخرى بالحروب والضغوط.
كان قتل رفيق الحريري المحاولة الأولى لضرب حلف المقاومة من خاصرته السورية مع وضع المقاومة اللبنانية في مرمى الهدف، لكن هذه المحاولة فشلت.
جاءت الخطوة الثانية من خلال العدوان الإسرائيلي على المقاومة اللبنانية عام 2006، ويومها كانت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندليزا رايس بأشد الوضوح عندما أعلنت من قلب بيروت أن ما يجري هو المخاض لولادة «الشرق الأوسط الجديد»، لكن حدث ما لم يكن بالحسبان، حيث صمدت المقاومة اللبنانية وانتصرت، وفشلت المحاولة الثانية من بوابتها العسكرية.
كان لا بد من تعديل الخطة والبدء من جديد بعد استخلاص العبر من فشل الخيار العسكري في لبنان، فكان اللجوء إلى الخيار السياسي والدبلوماسي، عبر الترغيب والترهيب، وأيضاً من الحلقة الوسطى والأهم وهي سورية، بهدف محاولة إخراجها (سلماً) من حلف المقاومة، فرأينا الانفتاح الفرنسي المفاجئ على سورية، فتمت دعوة الرئيس الأسد إلى قمة المتوسط في باريس في 13 تموز/يوليو 2008، ويومها جرت المحاولة لإسقاط الحاجز النفسي عبر إحراج الرئيس الأسد بلقاء (صدفة مدروسة بعناية) مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، واستطاع الرئيس الأسد الخروج منها ببراعة، وسقطت المحاولة.
وتجددت المحاولة الفرنسية مع سورية خلال زيارة الرئيس الفرنسي ساركوزي إلى دمشق في 2009/9/3، والقمة الرباعية التي عقدت في اليوم التالي في دمشق والتي جمعت قادة كل من سوريا وفرنسا وتركيا وقطر.
تخلل المحاولات الفرنسية جهود تركية حثيثة لرعاية محادثات سلام سورية إسرائيلية، كان أبرزها محاولة تركية فاشلة أيضاً لجمع الرئيس الأسد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في إسطنبول، لتأتي آخر المحاولات خلال زيارة الرئيس الأسد إلى باريس في 9/12/2010، ويومها حضر أمير قطر بشكل غير معلن إلى باريس للانضمام إلى الجهود الفرنسية في ترغيب وترهيب الرئيس الأسد لإخراج سورية من حلف المقاومة والانضواء في مشروع «الشرق الأوسط الجديد»، لكن هذه المحاولة فشلت أيضاً وأنقذ الرئيس الأسد بموقفه هذا المنطقة من الكارثة الحقيقية التي كانت ستسلب سورية هويتها الوطنية والقومية وستجعل منطقتنا أسوأ بأضعاف أضعاف مما هي عليه اليوم، لأن الرئيس الأسد كان يدرك أن سورية ستكون الضحية الأولى للمشروع ومعها حلفاؤها في المقاومة وفي المقدمة إيران، وأصدقاؤها الاستراتيجيون وفي مقدمتهم روسيا والصين، لأن الهدف الأساسي لمشروع «الشرق الأوسط الجديد» كان محاصرتهما ووقف الصعود الاقتصادي والسياسي للصين والعسكري لروسيا.
«ربيع عربي» لإسقاط دول المنطقة
المسار الثاني: كان يجري بالتوازي مع أحداث المسار الأول، إذ كان يجري إعداد تركيا لتكون القدوة والنموذج المطلوب لكامل المنطقة -بحسب المشروع- فوصل حزب العدالة والتنمية الإخواني برئاسة أردوغان إلى الحكم، وتم تصنيع الفورة الاقتصادية والتنموية التركية عبر ضخ أكثر من 100 مليار دولار أمريكي في الاقتصاد التركي دفع أعراب الخليج -كالعادة- معظمها.
وسط هذه الظروف أصبحت المنطقة مهيأة لبدء «الربيع العربي»، وهنا تم الكشف عن الخارطة (الحلم التركي) وعن الهدف من مشروع الإسلام السياسي وحلم العثمانية الجديدة.
مع انطلاقة الشرارة الأولى لوهم «الربيع العربي» من تونس كانت التقديرات أن كل المنطقة ستسقط كأحجار الدومينو، وهو ما حدث حتى وصوله إلى سورية.
الصمود السوري أسقط المشروع الإمبريالي ـ الصهيوني
كانت التقديرات تقول بأن سورية ستسقط في براثن «الشرق الأوسط الجديد» في فترة لا تتجاوز شهرين إلى ثلاثة أشهر، وهنا تم الإعداد لكل شيء على هذا الأساس، بدون التفكير بأي احتمالات أخرى كانت تبدو من شبه المستحيلات، وبدأت التحضيرات للاحتفال بإسقاط سورية وانتصار المشروع، وأعلن أردوغان أنه سيصلي في الجامع الأموي بدمشق منتصراً، ووضع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي والناتو موعداً للاحتفال بسقوط دمشق، لكن مرة أخرى حدث ما لم يكن متوقعاً، إذ صمدت سورية ومضت الأشهر الثلاثة الأولى ولم تسقط، وبدأ وزراء خارجية الناتو يضعون الموعد تلو الموعد للانتصار بسقوط دمشق حتى بلغت مواعيدهم السبعة ولم تسقط، فتوقفوا عن وضع هذه المواعيد ومازالوا يحلمون.
أما وقد صمدت سورية ومازالت بعد 10 سنوات صامدة، وستبقى أبد الدهر صامدة فمن الصعب التقدير اليوم أن أياً من الخريطتين «الشرق الأوسط الجديد» أو «العثمانية الجديدة» كانت ستنفذ لو سقطت دمشق، لكن المحصلة كانت واحدة وهي سقوط كامل المنطقة بيد المشروع الصهيوني الاستعماري الغربي، ولكنا رأيناها اليوم مجرد إمارات وكانتونات عرقية وطائفية تتناحر في حروب طاحنة ومجازر، كان يمكن أن تمتد لقرن من الزمن.
ولو أخذنا بالخارطة التركية (العثمانية الجديدة) فلنعترف بأنه لو سقطت سورية لكنا سنراها محققة على أرض الواقع وربما أكثر، وكنا رأينا أردوغان مصلياً صلاة الشيطان في الجامع الأموي، وكنا رأيناه يجلس اليوم في القصر الرئاسي في أنقرة والذي بني بكامل تفاصيله وضخامته لهذه الغاية، وبحرس رئاسي تم حتى تفصيل لباسه المأخوذ من التراث العثماني، ونفوذه يمتد من حدود المغرب في الغرب إلى داخل الحدود الصينية والروسية في الشرق.
أما وقد صمدت سورية وأفشلت عليهم أوهامهم وأحلامهم فقد تغير كل شيء، وبدأت ملامح منظومة إقليمية ودولية جديدة تتشكل من رحم الصبر والصمود السوري وبعكس ما كان قادة مشروع «الشرق الأوسط الجديد» يخططون ويتوهمون، ولهذا حسابات أخرى.
هل ستغفر الدول والقوى المستهدفة لأردوغان؟!
من الطبيعي أن الدول والقوى التي كان يستهدفها المشروع الأردوغاني (كما تظهر الخارطة) تدرك أهداف اللعبة وحدودها وهي لن تغفر لأردوغان توهماته، فروسيا تعرف أن الشيشان والقوقاز وغيرهم لم يتم تدريبهم في سورية للبقاء فيها وإنما مهمتهم الرئيسية على أسوار موسكو.
كما تدرك الصين أن الإيغور لم يتم جلبهم إلى سورية للبقاء فيها وإنما مهمتهم الرئيسية هي داخل الصين.
كما تدرك إيران أن الحيز الاستراتيجي في المنطقة لا يتسع لإيران قوية وتركيا قوية وأي سياسي تركي (وتحديداً أردوغان) ينظر إلى إيران وأمام عينيه معركة كالديران عام 1614 التي أسقط فيها العثمانيون الدولة الصفوية وكانت أول خطوة في طريق نشوء الإمبراطورية العثمانية.
أيضاً الأوروبيون لن ينسوا يوم طرقت الجيوش العثمانية أبواب فيينا وكادت أن تسقطها كما أسقطت القسطنطينية وغيرت وجه المنطقة.
وكما هي القاعدة في كل الصراعات فإن الخاسر يدفع كل شيء ولا عزاء له، وهو ما نتوقعه لتركيا بأن تكون في المستقبل القريب إما مقسمة أو ضعيفة بقرار إقليمي ودولي، وهذا ليس حلماً أو أمنية، وإنما هكذا هي قوانين الصراعات والحروب، لكن إدارة الصراعات والحروب تتطلب العقل البارد للوصول إلى الأهداف، وإذا كنا نرى أردوغان اليوم يلعب على هوامش التناقضات، وفي المرحلة الانتقالية، بين منظومة أمريكية غربية صهيونية تتهاوى، ومنظومة مشرقية بقيادة صينية روسية إيرانية تصعد، فإن هذا الهامش يضيق أمامه وسيبقى يضيق حتى يلتف على عنقه في مصير أين سيكون منه مصير عدنان مندريس، الذي انتهى على حبل المشنقة يوم توهم بأحلام أقل بكثير من أوهام أردوغان اليوم.. وإن غداً لناظره قريب.

.jpg)







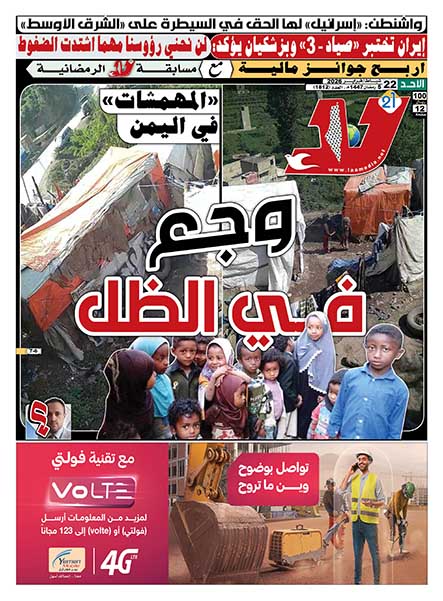




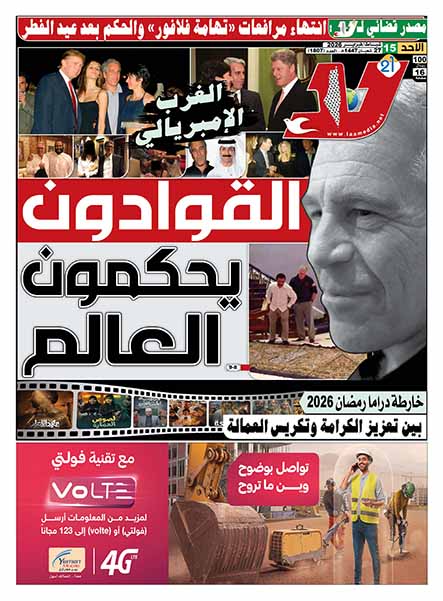


المصدر أحمد رفعت يوسف / لا ميديا