النباهـــة والاستحمــــار (الحلقة الأولى)
- تم النشر بواسطة وليد مانع / لا ميديا
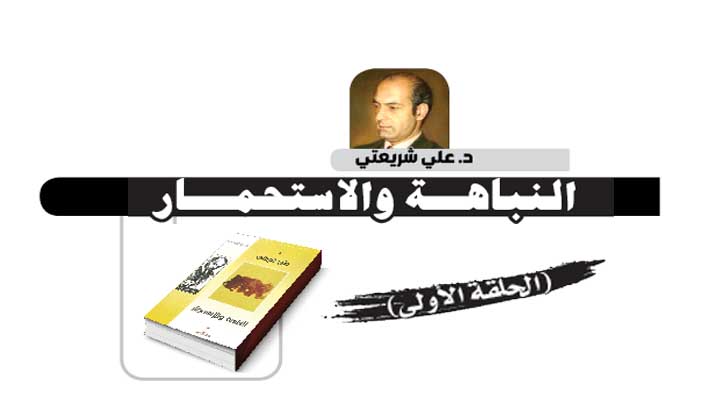
علي محمد تقي شريعتي مفكر إيراني شهير، ولد عام 1933، في خراسان. يُعدّ ملهم الثورة الإسلامية، وأحد أبرز أعلام النهضة الإيرانية.
نال شهرة واسعة، لكن المنطقة العربية، رغم أنه مدفون فيها (في دمشق)، ما تزال بعيدة وشبه مغيبة عن الاطلاع عليه ودراسته، محجوبة تحت رمال انبهارها وانجرارها وراء الغرب الاستعماري، ثقافياً وسياسياً على وجه الخصوص.
كان له من الأهمية والمكانة ما جعل جامعة السوربون، كإحدى أعرق جامعات العلوم الإنسانية في العالم، تستقطبه للتدريس فيها. ومع ذلك فإن أهميته ومكانته لا تكمن فقط في كونه مفكراً موسوعياً واسع الاطلاع على آداب وأفكار الشرق والغرب، ولا في نتاجه الفكري النظري، على أهميته وارتباطه الوثيق بالجانب الآخر من عظمته وفرادة مكانته، ونقصد به الجانب العملي.
لكنه أيضاً، وهنا بالتحديد، يكتسب فرادة ومكانة يمكن القول بأنها مزيج من مكانة الأنبياء ورواد الإصلاح الاجتماعي، وأهمية وتميُّز المفكرين والفلاسفة.
وهذا لم يتأتَّ لشريعتي من تشديده على أهمية الأبعاد والتأثيرات العملية للأفكار والرؤى والنظريات فحسب، بل ومن كونه جسّد ذلك عملياً، من خلال نضالاته وكفاحه ومواقفه التي زُجَّ بسببها في سجون ومعتقلات الداخل الإيراني، والخارج أيضا.
يكفي أن نعرف مثلاً أنه تم اعتقاله في باريس مرتين، إحداهما لمشاركته في مسيرة تضامنية مع الزعيم الأفريقي الكونغولي باتريس لوممبا، والثانية لتضامنه مع المناضلين الجزائريين، الذين ربطته بهم علاقات تعاون متينة.
في محاضراته ومؤلفاته، ناقش الكثير من القضايا الفكرية التي تفرد في إجاباته وما انتهى إليه بشأن الكثير منها.
ففي مسألة صراع الحضارات –مثلا– آمن شريعتي بما لدى شعوب العالم المقهورة والمجتمعات المستضعفة، من ذخائر وكنوز روحية ومعنوية لا ينقصها سوى الالتفات إليها وحُسن استثمارها، لتجعل من أولئك المقهورين والمستضعفين قوة قادرة على مواجهة أعتى قوى العصر المادية، بجيوشها وأسلحتها وتكنولوجيتها وأموالها...
وإذ يضع شريعتي الأمة الإسلامية بين أغنى الأمم بتلك الذخائر والكنوز، فإنه يتناول مسألة التاريخ والتراث الإسلامي بمنهجية علمية حديثة، لكنه في الوقت نفسه يتمسك بثوابت الهوية الحضارية الإسلامية، لا باعتبارها مجرد أيقونات أو رموز هوياتية، كما هي لدى الكثير من مفكرينا العرب والمسلمين، بل باعتبارها الأساس الذي لا يمكن لهذه الأمة أن تقف على أرضية سواه. وفي تناوله لهذه المسألة يصل إلى نتائج عامة أبرزها أن التشيُّع الصفوي هو الصورة الأخرى للتسنُّن الأموي، البراء منهما التسنُّن المحمدي أو التشيُّع العلوي، باعتبار الأخيرين شيئاً واحداً أيضاً.
وإذ يشيد بالكثير من النتاجات الفكرية، الغربية منها والشرقية، واليسارية منها خاصة، فإنه يعيب عليها، اليسارية منها خاصة أيضا، غالب انحباسها في دائرة النظري، وبقائها أشبه بتهويمات عالقة في الفراغ، لا قوائم لها راسخة في أرض الفعل والعمل، باعتباره الوسيلة والغاية معا.
من هنا، رأينا أن نضع بين يدي القارئ كتاب «النباهة والاستحمار» كنموذج جزئي للنتاج الفكري الذي ناضل شريعتي لأجله، متوجاً نضالاته بالاستشهاد بعد أيام قلائل من وصوله إلى منفاه في لندن، في العام 1977.
الأنا.. والمصير (مسألة وعي الوجود)
إن الحالة الخاصة التي نعيشها "نحن" و"أنا" تقتضي أن نقول كلمتنا الأخيرة أولاً، ونقرأ الكتاب من آخره. ومن هنا فإن الموضوع قد يبدو مملاً للذين لم يتعرفوا بعد على الظروف الفكرية للمسائل والقضايا التي أعرضها، فيحتاجون إلى مزيد من التأمل والدقة. وعلى كلٍّ فإني سأقول في هذه الجلسة ما كان ينبغي أن أقوله في عدة جلسات وانعدمت الفرصة، وسأقول في أول كلمتي ما كان ينبغي أن أقوله في آخرها. وهذا ما يزيد في إبهام الموضوع، ولكن لا حيلة لنا.
إن زبدة وأساس الكلام الذي أريد أن أبوح لكم به هو قضية فكرية، وليس قضية علمية.
وبقدر ما هي كلمة أساسية فهي لا تحتاج إلى الشرح والتفصيل، وهي: أن نتنبه كيلا نرى أنفسنا مكتفين فكرياً بالكفاءة العلمية، لأنها كفاءة كاذبة، وشبع كاذب، ونوع من الغش الكبير الذي يصاب به المثقفون والمتنورون في زماننا. فحين يرى المثقف نفسه مشبعاً بالعلم، وينال دراسات عالية، ويكتسب معلومات واسعة ورفيعة، ويرى أساتذة كباراً وكتباً مهمة، ويجد الآراء والنظريات البديعة ويتعلمها، يجد في نفسه رضى وغروراً، ويظن أنه بلغ من الناحية الفكرية أقصى ما يمكن أن يبلغه الإنسان الواعي. وهذا انخداع يبتلى به العالِم أكثر من غيره؛ إذ لا يظن الأستاذ، أو الفيزيائي، أو الفيلسوف، أو الصوفي الكبير، أو الأديب، أو المؤرخ، أنه يمكن أن يكون لا شيء من الناحية الفكرية، وأنه في مستوى أقل العوام شعوراً، وحتى الأمي الذي لم يأنس الخط أرقى منزلة في الدراية الشخصية، وفي معرفة المجتمع، ومعرفة الزمان؛ ولكنه كذلك.
إن كون العالم جاهلاً وبقاء المثقف عاطلاً من الشعور، أو إعطاءه العناوين والألقاب البارزة، كالدكتور والمهندس والبروفسور وأمثالهم، حالة مؤلمة جداً، إذا كان فاقداً للفهم والنباهة والشعور بالمسؤولية تجاه الزمان، وحركة التاريخ التي تأخذه معها هو والمجتمع.
إن خطر بقاء العالم جاهلاً وكونه أخرس وأعمى ولا شيء، هو خطر كبير جداً، لأن الإنسان إذا أشبع بالعلم لا يشعر بالجوع الفكري، والشيء الذي يتطلع إليه العالِم في هذا الزمان هو "المسألة الفكرية" منفصلة عن "المسألة العلمية".
اختيار المقرر
إن مجتمعات دول العالم الثالث (أفريقيا، آسيا، أمريكا اللاتينية)، المتأخرة من الناحية الصناعية، المنحطة في تقدمها، التي لم تصل بعد إلى مستوى التلميذ الأوروبي والأمريكي في شتى التعاليم الفنية والفلسفية... هذه المجتمعات الفقيرة تماماً، تملك قدرة مجهَّزة بأسلحة تقف لمكافحة الغرب بكامل أسلحته، وتمام عدده وعدته، فتجبره على الخضوع والاستسلام، في الوقت الذي يمتلك الغرب قدرات تكتيكية وعلمية وفلسفية عالية، بالإضافة إلى شرائه كل نبوغ في العالم، لأنه متمول؛ إذ النبوغ والدراسات العليا والعلماء والمكتشفون والمخترعون والكتاب، هذا كله أصبح يباع ويُشترى كأي سلعة، تتبع المال أينما كان، ولامتلاكه الميراث العلمي في الدنيا كلها، واحتفاظه بجميع الإبداعات والذخائر من جميع الفروع العلمية، ابتدعها هو أو أخذها من غيره، فبلغ ذروة التكامل العلمي والفلسفي والتكنولوجي، وحاز ثمرة كل الجهود البشرية التي بذلت في سبيل العلم إلى هذا اليوم... مع ذلك فإنه قد فقد شيئاً أجبره على الخضوع والاستسلام لتلك المجتمعات، التي لا تمتلك أي نوع من الأسلحة، فأهلها حفاة، لا يمتلكون حتى آلة للدفاع عن حياتهم وحياة أسرهم، رغم أسلحة الغرب المادية والمعنوية والعسكرية.
من هما طرفا القتال والجدال في هذا العصر؟
مجموعة من القدرات العلمية والصناعية تقاتل جماعة تفقد الصنعة والعلم. وإن مصير هذا القتال، بعد اختلاف عدة أشهر وسنين، سيكون لصالح أولئك الحفاة في هذه الدنيا بلا شك، لصالح أولئك الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، وستخسر تلك القدرات التي حازت الذخائر العلمية والفنية مدى الدهر، وطيلة تاريخ البشر. أيٌّ شيء يقتتل مع أي شيء؟ العلم يقتتل مع الفكر. هذا الحافي الجائع، الذي قدِّر له أن يبقى فقيراً، عرياناً، مريضاً، لكنه في الوقت نفسه تسلح بسلاح واحد هو "الفكر" و"الإيمان" و"العقيدة"، له هدف واحد جعله يقاتل ذاك الإنسان الذي جمع المقدرات العلمية والصناعية والفلسفية، فيتغلب عليه رغم كونه أمياً. إذاً هناك شيء آخر، غير الثروة والقدرة والعلم والفلسفة والتكنولوجية. الشيء الذي لو صرفنا النظر عن "وجوده" و"عدمه"، لهُزمنا أمام حفاة الدهر، وإن كانوا عبيداً مظلومين، لأننا نباد وننهار من الباطن، حتى لو بلغنا ذروة التكامل في تلك القدرات المادية، حيث بلغ الغرب المتمول هذا اليوم.
ومن هنا فإن المجتمعات التي تريد أن "تختار" تقف أمام طريقين:
1ـ أن تختار طريق العلم والرأسمالية والقدرة والصنعة.
2ـ أن تختار طريقة فكرية وعقيدة تنشدها.
من المسلَّم به أن المجتمع الذي يرتبط بهدف عال وعقيدة وإيمان، يتفوق على كل قدرة، حتى على القوة التي تسيطر على "المنظومة الشمسية". وإن مجتمعنا كمثل هذا، ستكون له حضارة أيضاً بعد عشر سنين أو خمس عشرة سنة، كما تكون له صنعة، وينتج على مستوى عالمي أيضاً. ونماذج كثيرة في الزمان الماضي وفي وقتنا الحاضر كان لها ذلك. أما إذا كان المجتمع فاقداً لنموذج يهدف إليه، فاقداً للإيمان والرعاية الشخصية والاجتماعية، وليس همه سوى الصنعة والاقتدار والرأسمالية، وما يسمى اليوم بالتقدم العلمي والصناعي (فلو وُفّق لنيل ما يروم ولن يوفَّق) فإنه سيبقى مستهلكاً، وإن ظن أنه منتجاً. وهذه هي الخديعة الكبرى التي وقعت فيها جميع البلاد المتأخرة، وخسرت ذلك الشيء الذي يهب المسترقّ العجوز المحروم قدرة تزلزل أكبر قدرة عالمية. وهكذا إذا كنا أصحاب عقيدة، فإنه متى ما وُفّقنا أن نجتاز مرحلة الإيمان بنجاح فإننا سنكون صانعي أكبر حضارة.
أما إذا لم نشعر بنقص فكرنا، أو لم تنكشف لنا قضية الإيمان والعقيدة، ولم نستوضح طريقنا فنتعلمه، ولم نشعر بحاجتنا إليه، فإننا سنبقى محتاجين أرقاء للمنتجين، معتمدين على الحضارة الغربية، ونستهلك من إنتاجها.
من هنا فإن المثقف اليوم في البلاد المتأخرة، أينما كان، في أمريكا اللاتينية أو في آسيا القصوى أو في الشرق الأدنى، لا فرق في ذلك، بل كما يقول "فانون": إن المجتمعات المتأخرة لها مصير متشابه، وحاجة واحدة، وانتخاب واحد، لأنها تواجه قدرة متشابهة في زمان واحد ومشترك؛ إما أن يختار "الفكر" أولاً، أو الحضارة من غير "الفكر"، وأعني بـ"الحضارة" الشيء الذي يخرجه المتحضرون لنا.
وقد كشفت لنا التجارب طيلة الثلاثين أو العشرين سنة الأخيرة، وحتى في الأربعين أو الخمسين سنة الماضية، أن المجتمعات التي بدأت من نقطة عقائدية، وتحركت بعد تحقق وعيها الفردي والاجتماعي، قد وقفت اليوم في مصاف القدرات التي تصنع الحضارة العالمية. لكن المجتمعات التي اقتدت بالحضارة الغربية بدون وعي اجتماعي، أو شعور إنساني بالوعي الفردي، وبدون عقيدة، بل بمجرد نهضة كاذبة، قد ظلت مسخرة للحضارة الغربية، مستهلكة على الدوام، خاضعة للذل والعبودية تحت سيطرة الغرب.
يمكنكم أنتم أن تجدوا أمثلة ونماذج لذلك!
ما أقرب الإنسان وهو بعيده!
ما أريد أن أقوله هو: إن الدين، الذي هو فوق العلم، يعتبر الإنسان ذاتاً أرقى وأشرف من جميع المظاهر الطبيعية. هذا هو اعتقاد الدين واعتقاد أصحاب النزعة الوجودية (Les existentialismes) أيضاً. فسارتر نفسه، الذي لم يؤمن بالله، يعتبر الإنسان ذاتاً منفصلة عن جميع كائنات الطبيعة، وقطع حبل اتصاله بالسماء، وأوكل أمره إليه، فهو يصنع مصيره ويصنع نفسه، وهو رب نفسه، ومسلط على الطبيعة ويسخِّر قواها، خلافاً لسائر الكائنات المخلوقة من قبل الطبيعة والمستسلمة لها، كان يعتقد ذلك. وهنا نرى أن الدين و(Les existentialismes) وأصحاب النزعة الإنسانية (les humanistes) يلتقون في نقطة تعترف بأصالة الإنسان، ورجحان ذاته على جميع مظاهر الطبيعة؛ أي كما رفع الإسلام قدره وأجلّه إلى حد تقاصرت عن أن ترفعه إليه المدارس ذات النزعة الإنسانية (humanists) المصرة على رفعه وإجلاله، حيث جعله الإسلام صفوة الله، وخليفته بين الكائنات، وسخّر له كل قوى الطبيعة، وأمر ملائكته بالسجود له والتسليم له بالعبودية، كذلك فضله على العالم. وأما عمله فهو كعمل الله في العالم تماماً، وبإمكانه أن يشابهه في العمل في عالم المادة وعالم الطبيعة، ولكن أي عمل؟ أن يكون خالقاً عارفاً مدبراً مختاراً مطلق القيد من كل جبر.
هذه الصفات الخاصة بالله في العالم نُسبت للإنسان في الإسلام بدرجات أدنى؛ عارف ذو إرادة، مختار، خالق، مغيِّر، متمرِّد، ومسخِّر لكُلِّ أنظمة الطبيعة، ومغيِّر لمصيره التاريخي، ولمجتمعه، وحتى لذاته.

.jpg)
















المصدر وليد مانع / لا ميديا