
«لا» 21 السياسي -
الأسبوع الماضي، وبالتحديد يوم التاسع من آب/ أغسطس، مرت الذكرى السادسة لمجزرة طلاب حافلة ضحيان – صعدة، التي ارتكبها تحالف العدوان الأمريكي السعودي في العام 2018، وراح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من الطلاب الصغار وأساتذتهم، في جريمة ضد الله وضد الإنسانية، واعترف بارتكابها ناطق العدوان، تركي المالكي، بعد الإنكار المسبق وإصرار مرتزقة العدوان على حمل كبرها كما كبر سواها واتهامهم لقوات الجيش اليمني واللجان الشعبية بفعلها وافتعالها، ليعود بعض هؤلاء (ومنهم أنيس منصور) للاعتراف بكذبهم وزيف ادعائهم وإجرامهم بحق وطنهم وشعبهم وبأنهم كانوا يعملون كخلايا إعلامية مدفوعة الأجر وتتلقى الأوامر من ضابط اتصال سعودي/ إماراتي من غرفة عمليات العدوان.
تزامناً مع ذكرى المجزرة تلك، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي عن الـ«إي كي»، والتي أحدثها أنيس منصور بدايةً بطلبه بندقية «إي كي» صناعة يمنية، وليس نهايةً بإعلانه الحصول على أربع عشرة بندقية من هذا النوع تلبيةً لطلبه ذاك، إحداها مهداة من رئيس المجلس السياسي الأعلى، وثانيتها من رئاسة أركان الجيش اليمني، عارضاً الأخيرة منحوتاً عليها الإهداء، متحدثاً عن استلام أحد أقاربه داخل جغرافيا السيادة الوطنية بنادق كتيبة كاملة، فيما هو يعيش في تركيا بالطبع، واللهم لا حسد له ولأشباهه، ولا شماتة بنا وبأمثالنا! المهم، «هات يا لبيج» و«هات يا صياح» بين منصور ومؤيديه من جهة وناقديه والناقمين عليه من جهة أخرى! ففيما الأول يقدم نفسه كرأس حربة وطنية إلكترونية تستحق البنادق، يرى فيه الطرف الآخر أحد المؤلفة قلوبهم، الذين وإن استحق شيئاً فبندقية واحدة تكفي، وهناك من السابقين من يستحقها أكثر منه. و«هات يا آيات» و«يا أحاديث» و«يا مواعظ»، «سدحها» كل طرف في وجه الطرف الآخر من الاستدعاء لحادثة توزيع الغنائم عقب غزوة حنين إلى الاستدراك بأن «السائلة» لا تجُبُّ ما قبلها، فالسابقون السابقون...
بالنسبة لي، فما عدتُ أطيقُ مقامي في حبر الأعراف، وما كنتُ يوماً رمادي المداد، فهاكم بعض السيل الذي بلغ الزبى، وبعض القيل عن «أحبة ربى...»:
أتذكر في نهاية العام 2009 كنتُ في صعدة أغطي آثار الحرب السادسة، وعدتُ بعدها بملف دسم نشره عابد المهذري في صحيفته «الديار»، حينها ووقتئذٍ كان أنيس منصور يغطي فيما أتذكر أخبار معارك تنظيم القاعدة في بعض المحافظات الجنوبية. ومضى عامان اندلعت بعدهما أحداث ثورة التغيير العام 2011، وكنتُ وقتها ناطقاً باسم المجلس الثوري في محافظة البيضاء ومحرراً للملحق السياسي في صحيفة «اليقين»، التي يرأس تحريرها عبدالله مصلح. ولم أكن أعرف حينها أين ألقت بأنيس منصور «أم قعشم». كُسر عمودي الفقري، وبرغم ذلك، وبرغم التوقيف المتقطع لراتبي الحكومي، وبرغم التهديد بتفجير بيتي، لم أتوقف عن الكتابة حتى يوماً واحداً، مواجهاً للتطرف في معقل الإرهاب ومؤيداً للتغيير في محل النظام ومبشراً بثورة الحادي والعشرين من أيلول/ سبتمبر، وسط نُذر «الإصلاح» وتحذيرات «المؤتمر». بعد الثورة كما قبلها، أُجبرتُ على العمل برغم الإصابة، وحُذف من كشف راتبي بدل طبيعة العمل، رغم دوامي، ودخلت في معارك اجتماعية وإعلامية وسياسية في مواجهة العدوان، محلقاً من على شاشة قناة «اللحظة» وغارقاً في كواليسها، وقد بعتُ خلال ما سبق آخر ما تبقى لديّ: «جنبيتي» و«بندقي»!
في المقابل، شاهدت أنيس منصور على شاشات ومواقع وصفحات العدو السعودي ينافح عن مذابح العدوان ويكافح عن مرتكبيها ويناطح الحقيقة بقرنين من زور و«بهررة»، وبصفته التي كان يقدم نفسه من خلالها «السكرتير الإعلامي للرئيس عبد ربه منصور هادي»، والذي بالمناسبة حصل منه على سيارة (كرت) «تويوتا لاندكروزر» بعد طلبه إياها منه.
حسناً، «من تاب، تاب الله عليه» و«المعترف بذنبه كما من لا ذنب عليه»، إنما ليس في الدماء ولا في الأوطان. فبعد أن قلب ابن سلمان المجن للإخوان، خرج أنيس باكياً ومعترفاً بذنبه وخطيئته، طالباً السماح والعفو من ذوي الضحايا، الذين أنكر مآسيهم، فهل غفر له آباء وأمهات أطفال حافلة ضحيان مثلاً؟!
ولكي أكون منصفاً فإن أنيس منصور ليس أسوأ مَن عادَوا بلدهم ثم عادوا إليه، فهناك من يتجاوزه في السوء عداوةً وعودة، كما أن قصة استفزازه للبعض بالـ 14 بندقية لا تقارن بقصص أخرى أشد وأنكى وأكثر استفزازاً، تبدأ بفحص البندقية ولا تنتهي ب«قحص» البندق. الاستفزاز الحقيقي هو في الراعي «الميري» والداعم الرسمي، وليس في هؤلاء وأولئك؛ هذا الرسمي الذي يدير ظهره ويهز كتفيه لوجوه السبق ممن أوصلوه لما هو فيه، وفي الوقت عينه «يدق صدره» ويمد ذراعيه لوجوه سقطت آخر قطرة ماء منها وهي تنفذ من مترسٍ إلى نقيضه في طرفة عين وظرف «ربالات». إنه مشهد سريالي وكأننا ننفد ما بين غلافي «وجوه رملية لأعراس الغبار»! مشهد ربما ننقض بعض خباياه وننفض بعض غباره بطرق ذكرى مشهد سابق ليس للنسيان.
يقال بأن عدداً من كبار المهاجرين، يتقدمهم بلال، وعدد آخر من كبار المتأخرين يتقدمهم أبو سفيان، استأذنوا في الدخول على الخليفة (أظنه عمر)، فأذن على الفور للفريق الأول، مستهجناً مزاحمة الفريق الثاني للأول على الباب.
اقتدوا بعمر إذن إن فشلتم في الاحتذاء بعلي وهو من قدم عماراً على ابن العاص، وأمر بإعادة ما دخل من خراج ومال المستضعفين في أموال كبار قريش إلى بيت مال المسلمين... وإني لأراكم عاجزين عن الاثنتين، فلا تتوسلوا مكر وخداع معاوية من أجل هزيمة معاوية، فهذا والله ليس نصراً لعلي، بل انتصاراً لأنفسكم.
حسناً، فأما بعد وأما قبل، فليس ادعاءً ولا منة والعياذ بالله، كما ليس باستعطاف ولا استجداء، والأمر لله، وليس الموضوع بشخصنة، وإنما بتشخيص له في تكثيف صوري مقطوع من مشهد مترامي الأطراف وموصول بلوحة جدارية عملاقة ألوانها الدم والألم وفرشاتها الصبر وبروازها الأمل. إنها مجرد فضفضة رجل طرحه المرض الفراش وتم فصله من عمله، وتم إبلاغه قبل أشهر بحصوله على توجيه بمنحة علاجية في الخارج من قبل السيد القائد ولم يُعمل بهذا التوجيه من قبل المناط بهم تنفيذه حتى اليوم هذا (وقت تحرير هذه المادة)، وهو اليوم الذي تشهد فيه العاصمة صنعاء مراسم جنازة سفير «الشرعية» في ماليزيا عبدالغني الشميري، وهي التي استقبلت من قبل جثمان حسين الأحمر ومن قبله عبدالكريم الإرياني ومن بعدهم ربما علي محسن وعبد ربه هادي، وهي صنعاء أيضاً التي -في المقابل- يشهد مطارها ولا يزال مغادرة العشرات من أمثال هؤلاء للعلاج و«الفهنة»، أما نحن وأمثالنا فلسنا أكثر من مجرد «أولاد شغالات» فقط ولا غير.

.jpg)












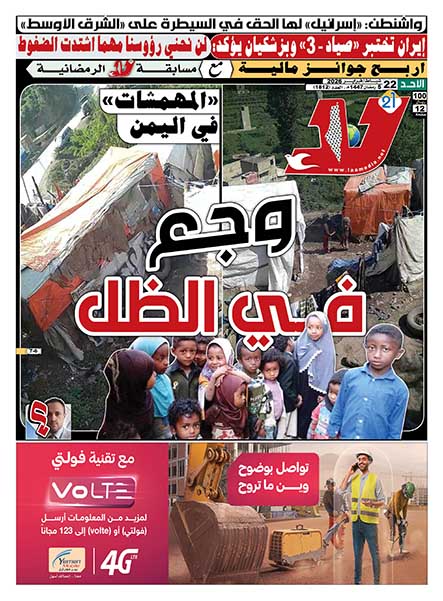



المصدر «لا» 21 السياسي