على خُطا البردوني.. الشاعر اليمني صلاح الدكاك:لو أن الإنسان يولد مرتين لاخترت أن تكون ولادتي الأخرى سورية
- تم النشر بواسطة موقع ( لا ) الإخباري

صحيفة تشرين السورية - حوار: حنان علي
«الشعر حالة عشق بالأساس، والشاعر عاشق على الدوا مغرمٌ قلق يتجاوز المرئي في علاقاته بمحيطه طمعاً في الإمساك باللامرئي وتظهيره وجودياً، بحيث يغدو قابلاً للقياس والرؤية ومتاحاً لمخيال القارئ العادي».
إنها أولى العبارات التي استهلها الصحفي ذو الموهبة الفذة، والشاعر اليمني المدهش، الذي كشف النقاب عن مشاعره وأفكاره بقصائد رائعة لملم وريقاتها باكراً؛ لكنه آثر التأخر في الإفراج عنها إلّا بين ربوع معشوقته «الشام».
صلاح الدكاك، الوطني العاشق الذي قضّ مكامن الوجع، متكئاً على الحب، مهدهداً الأحزان، ليسلم القارئ نصراً أدبياً جال في ربوع اليمن، فلسطين، لبنان، وسورية، يتلمس أوجه الجمال والقوة في الحب الإنساني وعشق الوطن في: «ألف ليلى وليلى»، و»هذه الأبجدية أمي»، الديوانين الصادرين عن دار نينوى للترجمة والنشر، واللذين عرضا مختلف تجارب الشاعر الشعرية عموداً وتفعيلة: «حباً وحرباً وفسقاً وتصوفاً، هذه هي غابتي التي التهم الترحال والنسيان والحرب كثيراً من أشجارها وغطائها النباتي؛ ولكنها ظلت متنوعة أطوالاً وثماراً، وقد تعمدتُ عرضها بتنوعها».
المرأة الملهمة متهمة بريئة
لم يستهدف شاعرنا خدمة قرائه، بل انطلق في الكتابة الشعرية من حالة سأمٍ حيال علاقات ساكنة وغير جدلية تطوقه، فكاد لها بتحطيمها، حتى حقق لنفسه الانعتاق الروحي والاتزان النفسي، متخلصاً من وزنٍ زائدٍ شدّه بحضيض الواقع الساكن والآسن.
فمن العسير -كما يرى الشاعر الدكاك- «تسمية مصدر حالة الإلهام المحرضة على الغرام والمنتجة للكتابة الشعرية. فالمرأة في المفهوم السائد متهمة بالوقوف خلف جلّ نتاجات الشعر العربي، والحقيقة أنها متهمة بريئة، فاللحظة الشعرية لحظة خلق جُوَّانية معقدة، لا حالة لصوصية تشحذ موضوعاتها من الواقع المنظور أو من علاقة حب اعتيادية عابرة تنتهي بـ«الرفاه والبنين»، وإلّا لكان كل البشر شعراء، فتجاربهم في هذا السياق -بالقصور الذاتي- واحدة».
ليلى من ألف ليلى
وعن «ليلى»، التي تجول في أروقة ديوانه الأول، أوضح الشاعر والصحفي المخضرم أن ليلى المعنية بهذه القصيدة هي المناضلة الفلسطينية «ليلى خالد»، التي سحبت طائرة صهيونية بركابها من روما لتفجرها في مطار دمشق في عملية شهيرة كان هدفها مبادلة الركاب الصهاينة بأسرى ومعتقلي الحركات الفلسطينية لدى كيان العدو الصهيوني.
ويُضيف شاعرنا: «ليلى خالد هي ليلاي، وأنا قيسها، وكل أحرار أمتنا هم قيسها، فهي أنموذج حي للمرأة العربية المناضلة، التي لم تكبلها مريلة الطبخ وعلبة الماكياج وجديد الموضة بحيث تتعثر بسرير زوجية يتمخض مواليد موات خارج معركة التحرير وخارج قضايا الأمة المركزية العادلة». فما برحت ليلى خالد، وفق منظور الشاعر، «قصة عشق سرمدية خالدة وملهمة. ولسوء الحظ فإن الذاكرة العربية متخمة بليلى العامرية وقيس بن الملوح، وفي «سنوات الضياع» الراهن لم تتسع لليلى عظيمة بمقام وحجم المناضلة الفلسطينية ليلى خالد، التي يتحتّم أن تحضر في صدارة قصص العشق الكبرى، وعلى أغلفة المناهج الدراسية وكراريس النشء الموشومة اليوم بـ«مهند ونور وبات مان وسلاحف النينجا وساندي بيل...» وأيقونات استهلاكية بلا حصر تعتقل مخيلات الجيل وتشكلها وفقاً لمقتضيات السوق، لا مقتضيات الصراع الوجودي الذي يفترض أن تخوضه أمتنا، والذي تعيش اليوم على هامشه، إلّا ما ندر من أحرار وشرفاء ومناضلين معدودين ينهضون بأعبائه وحيدين مخذولين من كل جانب».
«كلُّ ليلى لا تُسمِّي مهرها التحرير...
لا تَغزل مَهد الوعد بالجرح
ولا تشبك بالرمح الدرايا المرسلة
مقصلة!».
ما لبثت حياتنا العاطفية الواقعة تحت مفارز الاحتلال لا يمكن مزاولتها -كما يقول شاعرنا- دون أن نتعثر بها ونغضب ونثور ونناضل لتخليق مناخٍ لائق بحبنا وبمن نحب. فلا يمكن لصلاح الدكاك أن يكتب «لحبيبة ما، قصيدة حب اعتيادية في زمن المجازر اليومية، من دون أن تتضمخ حروفه بدماء الضحايا وتتحول إلى مولوتوف، والقلم إلى بندقية، والأبجدية إلى مشط ذخيرة حارقة تشقُّ طريقاً إلى عالم آدمي لائق بمن نحب وبأن نحب فيه بكرامة ونحن مطمئنين على أن «ليلانا» لن تسقط سبية لسوق دول النخاسة، ولن يتحرش بها المارينز وعصاباته في حواجز التفتيش، ولن تقع فريسة لثكنات «جهاد النكاح» المنتشرة على طول خارطتنا العربية السليبة».
أما فيروز الشاعر فهي «ليلى كبيرة غامرة، وهي واحدة، ولكنها بلا عدد في حسبان العشق والفن والوطن والقضية، وهي مشترك قومي إنساني رحب لم تتضمنه قائمة المشتركات القومية». وفي قصيدة من ديوان تحت الطبع كتب الشاعر في مناجاتها:
يا صوت فيروز بالرُّجعى
-تبشر من-
للقدس؟! ما أبعد المسرى وأبعدنا!
يا صوت فيروز، هل نبكي بـ«زهرته»
قُدسَ المدائن؟! أم نبكي به «عَدَنا»؟!
خرائطي كلُّها مسبيَّةٌ، وغَدي
كأمسه يندبُ الأطلال والدِّمَنا
لقد أفقنا من الحلْم الكبير على
منفى تَسربلَ من أعمارنا وطنا
عشنا نبيع فلسطين الوعود وقد
«فات المعاد» وبعنا الشام واليمنا
فهل نسمي ذلك يأساً؟! أم نسميه جراحة جريئة لجرحٍ عربي متخثر نستهدف كيَّه وتطهيره؟ لعله إحباط لا نجاة منه، فلا يعتقد شاعرنا أن «ثمة أمة على وجه الأرض أتعس من أمتنا العربية؛ فهي تتوافر على كل عوامل التآكل والتدمير الذاتي الذي يعفي غاصبيها من العناء في سياق تعبيدها وتدويرها لصالح مشاريعه الاستعمارية والاستحمارية معاً!».
ويبوح الشاعر بجانب من الألم، ورُبما القهر، الذي يُكابدهُ، ومعه كل عربي قومي حُر، قائلاً: «نغني لفلسطين وفي الطريق نخسر سورية والعراق واليمن، ولا نكسب فلسطين التي تبقىدائماً سليبة بامتداد الطريق».
القصيدة أمٌّ
الأم الحاضرة الغائبة عن طفلها أمست قصيدة ترضعه خمر النُّبوءة طفلاً يافعاً رجلاً. وجعٌ طاف بين كلمات «هذه الأبجدية أمي»، الديوان الثاني للشاعر:
نسي الطفل الذي عاش بوعد العيد ثوب العيد
مصلوباً على شمَّاعة الذِّكرى
ومطموراً بردم الأمنيات العاطرة
وارتدى جلجلة الرقيا
وأسمال يسوع النَّاصرة!
الشاعر متصدع الفؤاد عبّر عن يتمه بالقول: «أنا شهقة حياة تخلقت من زفرة احتضار. رحلت أمي في الثالثة من عمري مورثة لعبة صغيرة إلى جوار سريري تدعى الأبجدية، تكسرت كل ألعابي الأخرى، وبقيت هذه اللعبة تكبر معي، وما زلتُ طفلاً في حضرتها حتى اللحظة. لاحقاً اكتشفت أن أمي تقمصتني أبجدية، ولم تخذلني حين رحلت وشعرت بالامتنان والدفء لحضورها الغامر معي في كل مناخاتي النفسية، بحيث بات يُتمي الظاهري كنزاً جوّانيّاً أغترف منه كل العزاء والصبر الجميل».
وجعٌ مستدام
سنوات العدوان الكوني المستمر على اليمن ضاعفت أوجاع اليمني المثخن بالآلام والآمال منذ حقبة غير معلومة. وعن ينابيع الوجع الملهم ذكر شاعرنا قصيدة «بحرنا أحمر يا الله»، معقباً بالقول: «تخلقت أبيات قصيدتي من عشرات المجازر التي افترست خلالها عقبان طائرات العدوان مئات الأطفال من أبنائنا». مِن تلك المجازر، ما ارتكبه العدو قبيل عيد الأضحى في أحد أعوام العدوان بقصفهِ «سوقاً مكتظة بالعائلات التي كانت تتبضع ملابس العيد، وعرفت بمجزرة آل ثابت في صعدة، وارتقى خلالها عشرات الشهداء من النساء والأطفال والمدنيين... ولعلكم قرأتم أو شاهدتم كذلك مجزرة مماثلة عرفت بمجزرة حافلة أطفال ضحيان...».
ويضيف شاعرنا: «ينابيع الوجع الملهم كثيرة في زمن العدوان المديد الذي يمتدُّ من محاوي الحديدة إلى حمص، ومن سوق الهنود إلى الموصل، ومن صالة في تعز إلى بواكي بيت المقدس وجنين ويعبد ونابلس... بحارنا العربية بين أحمر قانٍ، أو أبيض متوسط يصطبغ بالأحمر ويقع توسُّطه فريسة للتطرف الممنهج، أو بحرٍ ميت هامد لا روح فيه. وأنهارنا نموت عطاشى على ضفافها من كربلاء إلى سبايكر في العراق... هذا هو واقعنا للأسف يا سيدتي».
أما الرفاق والحبيبات فيَخذلون على السواء، ومن النادر أن يجد الثائر رفيقاً يكمل معه رحلة الكدح من مهد الثورة إلى منفى «الرّبذة»، حيث «أبو ذر الغفاري» يموت وحيداً بلا عزاء حتى اليوم، ويخلد المتخمون من جوع الجوعى وسارقي الثورات الكبرى!
آه ..
كلُّ الأفاعي التي لدغت خافقي
خرجت من جراب الرِّفاق
والكؤوس التي سممتني
كانت كؤوس الحبيبات عند العناق!
كل ثائر في الأغلب -من وجهة نظر الشاعر الدكاك- ينتهي به الحال في منفى «الرّبذة»، حيث يموت بهدوء لينعم «قصر الذين يكنزون الذهب والفضة» بالسكينة، التي يهددها صوت الثوار الحقيقيين كأبي ذر الغفاري، وأما الزمن المشاع فحلم مؤجل يُبَشّر المسحوقين به، وسرعان ما يرثي الحلم ويفيق الجائعون بصفعة من يد المسغبة.
وفي سؤال عن مكنونات الشاعر التي لم يخطها حبره، مؤثراً التوصية بمد الورق جوار لحده قال:
ضعوا ورقاً أبيضاً قرب رأسيَ إن متُّ
علَّ سكون الضَّريح يساعدني
فأدوِّن ما فاتني من كلام!
فما كان من شاعرنا إلّا ذكر مثلٍ شعبيّ يمني يقول إن «الزمّار يموت وأصابعه على المزمار». وتابع بالقول: «إنها رحلة البحث عن كمال النغم، والشاعر كذلك يموت وأصابعه لم ترتوِ من القلم الباحث عن كمال الحرف، وكمال المعنى. وفي ذلك يقول الشاعر التركي ناظم حكمت: «أجمل القصائد هي تلك التي لم نكتبها بعد»، وأنا لم أكتب أجمل قصائدي بعد، ولذا أشعر بالحاجة لأن أحمل القلم والورق معي إلى سكينة الضريح إن كان ذلك مواتياً».
إطلالة دمشقية
«لو أن الإنسان يولد مرتين لاخترت أن تكون ولادتي الأخرى سورية؛ فهذا البلد يتقمصني منذ صباي في: الماغوط، دريد لحام، طلحت حمدي، أدونيس، نزار قباني، شحرور، البوطي، والزعيم الراحل حافظ الأسد... وهناك مقولة أظنها لمدير متحف في أوروبا، يقول فيها: «لكل إنسان بَلَدان: بلده الأصلي، وسورية»».
هذا ما صرح به الشاعر صلاح الدكاك عن محبته لسورية، فدمشق «بكل جراحاتها ومآسيها تظل مركز الإشعاع الفكري والأدبي الأول بلا منازع»، وفق تعبيره، ولذلك خطط باكراً لأن تكون إطلالته الأولى على القارئ العربي من «عاصمة الياسمين والأبجدية الأولى، وعلى خُطى الرائي الكبير الشاعر عبدالله البردوني، الذي صدرت كل نتاجاته الشعرية والفكرية تقريباً من دمشق». أما الجمهور السوري فيراه الشاعر «ذا ذائقة رفيعة مائزة ومرهفة إزاء الشعر والشعراء. أذكر أنني حضرت في يوم من الأيام في العام 2004 أمسية شعرية في قاعة اتحاد الأدباء بدمشق، ولفرط إصغاء الجمهور وخشوعه كانت رفة جناح فراشة تعد بمثابة ضوضاء وصخب وسط السكون القانت الذي يلف قاعة الأمسية. فمن مدرجات دمشق تعمّد محمود درويش شاعراً، والكثيرون سواه. وأنا أطمع أن تكون دمشق وجمهورها معمدانيتي، وأثق بأن القطار لم يفتني».
يبدو أن الشاعر الوطني لم يكن متابعاً للمشهد السوري فحسب، بل عاشه لحظة بلحظة، إذ يقول: «كما لو أن المعارك كانت تدور على باب منزلنا، وتهدد حياتي شخصياً».
أما تأثره فبان جلياً في قصائد عدة أبرزها قصيدته في يارا عباس، شهيدة الإعلام السوري، التي وصفها الدكاك بـ»صوت أعماقنا القلقة والمذعورة على سورية وبلسماً لها»، مُوضحاً: «كانت الشهيدة يارا عباس صوت أعماقنا القلقة والمذعورة على سورية، وبلسماً لها، واستشهادها في أهم منعطف تحريري (القصير) كان مربكاً وفاجعاً، وامتزجت مشاعر الفرح بالتحرير مع غصة الفقد الكبير. إنها أيقونة الصمود السوري والبطولة السورية الفارقة بلا منازع، وهي جديرة بحفريات شعرية تخلدها، لا بقصيدة مفجوعة ومباهية كالتي كتبتها فحسب».
يحشو بندقيته
ويثقب قلب يارا
فينزّ موّالاً على شفة الزمان
يدوزن الجرح انتصاراً
يارا دمشقُ، وجرحُها بَرَدى
شذى وندى
ودهرٌ ما توارى...!
يؤكد شاعرنا أن «مقولة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر التي يصف فيها سورية بأنها قلب العروبة النابض، لم تكن من قبيل المجاز»، مضيفاً: «أدركنا ذلك بصورة جلية في 2011، وأمام العدوان الكوني غير المسبوق أدركنا أيضاً -وبذعر شديد- أننا على وشك أن نخسر هذا القلب، ومعه نخسر كل وجودنا العربي، وتأكد أن ما يسمى «الربيع العربي» الذي انطلق من تونس ثم مصر كان يستهدف سورية بالأساس، ولو أمكن له تحقيق هدفه لتداعت بنية الوجود العربي برمتها دون كثير كلفة، فسورية كانت وثبة مفارقة لمحيطها الداجن حضارة وفكراً وسيادة وتصنيعاً وطموحاً ووضوح رؤية وصوابية بوصلة، ولذلك كله كان لا بد -في منظور الغرب الإمبريالي والصهيونية العالمية- أن تُمحى سورية، وأن يعاد تدويرها ككانتونات داجنة محتربة طائفياً وعرقياً لضمان موات عربي مديد وبلا نهاية».
نذكر أن أول إبداعاته الشعرية كانت قد احتضنتها دار نينوى للترجمة والنشر في دمشق، والتي خصها شاعرنا بالقول: «دار نينوى أشبه بسفينة نوح، حملت على عاتقها مهمة حماية الأنواع الأدبية من الانقراض، مبحرة بكلّ ثقة وجرأة ومقامرة وسط محيط طوفان رقمي يهدد زمن المداد. وأنا مدين بنتاجاتي الأولى للأديب أيمن غزالي، ولصديقي الإعلامي النبيل أحمد رفعت يوسف».
وباستفسار أخير عما في جعبته من إنجازات شعرية قادمة، أجاب الشاعر والإعلامي صلاح الدكاك بأن لديه ديوانين جاهزين لتعميد تروس المطبعة، أرجأ طباعتهما حتى يتيح لتوأمه الشعري الأول أن يتنفس بكامل رئتيه، مؤكداً أن «دمشق ستكون معمدانية ديواني: «بزمن بخس» و»أبجدية الحرير». وهذا الأخير الذي يضم كل ما كتبته بين يدَي سورية من دمشق إلى نبّل والزهراء إلى كفريا والفوعة ومعلولا وحلب الشهباء وبطولات رجال الرجال في الجيش العربي السوري...».


.jpg)










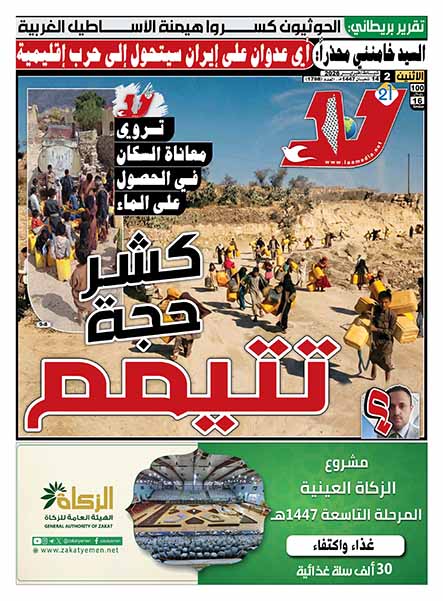





المصدر موقع ( لا ) الإخباري