لماذا ترفض أمريكا خروج السعودية من اليمن؟!
- تم النشر بواسطة «لا» 21 السياسي

«لا» 21 السياسي -
في ملحق العدد السابق، وتحت عنوان «لماذا ترفض السعودية الخروج من اليمن؟!»، وضعنا تساؤلاً استفهاميا بشأن ما تردده بعض الأوساط عن رغبة سعودية للخروج من اليمن. وكان التساؤل هو: لماذا لا تضع الرياض شرط السلام والخروج من اليمن على واشنطن ضمن شروط التطبيع مع الصهاينة إن كانت صادقة؟!
وأعلن البيت الأبيض، مساء الثلاثاء الماضي، وجود وفد أمريكي في السعودية لبحث مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية، أبرزها تطبيع العلاقات مع «إسرائيل» والحرب على اليمن، في مزاوجة ممجوجة ومفضوحة بين الملفين يصنع تركيبتها الأمريكي وليس السعودي بالطبع.
وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، في إفادة صحفية، إن مبعوث الإدارة الأمريكية إلى الشرق الأوسط، بريت ماكجورك، ومساعدة وزير الخارجية، باربرا ليف، انضما إلى المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج، الموجود حاليا في الرياض.
وأوضح سوليفان أن الفريق «موجود حاليا في الرياض لمناقشة مساعي التطبيع مع إسرائيل، إضافة إلى مجموعة أوسع من القضايا الإقليمية، بما في ذلك الحرب المستمرة في اليمن». وفي مفردة «المستمرة» التي وردت على لسان سوليفان اعتراف أمريكي صريح باستمرار العدوان على اليمن.
وبعد كلام متحدث البيت الأبيض عن أن الولايات المتحدة تسعى إلى «تعميق» الهدنة القائمة في اليمن منذ ما يقرب من عامين والتوصل إلى «سلام دائم» في اليمن، أضاف أن «بريت سيجتمع لاحقا مع ولي عهد البحرين ويتحدث مع الفلسطينيين حول مجموعة من القضايا تتعلق بالملف الإسرائيلي الفلسطيني».
بدورها قالت صحيفة «العرب» الإماراتية إن واشنطن وضعت على رأس أجندة وفدها الزائر للسعودية بندين بدا أنهما منفصلان في الظاهر، هما الحرب على اليمن وتطبيع العلاقات بين المملكة و«إسرائيل».
الصحيفة، التابعة للمخابرات الإماراتية، أكدت ترابط ملف الحرب على اليمن والتطبيع مع «إسرائيل»، وذكرت أن واشنطن وضعت الملفين في حزمة واحدة تعرضها على السعودية، على أن يتم أخذها كما هي أو تركها كاملة، وذلك في إطار صفقة تقوم على تسهيل الخروج الآمن للمملكة من الحرب على اليمن، التي طال أمدها أكثر من المتوقع، والسماح لها بالتقارب مع إيران في مقابل إنهاء التردد السعودي إزاء إقامة علاقات طبيعية مع «إسرائيل»، ما سيمثل إنجازا كبيرا يحسب في رصيد إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، ويساعد الديمقراطيين كثيرا في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وبدلاً من أن يبادر السعوديون بالاشتراط، تحول الأمر عكسياً تماماً، ليربط الأمريكيون ملف الخروج من اليمن بالتطبيع السعودي مع «إسرائيل»، في إشارة إلى رفض واشنطن إخراج الرياض من مستنقع الحرب التي تقودها منذ نحو 9 سنوات، وابتزازها من الجهتين وعلى الجانبين.
دعكم من فنتازيا «العنطزة» السعودية الفارغة والمروج لها منذ فترة وبكل لغات الإعلام النفطي، والتي تحكي عن التحدي السعودي للولايات المتحدة وعن وقوف الرياض وقفة الند للند أمام واشنطن وعن تمرد ابن سلمان على البيت الأبيض وغيره من الكلام الذي تلقيه على عواهنه ليس فقط معظم وسائل الإعلام العربية بل وبعض الغربية، فأكبر خيوط العباءة الأمريكية أوسع من بروبجندا «العنطزة» السعودية وأصغر ثقوبها أضيق على رأس «مبس» من رقبة ثوب الدفة مقاس الميديم.
يحدثنا عباس بوصفوان في مقالة رائعة له في «الأخبار» اللبنانية عن حقيقة ما وراء الفنتازيا المذكورة في الفقرة أعلاه، وأن «معضلة محمد بن سلمان مع المؤسسة الأمريكية تتمثّل في مطالبته إياها بإدامة هيمنتها في المنطقة، وتقوية أُطرها فيها، وترقية العلاقات الأمنية إلى اتفاقيات دفاع مشترك، في وقت ترى فيه واشنطن نفسها مشغولة بالصين الصاعدة، وروسيا المتمردة على نظام القطب الواحد».
أمريكياً، يشير بوصفوان إلى «ثلاثة مجمعات رئيسة تربطها علاقات وطيدة مع الرياض: الاستخبارات، السلاح، والنفط»، وأن «علينا التمييز بين جو بايدن، الذي ربطته صلات باردة ومشوشة بابن سلمان، لأسباب انتخابية، وبين أمريكا المُركبة: الكونجرس، والمجمعات الكبرى، واللوبيات الفاعلة، التي مازالت ترى السعودية صديقاً موثوقاً ليس له بديل في غرب آسيا، يقدم خدمات جليلة للسياسات الإمبريالية في الشرق الأوسط المضطرب».
ويفكك الكاتب الإشكال المتصور حالياً في العلاقة بين الرياض وواشنطن بإبانة مكمن الخلاف، حيث تريد «السعودية مزيداً من الاهتمام والرعاية والسلاح والحضور والحماية الأمريكية، وهي متضايقة وعاتبة لأن واشنطن تروم فطمها في بعض المساحات. ذاك عتب بين «خليلين» مختلفين جداً، وخلاف بين طرفين غير متكافئين، يمران بلحظة تغير «فيزيولوجي» و«سيكولوجي»، أو يقتربان من لحظة حرجة، عاشا علاقة مديدة قبل أن يجد «الأخ الأكبر» أن مفهوم «الاعتمادية التبادلية» و«الشراكة» بحاجة إلى إعادة تعريف، بسبب تغير حاجاته، وعقده، والمحيط الجيوسياسي».
حسناً، «ليس هناك من ثورة سعودية على الشريك الأهم. وتصوير ولي العهد الشاب وكأنه يريد خط مسار مستقل عن الولايات المتحدة، لا نعرف له من أسس، ولا مظاهر. فالعلاقات السعودية مع روسيا متمركزة حول النفط، والصلات مع الصين ذات طابع تجاري، محكومة بالعرض والطلب. وحتى استعادة السعودية علاقتها مع إيران لا يمكن أن تتم إلا بتنسيق مع الشريك الأكبر، فالأصل أن السعودية تنسق حثيثاً مع واشنطن، وهذه قاعدة من المستحسن حفظها، وتعليقها على الجدران. أما تصوير السعودية وكأنها تنتفض على واشنطن، وكأنها جزء من محور المقاومة، فهو أكبر بكثير حتى من الرغبوية. هذا غلو يصعُب تفسيره».
يمنحنا بوصفوان المزيد من الاستدلالات، فـ«العلاقات الأمنية وطيدة بين الطرفين. وقد زار مدير وكالة الاستخبارات (سي آي إيه)، وليام بيرنز، الرياض أكثر من أي عاصمة أخرى في المنطقة. وهكذا فعل جاك سوليفان، مستشار الأمن القومي، للتنسيق بشأن الاحتياجات الأمنية للسعودية، وملفات: الصين، أوكرانيا، إيران، اليمن، التطبيع... السعودية أكبر مشترٍ للأسلحة الأمريكية، وهذه تقارير رسمية، و72% من الترسانة التسليحية السعودية مستوردة من الشركات الأمريكية، وليس من روسيا أو الصين، في ظل رعاية البنتاجون وأجندته النافذة أمريكياً تجاه الخليج: قاعدته العائمة. وأخيراً، اشترت الرياض 121 طائرة بوينغ بقيمة 37 مليار دولار».
بشأن ما يتم تصويره بتحدي ابن سلمان للأمريكيين:
نفطياً: يشير الكاتب إلى أنه و»رغم حاجة اقتصاد أمريكا إلى نحو 20 مليون برميل يومياً، تسعى الشركات الأمريكية المنتجة للوقود الأحفوري للحفاظ على حجم إنتاج متوازن، في حدود 13 مليون برميل يومياً، وذلك بهدف إدامة الأسعار بالمستوى الذي يحقق ربحية للمستثمرين، وكثير منهم يوظف أمواله في غير النفط، وهذا لوبي رابع تهمه العلاقة مع الرياض. لذا، نجد شركات النفط تُحجم عن ضخ مزيد من الاستثمارات، ولا تعمل على إنتاج مزيد من النفط الصخري، خشية انهيار أسعاره، وبالتالي انخفاض أرباح ملاكها، أو حتى إجبارهم على غلق الآبار، وتسريح العمال».
في التحليل السياسي، يقول بوصفوان: «لا يوجد إجماع أمريكي على زيادة الإنتاج وتخفيض أسعار النفط». و»حين حُدد سعر أقصى للنفط الروسي، كجزء من عقوبات الناتو ضد الدب الأوراسي، وُضع له 60 دولاراً للبرميل (ليس بعيداً عن الحدّ الأدنى)، ربما لتجنيب الشركات الأمريكية الإفلاس، فضلاً عن أن أسعار نفط رخيصة قد تمثل هدية للصين، المنافس الأكبر لواشنطن».
ويفند الكاتب «تصوير الرياض وكأنها تحارب أمريكا في سعيها للحفاظ على سعر «عادل» للمنتج والمستهلك»، فهذا «محض لعبة سياسية، تستثمرها السعودية لادعاء الاستقلال، في منطقة تحلم بالتمرد على أمريكا».
يستدرك عباس بوصفوان بأنه «ورغم أن بايدن يتضرر كلما ارتفعت الأسعار، وخصوصاً في حال تعدت 100 دولار مثلاً، بيد أن السعودية ستغرق إذا انهارت الأسعار، مع الأحلام المليارية لابن سلمان، القلِق من غضب المؤسسة الأمريكية القادرة على الإضرار بالسعودية، وتحطيمها كما حطمت دولاً أخرى في الإقليم، ما يقنع السعودية بأن تخضع».
ويختم الكاتب بالقول: «إن علاقات السعودية بأمريكا مبنية على «الخوف والطمع»، مادامت أمريكا في نظرها «إله الكون».

.jpg)












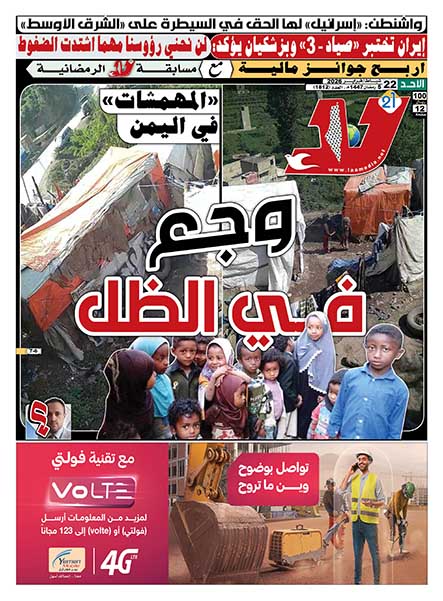



المصدر «لا» 21 السياسي