مشهد جمهوري من شاقوص الحريم الملكي "ضفائر تقية حميد الدين تشنق مارد الثورة (الحلقة الخامسة عشرة)
- تم النشر بواسطة تقديم: رئيس التحرير / صلاح الدكاك
 (1).jpg)
على ضوء صواعق ولهب الحنين تدلف الكاتبة قبو الحقبة المنسية وتهبط سلالمه المجدولة بغزل العناكب وصولاً إلى لحظة سحيقة من العام 1922م، لتبدأ رحلتها من أريكة أمها المحتضرة، مبحرة في خضم مآتم وأعراس ودموع وزغاريد ودماء وقصص حب ومؤامرات ومسامرات عائلية حميمة ودواوين شعر ودواوين حكم وأصوات مزاهر وفحيح أفاعٍ وأبهاء ملكية وسجون وولادات وإعدامات وانقلابات ومكائد حريم ونزوح وجوازات سفر و... منفى!
إنها كتابة اجتماعية (نوستولوجية) تحت سماء حمراء محتدمة بالصراع وحافلة بالأحداث، لا تخلو من زخات فرح تعشب قرنفلات حزن على امتداد رحلة شاسعة الوحشة، تطيح خلالها تقية بنت الإمام يحيى حميد الدين، بالصور المثالية الراسخة في أذهان كثيرين عن (الثورات الثلاث 48، 55، 1962م)، الواحدة تلو الأخرى، دون أن تتعمد الإطاحة بها، ودون تخطيط مسبق..
كتاب مغاير مخيف لا يقرأه أصحاب الضمائر الضعيفة وعديمو النخوة.. نضعه بين يدي القارئ على حلقات، إيماناً منا بأن فتح الجروح القديمة وتنظيفها أسلم لعافية أجيالنا من مواربتها وتركها تتخثر.
مصائبي كانت ذات شقين:
مصيبتي في ابنتي، ماذا لو عرفت أن أباها هو الذي قتل جدها، لقد سقطت كل الأقنعة، وباتت الحقيقة معروفة، فكيف لي أن أحرس ابنتي من كل طارق، وأحول دون معرفتها الحقيقة المرة، والتي ستدمر كيانها، وتضاعف حبي لابنتي وزاد تعلقي بها، سيما وأنها ذكية، مرهفة الإحساس، وهي قد بلغت العاشرة من عمرها.
ساعدني الله، وأقمت من نفسي سداً وحارساً وحاجزاً لها من رفيقاتها، بنات عمرها، ووقف معي جميع أفراد أسرتي، حالوا دونها وسماع الخبر، وكان الأمر صعباً، فكيف أحوطها بكل هذه السرية والكتمان، ووفقني الله في تحمل المسؤولية، فليس لابنتي من يحميها من لهيب الاكتواء بنيران الأحزان غيري، إنها بريئة ولا ذنب لها في كل ما حصل، ثم إنها فلذة كبدي، وقطعة عزيزة مني دماً ولحماً وعاطفة وحباً.
وبعد حقبة من الزمن، أخبرتها أن والدها عانى من أمراض كثيرة، وتوفي بالخارج، وما نطقت لها بكلمة واحدة عن ذاك السر الرهيب، وإنما عرفته هي بعد عشرين عاماً، وكانت قد تزوجت، ووهبها الله عبد الوهاب وخالد، عرفت السر من أعمامها الولدين زيد وقاسم الوزير في بيروت.
سمعتها ذات يوم تقول، وقد عرفت كل شيء:
الحقيقة أن أسرة حميد الدين طيبون، لأن أحداً منهم لم يتفوه بهذا الخبر، أن لوالدي اليد الطولى في قتل جدي الإمام يحيى.
كم كان ثقيلاً ومرهقاً حجب هذا الخبر عن ابنتي طوال تلك السنوات الغبراء.
ومصيبتي الثانية: في اغتيال والدي وإخواني وابن أخي، واعتقال الانقلابيين إخواني، ثم معاودة اعتقال أخي علي، لا لذنب اقترفه، وإنما لوشاية من حاقد. وليعذرني القارئ، فالأفكار والذكريات والحوادث تضطرب وتتشابك، ولكن ما ذنبي، فأهوال ما عانيته تهد الجبال، وصبري دونه أكباد الجمال.
وكان أن وصل إخواني المطهر ويحيى إلى دار أخي علي، يحملون رسالة إليَّ، قالوا: وصلنا خصيصاً لك، رسولين من طرف الإمام أحمد.
الإمام أحمد مشغول باله عليك، ويطلب نزولك إلى تعز، لتكوني طرفه، وسيعمل كل مستطاع لراحتك، وبالفعل استجبت.
وبالفعل سافرت مع إخواني المطهر ويحيى، وبرفقتي ابنتي والمساعدة الأمينة، ولكن دون مواكبة واحتفالات، وقد فرح الإمام أحمد بوصولي، وقابلني وابنتي بقدر عالٍ من الحنان والود، وحين انفردت به، طرحت عليه موضوع اعتقال أخي علي، وبينت له وأنا شاهدة على ذلك، أن كل ما صرفه ما كان إلا استجابة للاستغاثات التي أبداها الناس، ليتخلصوا من الأضرار التي أصابتهم بسبب هؤلاء، ولولا جهود أخي علي وحسن تصرفه لاستمرت الفوضى والغمة لأيام أطول، ولأصاب الناس شر مستطير.
وكان جوابه يرحمه الله: إني واثق من صدق ما تقولينه، ولكن الشرع يفرض علي التثبت والاستقصاء. وما هي إلا أيام حتى أطلق سراح أخي علي، وعاد إلى منزله، بعد أن اتضحت الحقيقة وبراءته بشهود عدول أثبات.
ثم ناقشت أخي أحمد في اعتقال عمي الكبير، وقلت له: أعتقد براءة العم علي من دم أبينا.
فأجاب: (مع احتمال ذلك، فإذا ثبت فسوف يطلق سراحه، والحقيقة لا تخصني وحدي في دم أبينا، فهناك ورثة غيري. ثم إن القضية تحت نظر الشريعة، فلا تدخل فيها لا مني ولا من غيري).
وفي تعز أسكنت في قصر الصالة من الدار الشرقية، بعد أن جهز لاستقبالنا. وكان يصحبني أخي عبد الرحمن وأولاد إخوتي علي بن إبراهيم والحسن بن علي، ولقينا الرعاية الجمة والعناية الفائقة المباشرة من أخي الإمام أحمد، رحمه الله، واستأنفت ابنتي الدراسة مع أستاذة القصر.
أمضيت في تعز عامين، ثم تاقت نفسي لزيارة صنعاء، ولقاء أهلي، واستأذنت أخي الإمام فوافق شريطة أن أعود. وأشهد أنني خلال إقامتي طرف الإمام أحمد ما عرفت منه إلا التفاني في خدمة شعبه، ومتابعة قضايا الناس بهمة لا تعرف الفتور، وكان يعمل في النهار والليل، وله صولات وجولات حتى داهمه المرض.
وسافرت إلى صنعاء، ولما وصلت انشغلت بترتيب أموري، وتجهيز سكن مناسب وتأثيثه، ودار دولاب الحياة مرة أخرى، مهما كانت فرائس الأحزان، وكيفما كانت علقمية الذكريات، فالحياة يجب أن تستمر.
***
كان لتواجد إخواني حولي، كل واحد منهم يشملني بالود والتقدير، ويحاولون دفعي لتخطي الأحزان، ومواجهة الحياة بكل شجاعة وعناد وإصرار، والحق أقول: كان لدي إصرار عجيب على الاستفادة من كل ما هو متاح، والتغلب على الوازع العاطفي، فحاولت الانطلاق من مغاليق نفسي، فالماضي لن يعود، حياتي بدأت من جديد في صنعاء، وكان بها آنذاك من إخوتي: أخي المولى الحسن، حفظه الله، وأخي عبد الله والمطهر، وعلي والقاسم والعباس ويحيى، كل واحد منهم حيث سكنه، وله شخصيته وطباعه وسلوكه، إذا زرت دار الشكر حيث سكن أخي الحسن أجد فيه صفات والدي، نفسه زكية، لطيف المعشر، أسمع منه العلم الرقيق والأحاديث النبوية، ونصائح وفوائد لا غنى لأحد عنها، غير أن دار الشكر، وبرغم عنادي وإصراري على تجاوز ما كان، كانت تثير أشجان نفسي، وتنشر ذكريات ارتبطت بأحلى أيامي الخوالي، تسابيح الليل، وأذان الفجر بصوت العم حمود الشمسي، مؤذن الإمام الشهيد، وإذا كنت في قصر دار السعادة أسترجع حادثة مضحكة ومخجلة، فقد كنت أعلق في صدري ساعة ذهبية مربوطة بسلسلة ذهبية، للزينة والوقت، ومن عادتي أن يكون أبداً قلم في جيبي لا أفارقه البتة، لأن والدي يرحمه الله كان يأمرني في أغلب الأوقات أن أكتب ما يمليه علي، مثل تحويل شيء أو فك لدخول أو خروج أحد من القصور، وتلك الحادثة كانت في الروضة:
في أحد أيام الصيف كنت مع أخواتي، وقد انتهى والدي الإمام من صلاة العصر، في شاذروان دار الخير بالروضة، استدعاني والدي وأمرني أن آتيه بورقة بيضاء لأكتب شيئاً، فهرعت إليه بالورقة، وأخرجت القلم، وقعدت أمامه منتظرة لما يأمرني بكتابته، فإذا قلمي فارغ من الحبر، نفضت القلم حتى أستجر الحبر، فما أجاب، فخجلت واحمر وجهي، فقال والدي: كم الساعة، فنظرت إلى ساعتي فإذا بها واقفة لا تتحرك عقاربها، فذبت واضطربت، فنظر إلي والدي بنظرات مؤنبة كادت أن تسحقني، وكنت أتوقع الأكثر، إلا أن صغر سني، ودلاله لي شفعا لي، واكتفى والدي بتلك النظرات، ولكن لم يشعر بها أحد من الحاضرين.
كنت أعرف أن حنان أبي وحبه لي منعاه من تأنيبي، وكانت درساً قاسياً لي، تعلمت أصول اليقظة والحيطة، وما برأ جرحي إلا عندما تكررت الحكاية وأمرني بالكتابة، وسألني عن الوقت فكنت جاهزة ومستعدة، ولمحت رضا بريق عيونه، وانفراج أساريره، ومن ذلك اليوم ما تراني إلا أقدر الأمور حق قدرها على الدوام.
***
في دار الخير بالروضة حيث سكن أخي العباس كنت عندما أزوره أجبر نفسي على عدم النوم إلا بعد صلاة الفجر، لأستمع إلى زقزقة العصافير في الصباح الباكر، ثم أصوات الغلمان الصغار يتغنون بأنغام طفولية رائعة لإخافة العصافير وطردها حماية لأعناب الروضة، يبدون كجوقة غنائية، نظيمة اللحن والموسيقى، وأستمتع بغنائهم وألحانهم كأنهم يعزفون على أوتار قلبي، ثم يتلوه أصوات الشباب وهم يسنون (يرفعون) المياه بالدواليب والبكرات من الآبار بواسطة الجمال، بألحان قد توارثوها من عمق الزمن عن الآباء والأجداد.
وفي بيت أخي العباس كان الماضي يتجسد أمامي، تذكرني دار أخي العباس بالأهل والناس، وتعيد رسم صورة مجتمعنا اليمني في زمانه ووقته.
ولكن، وأواه من لكن، فإن ذكريات الألم تعاود عصر نياط قلبي، أصبت بسهم الزمن، وتوالت المصائب؛ فحادثة اغتيال والدي المجاهد والمحب لشعبه وأمته، التقي الورع الزاهد، العلم، وقد جثا على جثمان حفيده الطفل، وبجانبه رفيق دربه والمؤتمن على دولته؛ وزيره القاضي عبد الله بن حسين العمري، وإخواني الحسين والمحسن، ما كانت لتفارقني لحظة، وإن كنت أتصنع السرور والضحك.
***
وتوفي أخي إبراهيم رحمه الله في 22 شعبان 1367هـــ/ 29 يونيو 1948م، ثم أخي يحيى رحمه الله تعالى عام 1369هـــ/ 1950م.
ما لي أرى طائر الفرح يخفق في صدري لحظة ثم أراه وقد طار، أترنح وسط عباب زاخر، وعصف رياح، فغمامة من الحزن تظل رابضة على صدري، أفقد كل حين أخاً عزيزاً. وعبر صبر عجيب فإن شفتاي تتمتم: لا بد من إبعاد كل جنوح إلى الضعف عن خاطري، علي أن أوقف طاحونة العذاب التي تحيطني.
فضلت الاستقرار في منزل أخي علي (دار الحمد)، حتى يتم إصلاح وفرش منزلي، وبالفعل، انتقلت إلى منزلي، ولم أستقر فيه سوى بضعة أشهر.
يتبع العدد القادم

.jpg)








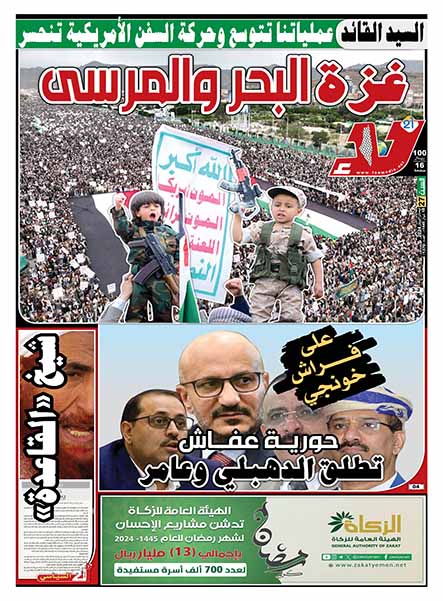







المصدر تقديم: رئيس التحرير / صلاح الدكاك