خـــريف امبراطــــورية
- تم النشر بواسطة رئيس التحرير / صلاح الدكاك

مَثَّل (ترامب) تجسيداً قوياً لعجز الواقع الأمريكي فيما مثلت (كلينتون) ادعاء القوة الفارغ
خـــريف امبراطــــورية
خلافاً لوسائل الإعلام العالمية التي أجمعت غالبيتها على توصيف فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، في سباق الرئاسة الأمريكية بـ(الصادم والمفاجئ)، ثمة توصيف أدق ـ برأينا ـ تنسحب دلالته على لحظة زمنية سابقة بـ8 أعوام للحظة إعلان اسم رئيس الولايات المتحدة الـ45، عشية الأربعاء الفائت..
يقارب هذا التوصيف الأدق (واقعة فوز ترامب) باعتبارها استمراراً لـ(صدمة ومفاجأة فوز باراك أوباما الأسود ذي الأصول الأفريقية الكينية والجد المسلم، في نوفمبر 2008)، ثم فوزه مجدداً بدورة رئاسية ثانية في 2012م.
انفتاح مغاليق بوابات البيت الأبيض لرئيس لا يتحدر من عرقية (الواسب) البريطانية الأيرلندية، وذات الجذور الضاربة في مضامير الاحتكارات الصناعية الحربية وغير الحربية، لم يحدث سوى مرتين في تاريخ الولايات المتحدة: مرة مع (جون كنيدي) مطلع ستينيات القرن المنصرم، والأخرى مع (باراك أوباما) الذي ضاعف لون بشرته الأسود وأصوله الأفريقية من صدمة ومفاجأة صعوده.. وكلا هذين الرئيسين كان ديمقراطياً.
في ستينيات القرن العشرين، وفي أوج وزخم قوة الولايات المتحدة، لم تكن الطبقة المسيطرة اقتصادياً وعسكرياً وأمنياً، لتسمح بحدوث زلل في نواميس توارث الرئاسة حصرياً ضمن شجرة (الواسب)، فجرى تصويب هذا الانحراف ورقع الخرق باغتيال (جون كنيدي) في 1963م، عقب 3 أعوام من رئاسته!
غير أن عاصفة الإفلاس المالي المعروفة بـ(أزمة الرهن العقاري)، كانت بمثابة الملاك الحارس لـ(أوباما الأسود) طيلة دورتي رئاسته، منذ 2008 وحتى 2016، فقد كان فوزه ـ بدءاً ـ بمثابة انحناء لا غنى عنه لعاصفة الإفلاس العاتية، تملقت من خلاله الطبقة المسيطرة أزماتها البنيوية المعقدة بحافز ألا تخسر مداميك وجودها كلياً أمام العاصفة الناجمة أصلاً عن هذه الأزمات!
أرادت طبقة الاحتكارات المسيطرة أن تبرهن للداخل الأمريكي على جديتها في تقديم تنازلات لاستنقاذ اقتصاد مركز قيادة العالم من هاوية السقوط الوشيك بفعل مقامرات المحافظين الجدد وغزواتهم الكونية التي ضربت ارتدادتها مزايا الحياة الأمريكية والمواطنة والهوية، وأضرت بغالبية الشعب، ولفظتهم خارج حقول العمل والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي و... خارج منازلهم العالقة على ذمة أقساط مالية باتوا عاجزين عن سدادها.
كان (أوباما) ـ كحصيلة لسلسلة الظروف المتردية تلك ـ إبحاراً بالاتجاه المعاكس للمزاج الأمريكي المقامر وغير الهياب، كما ونكوصاً حتى عن تعاليم (كتاب العولمة المقدس) الذي استمات المحافظون الجدد في قسر شعوب وحكومات العالم على اعتناقها بوصفها طريق الخلاص الأمثل والأوحد من كل معضلاتهم..
مقابل فتات (التأمين الصحي) الذي أسبغه على قرابة 30 مليون مواطن أمريكي لم يكونوا مشمولين به؛ استنزف (أوباما) خزانة المالية العامة المتحصلة من أموال دافعي الضرائب، وهم غالبية الشعب، في تغذية الشركات الخاصة بالسيولة تلافياً لإفلاسها، تحت مسمى (خطة الحفز)..
لقد باركت الاحتكارات الاقتصادية المترنحة تَدَخُّل الدولة في توجيه دفة السوق وتسمية رواتب الحد الأقصى لمدراء البنوك الفيدرالية التنفيذيين، وحماية كبريات الشركات الأمريكية من الوقوع في قبضة الرساميل الأجنبية (الصينية تحديداً) تحت وطأة نضوب السيولة، بوصفها رموزاً للهوية الاقتصادية للولايات المتحدة، وهي سياسات على النقيض تماماً لما تؤمن به وتروج له العولمة النيوليبرالية التي يُعدُّ فك ارتباط الدولة بالسوق أقدس تعاليمها، ورافعة رئيسية لوجودها.
إن صعود (أوباما) للرئاسة بالأمس لم يكن دليل عافية أمريكية، وكذلك الحال بالنسبة لصعود (دونالد ترامب) اليوم، وإلا لما جرى توصيف واقعتي الصعود بـ(الصدمة والمفاجأة)، خلافاً لسواهما من رؤساء تعاقبوا على سدة حكم الولايات المتحدة، دون أن يكون صعودهم (صادماً ومفاجئاً) بالنسبة للمراقبين وأوساط الميديا العالمية، على الأقل.
إن مبعث الصدمة والمفاجأة بالأساس ليس لون بشرة الرئيس، فافتراض كهذا يجعل من فوز (ترامب) اعتياداً لا يستوجب الدهشة.. فلماذا إذن يغدو فوز رجل أبيض برئاسة أمريكا استثنائياً وموجباً للدهشة؟!
بمنأى عن كون (ترامب ذي الجذور الألمانية) لا ينحدر من شجرة (الواسب)، فإن مغايرته ناجمة ـ برأيي ـ من جرأته في الإقرار بحالة النكوص الأمريكي الراهن، وتهكمه البذيء من المجدفين خارج واقع الولايات المتحدة بوهم أنها لا تزال (امبراطورية)، فيما هي ـ حد توصيفه ـ باتت دولة (من دول العالم الثالث)، متهماً (تدخلات أوباما في شؤون الغير وصلات كلينتون بنشوء داعش ونفوذها،..) بالمسؤولية عن هذا النكوص والانتكاس.
في الدورة الأولى من رئاسته، عكف (أوباما) على احتواء تناقضات الداخل الأمريكي بفعل الأزمة المالية الحادة، للحيلولة دون انفجارها، وكبح تفاقمها الحثيث، وقد استطاع عبر السباحة بالضد للمثل الرأسمالية المعولمة، وعبر مقاربة (اشتراكية فرنسية كانت مستهجنة أمريكياً)، وقف حالة التدهور المالي والاقتصادي إلى حد كبير، لكنه لم يكن بمقدوره إعادة عافية أمريكا الإمبراطورية إلى سابق عهدها، فأزمات هذه الأخيرة كانت ولا تزال في صلب بنيتها القائمة على التناقضات والاستحواذ ومركزة الثروة وإذكاء الحروب. وفي دورته الثانية راهن (أوباما) على (الربيع العربي) أملاً في إعادة العافية الإمبراطورية الذاوية للولايات المتحدة، وفق مبدأ (شرق أوسط جديد ـ جمهوري بالأساس)، غير أن نتيجة إخفاق (ربيع الشرق) كانت مخيبة لتوقعاته، إذ برزت (روسيا) كقوة على مسرح الشرق الأوسط، وباتت إيران لاعباً وازناً على مستوى أكثر ملفاته وقضاياه، وانفرط عقد نفوذ وكلاء واشنطن في (حظيرتهم الخلفية اليمنية)، وأصيبت حركات الإسلام السياسي الإخواني الوهابي في مقتل لجهة وثوب حركات أيديولوجية ثورية مناهضة لأمريكا وإسرائيل، أخفقت ترسانة الردع العسكرية الغربية في إجهاضها واجتثاثها.
بالنسبة لغالبية الشعب الأمريكي، فإن صعود (هيلاري كيلنتون) للرئاسة، لن يعني سوى تبديد 4 أعوام أخرى في ذات سياسة مراكمة الإخفاقات الخارجية كمسلك ديمقراطي، على حساب بنية الداخل الأمريكي الآيلة لـ(انقسامات عميقة) أقرت بها كلينتون تحت وطأة خسارة لم تكن في حسبانها، مع إعلان فوز (ترامب).. لكن ماذا بوسع هذا الأخير أن يفعل؟! لا شيء أكثر من الإقرار بعجز أمريكا عن الفعل! وهذا هو ما يجيده ترامب بجرأة تصل حد البذاءة، على أن هذا ـ كما يبدو ـ هو ما استمال الرأي العام الأمريكي الناخب إليه.
(لو عاشت أمريكا لأمريكا فستعيش في رفاه ورغد).. هكذا زفر رئيس منظمة عاملة في مجال الحقوق والحريات الإعلامية، ولخص في العبارة الآنفة تعقيبه على مداخلة لي قلت فيها إن أمريكا تعتمد في رفاهها الداخلي على حصيلة عرق العالم الخارجي الذي تهصره من الشعوب والبلدان ترسانة هيمنتها ووصايتها.
حدث ذلك أثناء زيارتنا لأمريكا، وفي ولاية (ويسكونسن) في العام 2011، حيث معظم النخب الفاعلة في هذه الولاية الزراعية، ميالة إلى نقد السياسة الخارجية لواشنطن بحدة، وتحميلها المسؤولية عن تردي مزايا المواطنة في أكثرية الولايات، لا سيما الجنوبية والجنوبية الغربية، وتعتقد هذه النخب أن بوسع أمريكا الاستغناء كلياً عن نفط الشرق الأوسط، فمواردها النفطية الداخلية وافرة فيما لو حصرت نشاطها في حدود كونها دولة عظمى.
حديث ترامب أثناء سجال الدعاية الانتخابية تضمن عبارات شبيهة بالتي سمعتها في (ويسكونسن)، حيث أبدى استعداده لمقاطعة نفط الخليج.. كما والكف عن التدخل في شؤون الآخرين.. ولعل نجاح (ترامب) في محاكاة الذهنية الداخلية المتذمرة والبرمة بسياسات الإدارة الأمريكية الديمقراطية، كان أحد أبرز عوامل فوزه.
يمكن الجزم بأن الفوارق التقليدية بين المقاربتين الجمهورية والديمقراطية، قد انتفت، وبات فرز الساسة الأمريكان إلى صقور وحمائم، من الماضي. والأرجح أن حاجة الجمهوريين في هذا المنعطف كانت لجهة فوز الديمقراطيين بولاية ثالثة تلافياً لتركة الإخفاقات الثقيلة والمعقدة التي راكمها الديمقراطيون خلال دورتين سابقتين، والتي لا مفر أمام الجمهوريين سوى النهوض بتبعاتها في حال فوز مرشحهم، لذا فقد دفعوا بـ(ترامب) ليخسر!
إن الرياح العالمية (وتحديداً في الشرق الأوسط) ليست مواتية لمقاربة جمهورية تقوم بدرجة رئيسية على المد، ولن يكون بوسع (ترامب) أن يفعل أكثر مما فعله سلفه الديمقراطي إزاء (الملف النووي الإيراني)، في حين أنه أبدى نكوصاً واضحاً إزاء ما يمكن أن يقدمه في الشأن السوري، الأمر الذي جعل خطاب الرئيس بوتين احتفائياً لدى فوز (ترامب) بمنأى عن أنه يرى في هذا الأخير نسخة أخرى من الرئيس الروسي الأوهن (بوريس يلتسين)، سيعمل على تدمير أمريكا كما دمر يلتسين روسيا.
وثمة ملفات لن يكون بوسع (ترامب) سوى المضي فيها على نهج سلفه، أبرزها (فلسطين)، ورعاية التفكيك الناعم للمملكة السعودية عبر الهيكلة، غير أن اللحظة اليمنية مواتية أكثر من ذي قبل للذهاب بالقرار الوطني إلى مطاف تشكيل حكومة تحظى باعتراف واسع، وفرض الشروط على طاولة مشاورات قادمة محتملة بناءً على زخم معارك ما وراء الحدود، كما وملاحقة تحالف العدوان في المحافل الدولية على خلفية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
إن التحاق اليمن كرقم وازن بمحور المقاومة لن يطول، فمن خلاله وعبره يمكن لها الانتفاع إيجاباً من التباينات الدولية التي تغدو أكثر نضجاً بولوج زمن الجزر الأمريكي الامبراطوري.

.jpg)












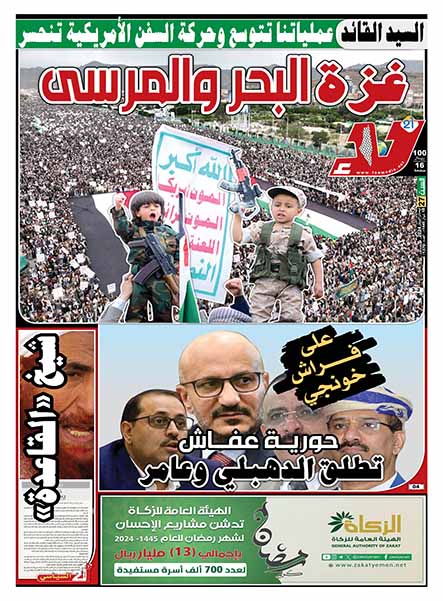


المصدر رئيس التحرير / صلاح الدكاك